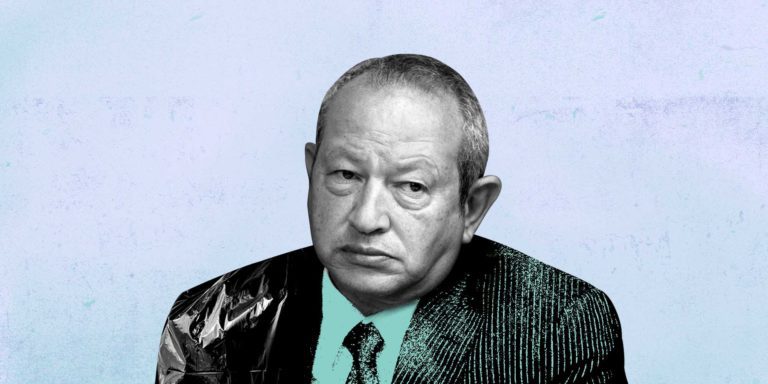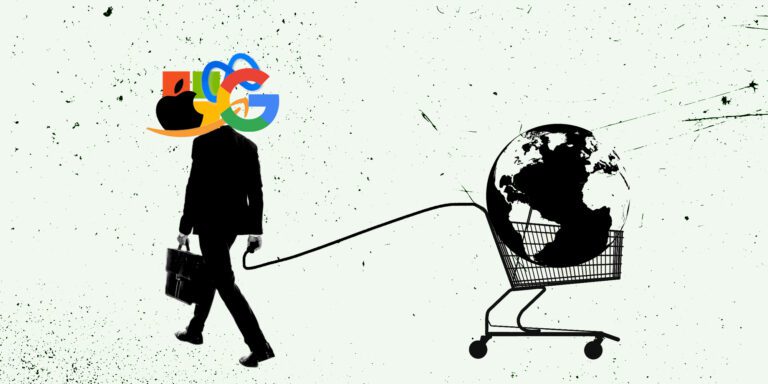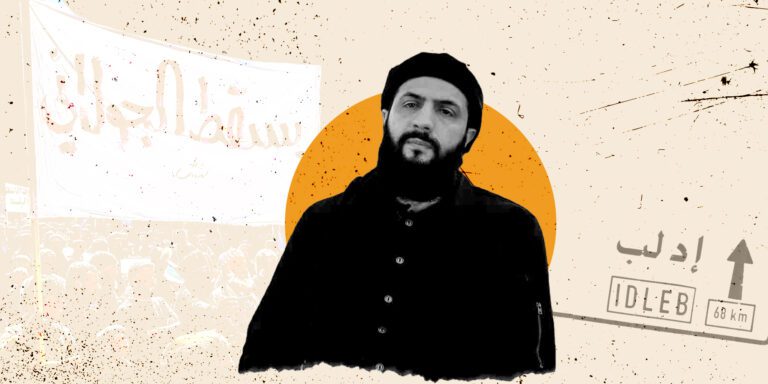لا يهم الوقت الذي سيبدأ فيه عمله أو متى سينتهي، ولا يشغله أين سيعمل… فالمهنة التي يعمل بها ليس لها مُديرون يحددون مواقيت العمل، ولا عملاء في انتظار إنتاجه، ولا محل إقامة لوظيفته. فهو صاحب المشروع، مدير نفسه، رأس ماله، جوال فارغ يحمله وينطلق حيث يلتقط رزقه من الشوارع والطرقات.
يحكي محمد حسين، 44 سنة، موضحاً لـ “درج” طبيعة عمله، “تبدأ السرحة حين تٌفرغ الجيوب. فآخذ شوالي وأنطلق على حسب ما تسحبني قدماي حيث لا جهة محددة”.
يشير حسين الى أن مصطلح “السرحة” متعارف عليه بين جامعي العبوات الفارغة، معتبراً أنه مصطلح دقيق ومعبر للغاية عن حالته أثناء العمل، فهو يسرح في بلاد الله، شارداً، يتلفت دوماً أثناء المسير ربما وجد عبوة معدنية هنا أو هناك فيلقي بها في الشوال.
ينتهي عمله حين يشعر بثقل شواله، هنا يدرك أن الوقت قد حان ليعود بما حصل عليه في يومه الطويل إلى عم رجب، صاحب مخزن لبيع المخلفات وشرائها، فيبيعه كيلوغرام العبوات المعدنية بـ 50 جنيهاً، وكيلوغرام العبوات البلاستيكية بـ 15 جنيهاً. غالباً، تتراوح السرحة ما بين 10 ساعات إلى 12 ساعة من العمل المتواصل، بينما تبلغ قيمتها المالية من 300 إلى 350 جنيهاً، أي أقل من 10 دولارات.
يضيف محمد بلهجة لا تخلو من السخرية المريرة، “رزق بائع السجائر والمطعم والديلر”.
رغم ملابسه المتسخة والبالية، كعادة أصحاب تلك المهنة، إلا أنه يبدو مختلفاً عنهم بالتأكيد، فهو مُطلع ومتعلم، حصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة حلوان عام 2000.

يوضح محمد حسين، “في تسعينات القرن الماضي، كانت الدولة تروج لمشروعها القومي (توشكي)، وكانت أغنية “عاوزينها تبقي خضرا… الأرض اللي في الصحرا“، بصوت محمد ثروت، تتردد في كل مكان. كانت الحملات الترويجية تستهدف الشباب لتحفيزهم على ترك العاصمة والانضمام إلى المشروع العظيم. لذلك، أعلنت السلطة حينها قراراً بتمكين خريجي كليات الزراعة من الأراضي بتوشكي مجاناً بهدف استصلاحها”.
كان مجموع الثانوية العامة يضمن له دخول كلية من كليات القمة بلا عناء. غير أنه اختار كلية الزراعية سعياً وراء الحلم.
بالطبع، الجزيرة لم تكن سوى خيال، والبيت وهم والمشروع القومي أكذوبة من السلطة.
تخرج محمد حسين في الكلية، كما تخرجت حبيبته التي تزوجت من آخر، كعادة الحب الأول ربما.
لم تكن تلك هي المشكلة الحقيقية، بل الشهادة ذاتها، فقد تخرج في عهد الامتداد الخرساني مقابل تآكل الأراضي الزراعية التي بدأت في دخول كرديون المباني. الفلاح نفسه صار عاملاً وسمساراً وصاحب عقار. أما المؤسسات والشركات فهي في غني عن شهادته.
يؤمن محمد حسين بأن جيله ضحية الخديعة بامتياز. “في البداية، أفهمونا أن التعليم وسيلة الناجح لتحقيق أهدافه وتحسين حياته نحو الأفضل. فاتخذنا طريق العمل، وبعد النجاح رفعوا شعارات أخرى: أعمل ما لا تحب حتى تحب ما تعمل”.
وهو ما فعله محمد حسين بالفعل، الذي ركن شهادته وراح يتنقل بين شغل وآخر. مرة عامل باليومية، ومرة بائع في دكان حلويات، حتى انتهي به المطاف عامل دليفري بأحد الصيدليات الكبرى. غير أن السلطة في مصر قررت أن تقتحم مجال تجارة الأدوية، لذلك جاء التضييق على الصيدليات الكبرى، ما دفع صيدليات كثيرة الى إغلاق فروعها وتسريح الموظفين. وكان محمد حسين واحداً من هؤلاء.
يتذكر محمد حسين تلك الأيام قائلاً: “عشت أياماً من الضنك، بخاصة مع ارتفاع معدل البطالة الذي تزامن مع ارتفاع الأسعار، وتدهورت الحال أكثر حين توفيت والدتي. فاضطررت لبيع أثاث الشقة، وفي النهاية ارتميت في الشارع ليكون بيتي الجديد ومصدر رزقي”.
يهز رأسه بخيبة أمل، “كنتُ أعتقد أن البلاد ستدخل عصر الزراعة بعدما فشلت في عصر الصناعة والتجارة. ولكنها عادت بي إلى عصر الجمع والالتقاط”.

مرحباً بكم في ديستوبيا القومية العربية
لم يكن يخطر على بال محمد عبد العزيز الشهير بـ زيزو (45) عاماً، أن ينتهي به المطاف مع أسرته في مقلب القمامة هذا، بخاصة أنه عاش حالة من الرخاء مع مهنته القديمة، التي يحكي عنها لـ”درج”: “في الأصل، كان والدي شماعاً، صانع شمع. وكانت لديه ورشة كبيرة خلف شارع المُعز بالأزهر، يعمل فيها أكثر من عشرين صنايعي. كانت أيام عز بصحيح. يمكن أن نطلق عليه (العصر الذهبي للشمعة). شموع لأعياد الميلاد، شموع للسبوع، شموع للأفراح، الشمع أنيس السهر في القرى والنجوع. كل الأيام الحلوة كانت مرتبطة بالشمع. ووقتها، أنا أيضاً، كنتُ أعيش طفولة سعيدة. ولمَ لا وأنا الابن الوحيد لصاحب الورشة؟”.
كان صاحب الورشة يحلم بتحويلها إلى مصنع كبير يصدّر الى العالم أجمع إنتاجه الفني المتنوع من الشموع. لذلك أصر على أن يعلّم الابن الصنعة على أصولها، فأجبره على ترك المدرسة والالتحاق بالعمل في سن مبكرة.
“اتولدت معلم، كنت بدير الورشة وأنا ابن العشر سنوات. كانت شنبات تقف تقديراً واحتراماً حين أدخل الورشة”، يقول زيزو.
عقب ثورة يناير، تأثرت المتاجر والمحال بالأحداث التي مرت بها البلاد، لا سيما في منطقة وسط البلد وضواحيها. وساد الكساد، ففرّ العمال من الورشة واحداً تلو الآخر، ما اضطر زيزو لإغلاق ورشته سنوات عدة عاني فيها من الحاجة والعوز.
لم يصمد زيزو طويلاً أمام التغييرات الاقتصادية التي طرأت على الدولة، خصوصاً وأن الحمل العائلي تزايد في ظل ابنتين. لهذا لجأ زيزو الى بيع محتويات الورشة والمعدات، ثم بدأ في بيع أثاث بيته. ومع ذلك، تراكمت عليه الديون كما تراكم عليه إيجار شقته. وهكذا وجد نفسه، ومعه أسرته، في الشارع.
بآسىً حقيقي يستطرد، “الشارع كان أحن عليّ من أهلي وأصدقائي. ليس هنالك أثقل من البني آدم، فمن تحملك بظروفك القاسية يوماً لن يستطيع تحمّلك في اليوم التالي. كما أن معادن الناس الحقيقية تظهر وقت الشدائد. أحياناً، يمر من أمامي صديق قديم، واحد لحم كتفه من خيري. غير أنه يتجاهلني كغيره، يستعرون مني بعدما كانوا يتفاخرون بمعرفتي. ولكن، هذه هي حال الدنيا”.
بعكس المتوقع، لا يحلم زيزو ببيت آمن أو وظيفة أخرى لائقة. لقد صار مقلب القمامة هذا – والذي يطل على شارع القومية العربية العمومي بمنطقة إمبابة – بيته الحقيقي حيث العشة القابعة بالعمق، والتي يتألف أساسها من أخشاب متهالكة أُرخيت عليها الستائر. في داخل العشة، نجد مرتبة صغيرة وكرسياً ضخماً مصنوعاً من القش وبعض الأدوات البدائية لإعداد الطعام. أما في الخارج، فقد وضع كنبة ضخمة قديمة في منتصف مملكته تماماً، تلك المملكة التي تتكون من أكوام من القمامة حيث تعمل ابنته جميلة مع أمها في فرز هذه التلال. بينما تستقر مريم الصغيرة في حضن والدها الجالس على “عرشه” الجديد.
يشير زيزو نحو مملكته القذرة ويقول: “لا أفكر مطلقاً في ترك هذا المكان. ما أفكر فيه فعلياً هو شراء حصان وعربة كارو. بذلك سأتمكن من نقل البضاعة/ المخلفات إلى المنافذ الكبرى الموجودة بالبراجيل وبشتيل. وقتها لن أكون تحت رحمة صاحب المخزن الذي يمتص أكثر من نصف المكسب”.
تواصل جميلة ووالدتها العمل أمامنا. تلتقطان العبوات البلاستيكية والقطع المعدنية من بين النفايات تحت الشمس الحارقة. مشهد يذكرني بأفلام الأرياف المصرية حيث الفلاحات مع بناتهن تجمعن المحصول من الأرض الزراعية. إلا أن الواقع يبدو لي كـ “ديستوبيا” لمدينة هلكت لم يتبقّ منها غير بقايا البقايا. لا شيء غير أكوام القمامة ومحاولات مستمرة من أبناء هذا الوطن لأجل البقاء.
قاع الحلال…
يصل حجم المخلفات في مصر سنوياً 90 مليون طن، 26 مليون طن منها مخلفات صلبة، والتي تمثل تقريباً ثلث إنتاج مصر من المخلفات. هذا الكنز المُتجدد لفت أنظار السلطة في مصر، فـسنت قانون 202 لسنة 2022 لتنظيم إدارة المخلفات، بعدها قررت الدولة أن تزيد عدد مصانع إعادة التدوير من 28 مصنعاً إلى 58 مصنعاً. بالإضافة الى أن مركز إدارة تنظيم المخلفات بوزارة البيئة قرر إعفاء الشركات الصغيرة العاملة في مجال تدوير المخلفات من أي رسوم لممارسة النشاط، وتخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجالات المخلفات. ذلك كله بهدف الاستفادة الكاملة من المخلفات، بخاصة وأن الدولة المصرية تستهلك نحو 12 مليار كيس بلاستيكي كل عام يتم إنتاجها من مخلفات العبوات البلاستيكية، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي تُنتج من المخلفات سواء معدن أو بلاستيك. وهو ما دفع الرئيس السيسي نفسه الى الاهتمام بملف المخلفات حديثاً.
أما قديماً، فقد كانت نظرة المجتمع المصري الى القمامة والى جامع القمامة مختلفة كلياً. يقول عم رجب، صاحب مخزن لتجارة المخلفات، لـ”درج”: “ظلت مهنة الزبال قاصرة على الأقباط حتى عهد السادات. ولا أعرف لمَ؟ البعض كان يقول إن القمامة تعتبر من النجاسة لذا لا يعمل بها مسلم، والبعض الآخر ربط المهنة بتسمين الخنازير حيث كانت القمامة قديماً تُقدم كوجبات يومية لحظائر الخنازير المنتشرة بمصر القديمة وجبل الدراسة. كما أن القمامة كانت تُحرق في مستودعات الفول لتساعد على تدميسه، وتستخدم كذلك في الحمامات الشعبية كوقود”.
يري عم رجب أن تلك عصور مضت، وقتها كان جمع القمامة مهنة كباقي المهن، لها معلم يحدد الأماكن ويوزع الشغل ومواقيت العمل ويتابع حركة الصبيان.
يضيف: “دائماً ما كانت نظرة المجتمع الى الزبال نظرة تعالٍ. صحيح أنها مهنة حلال، ولكن المجتمع يعتبرها قاع الحلال. بالطبع يمكنك أن تتعاطف مع جامع القمامة، ولكن من الصعب مثلاً أن يصبح صديقك، ومن المستحيل أن تزوّجه من أختك أو ابنتك”.
تلك النظرة أجبرت عمال هذه المهنة على إنشاء مجتمع خاص بهم: قهاوي تجمعهم عند الراحة، تقاليد متفردة عند الزواج، لغة للتفاهم بعيدة فضول الزبائن…
يؤكد عم رجب أن الأمر أصبح مختلفاً تماماً، فقد صارت مهنة من لا مهنة له. كل من لا يجد عملاً يحمل فوق كتفه شوالاً ويطلع يسرح في أرض الله. ويشير إلى صناديق القمامة المنتشرة في كل مكان، موضحاً أنها أصبحت مصدر رزق لملايين المصريين، لذلك فمن النادر أن تجد مقلب قمامة من دون رقيب يعيش إلى جواره.
وعلى رغم تزايد عدد جامعي العبوات، إلا أن القمامة تنتشر بصورة أكبر في كل مكان. يبرر عم رجب ذلك بأن الزبال، قديماً، كان يمر بين البيوت، يأخذ الزبالة كما هي. لكنه اليوم، يقوم بفرزها ليستخرج منها ما يستنفع به ويترك ما لا منفعة له منه في الشوارع.