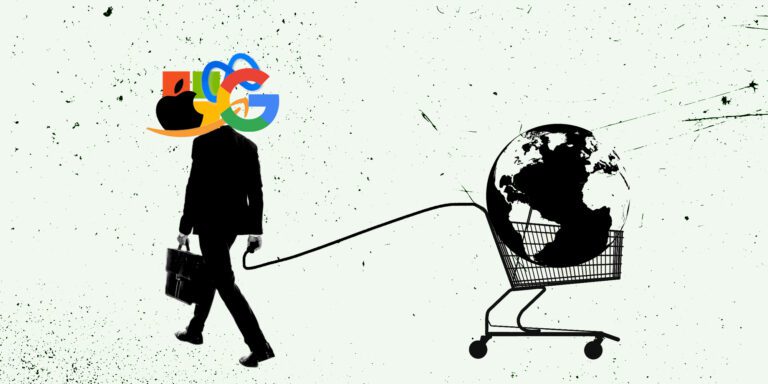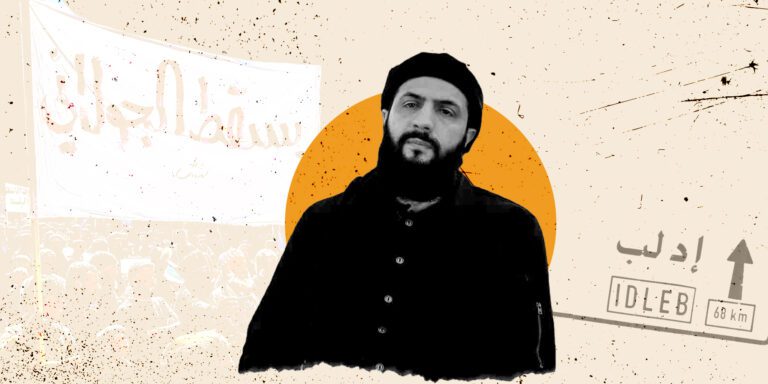عرفت باكراً أن الاحتفال بيومٍ عالميّ لمفهوم ما يعني غيابه، تماماً كاليوم العالمي للمرأة واليوم العالمي للصحافة، هما يومان للتذكير، تنديداً واحتجاجاً على استمرار تقييد حرية المرأة أو الصحافة، لكن ماذا لو كنت امرأة وصحافية في الوقت ذاته؟ كيف يمكن أن يكون شكل حياتك؟
حسناً لم أختر أن أكون امرأة ولا صحافية، ولا أن أولد في الدولة الأكثر تقييداً لحرية الصحافة في العالم. وفي الأحوال كافة، كلّ الحريات مرتبطة ببعضها البعض، فلا يمكن أن تغيب حرية المرأة وتحضر حرية الصحافة مثلاً، وهذا ينطبق على كل الدول التي تتصدّر لائحة الديكتاتوريات كإيران مثلاً أو السعودية، ففي كلتيهما تعاني النساء والصحافة معاً.
بعد سنوات من العمل في الصحافة ومواجهة التحديات النفسية والشخصية، ما زلت أطرح في نهاية اليوم السؤال ذاته على نفسي: “هل تستحق الصحافة والحرية هذه المعاناة كلها؟”.
لا إجابات واضحة في الحياة هنا، قد تبدو هذه الإجابة الوحيدة، لكني أفهم اليوم أن عدم الوضوح قد يكون درباً وطريقة للعيش وفهم الأحداث من حولكِ، تخلقين منه طرقاً للتعايش والتعوّد وحتى لحماية نفسك.
حماية نفسي، هو مصطلح ما زلت أحاول التعامل معه والتعود عليه، اعتدت الخطر في سوريا حتى تماهيت معه وصار جزءاً من روتيني اليومي كما روتين العناية بالبشرة، وهذه حال كل سوري. صرتُ متآلفة مع هذه الأخطار كلها حتى نسيتُ أنها أخطار، اعتدتُ تهديد النظام السوري وخطر “داعش” والقذائف المتساقطة من السماء، لكن الى الآن لم أعتد خطر الترحيل، لسبب بسيط هو أنني لا أريد تصديق أني كنت متأقلمة مع ذلك الخطر في سوريا، وأن ذلك الرعب كان جزءاً من حياتي اليومية.
وفي ما يتعلق بسؤال هل نجحت بما أفعل؟ هناك إجابة مؤلمة ومقنعة، نعم قد ننجح على رغم أن الحياة لم تغدُ أفضل من حولنا، وقد نصنع تأثيراً ورقابنا تحت المقصلة حرفياً ومجازياً، قد نكون سبباً في تغيير حياة شخص ما بينما لا نعلم إن كنا سننجو في الغد.
إقرأوا أيضاً:
لم يكن الوقوف إلى جانب الإنسان والحرية سهلاً يوماً، كما أن الصحافة ليست بمهنة الرفاهية، بل هي مهنة التحديات، الأمل والخوف، المحاولة تلو الأخرى، مهنة الحرية المنشودة التي نمسكها تارة وتتسرب من بين أصابعنا طوراً. هدف الصحافة هو الحقيقة والحرية، بخاصة أن الدكتاتوريات ترفضهما، حتى أنها ترفض النساء القويات.
غريبٌ كيف تتحوّلين من صحافية شجاعة تدافع عن حقوق الإنسان وتكشف الفساد، إلى فتاة تتابع مجموعة “اللاجئون السوريون في لبنان” على “واتسآب”، ثم تنسين إكمال المقال بعدما أرسل أحدهم رسالة إلى المجموعة مفادها: “التدقيق الأمني زاد في منطقة سن الفيل والأشرفية ومار مخايل… انتبهوا”.
في الحقيقة، تغدو هذه المجموعة وسيلة، لنا نحن السوريين، لننجو بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وذلك لمعرفة الطرقات التي يجب المرور فيها وتلك التي تحوي نقاط تفتيش بانتظار سوريّ ليمرّ.
ووسط هذا كله، أعتقد أن حرية الصحافة والإنسان تتلاشى في كل لحظة بتُّ أتأكد فيها إن كانت المناطق التي سأمرّ بها خاضعة للتفتيش أم لا. الحرية تتلاشى أثناء محاولاتي ألا أبدو سوريّة بينما أشتري بعض الحاجيات… الحرية هي ألّا يحدث هذا كله.
إلى اليوم، لا أعلم ما تعنيه عبارة “كي لا أبدو سورية”، هل أغيّر لهجتي إلى اللبنانية أو أدخل كلمات إنكليزية إلى أحاديثي؟ هل أرتدي ثياباً مختلفة؟ لكن “ستايلي” لم يتغير بين سوريا ولبنان، ولا أزال أسمع عبارة (مش مبين عليكي سورية)، على رغم أن شريحة كبيرة من الشابات في سوريا ترتدي ما أرتديه من ثياب كاجوال.
الحرية هي ألّا أحتار في اختيار الاسم المستعار لمادتي الصحافية، على اعتبار أني أمتلك أكثر من اسم، ككل صحافي/ة سوري/ة معارض/ة. أضحك كثيراً مع المحرر وأقول “يالا حيرة الأسماء المستعارة!”، ليرد علي: “نوّعي في الأسماء المستعارة”.
كلما كانت للصحافي أسماء كثيرة كلما قلّت فرص أن يكتشفه الجيش الإلكتروني السوري التابع لنظام الأسد، لذا تجدني أحياناً فتاتين وأحياناً أخرى شاباً، وفي بعض الأحيان أشك في أني أعرف نفسي حقاً.
بعدما تحوّلت من صحافية لا تهاب شيئاً إلى متسلّلة في الطرقات، تمرّ مسرعة من أمام مبنى حزب “القوات اللبنانية” أو تضع نظارة لتخفي عينيها المرتجفتين، هل أستطيع القول: كلّ عام والصحافيون أحرار؟
هل كان علي أن أصبح صحافية؟ سؤال يشبه “هل كان على السوريين أن يثوروا قبل 13 عاماً؟”، وفي كلتَي الحالتين، لا نملك رفاهية الاختيار، فقد أصبحتُ صحافية بمحض المصادفة. والى الآن،كلما أردت التفتيش عن الطرق التي أوصلتني إلى هذه المهنة، أتذكر غضباً قديماً داخلي على الظلم ورغبة في الكتابة ورواية حكايات المظلومين.
كيف نصبح صحافيين في بلد مثل سوريا؟ بمحض المصادفة والديكتاتورية، لأننا نريد رفع رؤوسنا، والصحافة طريقة ذكية لرفع الرؤوس، وإن سألني أحدهم كيف تتخلّصين من الانحناء الذي ابتلاكم به نظام الأسد؟ سأجيب: أكتب وأكتب.
وحدهم من جربوا ديكتاتورية نظام الأسد يدركون صعوبة الكتابة عن هذا النظام، تحليله، التذكير دوماً بجرائمه. تعلّم السوريون الانحناء على مدار خمسة عقود. الصحافة أشبه بالإدمان، ما إن ترفع رأسك مرة حتى يصير الأمر أشبه بالعادة وأحياناً الهوس، لا طرق أخرى لرفع رأسي غير الصحافة.
الآن، بعدما أصبحت واحدة من أولئك المهدّدين ليس فقط من نظام الأسد بل من العنصرية وخطاب الكراهية في لبنان، كيف يمكن أن أفهم تراكم معاناتي كصحافية؟ غالباً ما أنتزع طبقات الخوف والتضييق والتهديد من داخلي، كما تنصحني طبيبتي النفسية، طبقة العيش تحت حكم نظام الأسد، طبقة الحرمان من أبسط الحقوق في سوريا، والبقاء من دون كهرباء لأيام، طبقة المعاناة لكتابة مقال في أسرع وقت لأن بطارية الحاسوب المحمول ستنفد قريباً، طبقة إخفاء اسمي يوماً بعد يوم، حتى انفصلت عن تلك الصحافية التي تكتب هنا، وبتُّ أراها شخصاً غيري، طبقة العنصرية التي واجهتها في تركيا ولبنان، طبقة الاختباء بينما يُضرب شاب تحت منزلي… وطبقات وطبقات قبل أن أصل إلى الصحافية والإنسانة التي تُدعى على سبيل الخوف سارة.
اليوم ،كل ما أحتاجه كصحافية وإنسانة هو التوقف، التوقف عن القلق والبحث عن طرق للاستحصال على أوراقٍ نظامية وإلغاء أمر مغادرتي. أحتاج الى التوقف أمام مبنى حزب “القوات اللبنانية” والصراخ ثم متابعة طريقي كأن شيئاً لم يكن. أحتاج الى العودة الى بلدي من دون أن يُلقى القبض عليّ ومن دون أن أفكر إن كنت سأمرّ على الحدود سالمة… أحتاج الى العودة الى منزل عائلتي في سوريا والتمدد على فراش الصوف الذي صنعته أمي لأغفو على صوتها وهي تخبرني قصة ما حصلت في غيابي، قصة غير مثيرة لكنها آمنة وتدعو الى النوم.