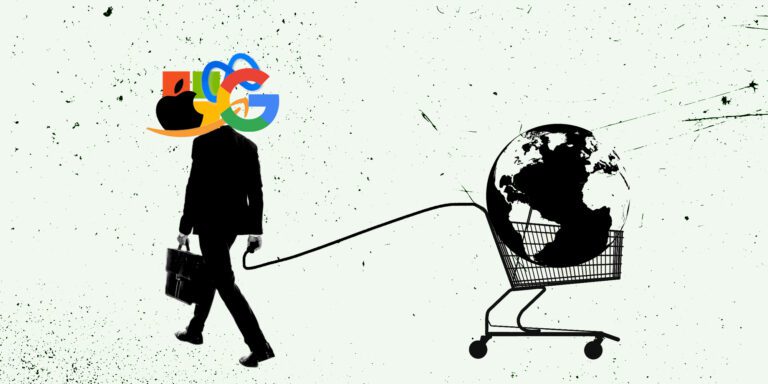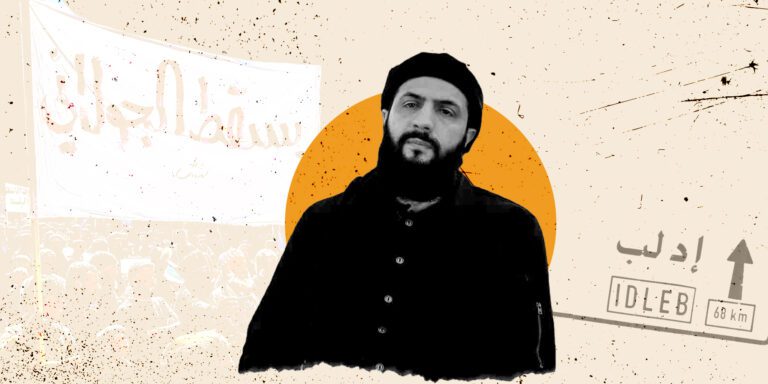“فلسطين كذبة!” قال لي محدثي الإسرائيلي الذي التقيته مصادفة في بيرن، سويسرا، منذ بضعة أسابيع. الملامح المشتركة هي ما جذبنا للحديث معاً خلال لقاء عارض ضمن نشاط ثقافي عام. كلانا ظن في البداية أن الآخر كردي (لا أدري، لم نلجأ إلى تلك “الهوية” المقموعة سياسياً بالكامل في بلادنا، على الأقل حتى وقت قريب جداً، عندما نلتقي بأحد ما “يشبهنا”!)، لأكتشف لاحقاً أنه إسرائيلي من أصل إيراني، وليكتشف أنني سوري من أصل فلسطيني- التعريف الذي قدمته لنفسي وأحدث لديه مشكلة في ما بدا بوضوح من خلال ردة فعله ما أن ذكرت كلمة “فلسطين”.
لم أستطع تمرير عبارته الأخيرة بسهولة، فانبريت أسأله عن أبي الذي وُلد في طبريا قبل أن توجد دولة إسرائيل بعشر سنوات، وعن عائلتي التي طُردت بكامل أفرادها من حيفا، وخسرت حياة كاملة هناك بنيت بشق الأنفس وعبر عقود طويلة متواصلة، ما أن أنشئت تلك الدولة. فما كان من محدثي إلى أن لجأ إلى عبارة، بت أراها أخيراً تُستخدم فقط كستارة مرفوعة لتخبئة منظر بشع تطل عليه النافذة، أو عطب في الجدار: أنا إنسان، وكل الناس من حقهم أن يعرفوا أنفسهم بمعزل عن أية هوية ضيقة قد تحدّ من أفقهم أو من قدرتهم على التواصل بين بعضهم البعض!

للوهلة الأولى، وما أن قرأت عن حركة “10 آب” في سوريا، قفزت فوراً تلك الحادثة إلى ذهني من دون توقّع أو انتظار. في البيان، أو البيانات القليلة التي أطلقتها تلك الحركة، هناك إشارة واضحة، بل ومفصّلة، إلى الوضع المعيشي الكارثي في سوريا، ودور الدولة التي قصّرت بالكامل في حماية المواطن في ظل كارثة كهذه. بل إن تلك البيانات قد مضت أبعد من شرح الحال التي يعرفها الجميع، إلى وضع صيغة محدّدة للخروج منها تتضمن مجموعة من الشروط، صيغت على طريقة إنذار للنظام الحاكم في سوريا، إما أن يلتزم بها، أو أن الحركة ستبدأ بالعمل السلمي بالاحتجاج ضد النظام إن لم يستجب لتلك المطالب. أهم تلك الشروط كانت ثلاثة: الالتزام بتحقيق حد أدنى للدخل في سوريا لا يقل عن مئة دولار شهرياً، والالتزام بالقرار 2254 لرفع العقوبات عن سوريا والسماح بتدفق الموارد، والإفراج عن كامل المعتقلين السياسيين.
خطر لي وأنا أقرأ تلك المطالب، أو الشروط، أن الأسد لو التزم بها فعلاً (لنفترض جدلاً) فهل هذا يعني أنه سيعود رئيساً شرعياً لسوريا، وأن نظامه المفترس، سيصبح بهذا “دولة لجميع السوريين”؟!، ثم ماذا عن السنوات الـ11 الماضية التي كانت بكاملها مسلسلاً مستمراً ووحشياً من الإبادة الجماعية لعموم السوريين وتدمير وطنهم وسبل عيشهم بالكامل؟! ماذا عن مئات آلاف الضحايا في أقبية السجون وتحت أنقاض منازلهم التي دمرتها براميل النظام وصواريخه؟!

البيان الذي أُطلق في مناطق سيطرة النظام، أو ما يُسمى بـ “البيئة الحاضنة”، يشير بوضوح إلى ما بات الجميع يعرفه حول الغليان هناك بسبب تلك الظروف الكارثية التي يعيش جميع سوريي الداخل في ظلهّا الآن. وهو أمر كان يجب توقعه، وبمعزل عن كل الجرائم الموصوفة أعلاه، وبمعزل عن المركب الأمني العسكري الذي يشكل جوهر النظام كله، في ظل إدارة، اقتصادية وخدمية، كانت في كل الأحوال تعتمد على مبدأ الولاء قبل أي شيء آخر. وبالتالي فإن الكفاءة، إن وجدت، كانت آخر هموم تلك الإدارة، هذا إن لم تكن عامل تهديد، من جهة الكفؤ، بحيث يتم استبعاد هذا العامل على الفور. النتيجة، أن البلاد استمرت، ضمن ظروف الحدود الدنيا، وبتراجع مستمر على الصعد الاقتصادية والمعيشية كافة، منذ عشية سيطرة البعث على السلطة، لتصل تلك السيطرة إلى ذروتها بالانقلاب الأسدي في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970.
خلال تلك العقود الطويلة، كان التدهور هو السمة الغالبة لأوجه حياة السوريين كافة، الذين عاشوا، في غالبيتهم الكاسحة، على حدود الكفاف، محاولين بما يشبه الاستحالة تأمين سبل عيشهم كيفما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وعلى رغم هذا العسر والضنك كله، إلا أن أولئك السوريين، وبمختلف طبقاتهم الاجتماعية، كانوا المولد الوحيد للقيمة المضافة التي كان النظام يسحبها من بين أيديهم عبر فرض مختلف أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي جعلت أساسيات الحياة حلماً صعب المنال في نظر الغالبية الكاسحة من السوريين.
ورغم كل التحديات وكل الجهود المضنية للعيش والعمل في وطن، لم يعرف السوريون سواه وطناً لهم، كان التراجع هو السمة الأبرز. الى درجة أن الأسد الأب، وعندما ترك السلطة، ميتاً، كان الدولار قد تجاوز عتبة الـ45 ليرة، بعدما كان لا يتجاوز الثلاث ليرات ونصف الليرة عندما استولى على الحكم في عام 1970. أي بزيادة تتجاوز الـ13 ضعفاً. لكن هذا حصل خلال ثلاثين عاماً من حكم أسد مفترس واحد. بينما هو يحدث الآن وبمعدلات خيالية، وخلال بضعة أشهر، خلال حكم خليفته.
ما أبطأ الانهيار، ولم يستطع منعه، في ظل الأب، هو أن كل السوريين، تقريباً، بقوا في بلادهم يحاولون بكل طاقتهم العيش. وما جعل الانهيار سريعاً، في ظل الابن، هو أن أولئك السوريين، نسبة هائلة من النواة المنتجة منهم بالتحديد، توزعوا بين ثلاثة مصائر: الموت تحت التعذيب في أقبية سجون الأسد أو تحت أنقاض منازلهم، الفرار إلى دول الجوار للعيش كلاجئين في المخيمات في ظروف بتنا جميعاً نعرفها، أو الإكمال باتجاه دول تحترم حقوق الإنسان، وبالذات حقه بالحياة والعمل. وحتى أولئك الذين شاءت ظروفهم أن يبقوا في البلد، ما عادوا قادرين على العمل في البيئة نفسها التي اعتادوا عليها، والتضييق يلاحقهم من كل جانب، حتى الصناعيين والتجار من بينهم. وبالتالي ما عاد هناك أحد قادر على إنتاج قيمة مضافة تعيد ورقة التوت إلى عورة المفترس.
ما زاد في الطين بلة، هو أن الأسد الابن، قد حوّل البلد بكاملها إلى قاعدة لإنتاج الكبتاغون وتوزيعه في المنطقة والعالم كله. وهذا ما جعله يحقق عائدات، له ولدائرة محدودة من مواليه، وليس لنظامه، ولا حتى لقاعدة مواليه، تُحسب بعشرات مليارات الدولارات. هذه العائدات التي لم يُستخدم منها شيء على الإطلاق داخل البلاد، إلا لجعل الهوة بين أثرياء الحرب في سوريا، وبقية المواطنين، بما فيها قاعدة النظام الاجتماعية، تتسع أكثر وأكثر بشكل بات فيه الفحش نفسه كلمة عادية لتوصيف الحال.
إقرأوا أيضاً:
إن أضفنا إلى الصورة أعلاه، واقع أن سوريا، كجغرافيا، ما عادت هي سوريا التي نعرفها، وأننا فعلياً بتنا أمام ثلاث سوريات على الأقل: المناطق الخاضعة لسيطرة قسد، وتلك الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، وفيها مساحات شاسعة (تلك الغنية بالواردات تحديداً) صارت إيرانية أو روسية بالكامل، فإننا سنجد أنفسنا أمام خطاب لا يتوجه إلى أحد. على اعتبار أن النظام نفسه، العنوان الرئيسي الموجه له هذا الخطاب، غير معني بالمطلق بكامل تفاصيله، باستثناء أولئك الذين أطلقوه، بحيث يحوّلهم إلى عبرة للجميع، على جاري عادته.
إضافة شرطي إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين، والالتزام بالقرار الأممي 2254، لن يفعلاً شيئاً في إضافة زخم “سوري” ما الى تلك الحركة، وخارج مناطق سيطرة النظام، إذ إن السنوات الـ12 الماضية تحتاج إلى “شجاعة” من نوع مختلف تتناول مواضيع أكثر جدية وعمقاً وإيلاماً لجميع السوريين، وتسميتها بأسمائها الصحيحة كمثل: ثورة حرية وكرامة، مجازر جماعية، تسليم جميع المرتكبين إلى العدالة لمحاكمتهم، مصالحة قائمة على العدالة…. وهذا غيض من فيض من عناوين لا تزال، رغم أنهار الدم، موضع خلاف، لن تنجح جميع أنواع الستائر في تغطيتها.
بالعودة إلى ستارة صديقي الإسرائيلي، فإن السؤال الذي أرقني أكثر من غيره وأنا أغادر عائدا إًلى بيتي، كان: ماذا لو لم يكن الرجل يحاول تغطية عطب في الجدار؟! ماذا لو كان يعتقد، فعلاً، بأن فلسطين كذبة؟! هذه مصيبة تستلزم ألا نكف عن محاولة قول الحقيقة إلى النهاية، حتى لو هُزمنا، ونحن فعلاً، فلسطينيون وسوريون، وبالمعنى السياسي والعسكري، قد هُزمنا وشبعنا. ولكن هذا لا يلغي أننا أصحاب حق وأن كلمة الحق تلك هي آخر ما نمتلكه ولا يجب أن نستغني عنه… إن لم نفعل هذا سنكون قد هزمنا تماماً.