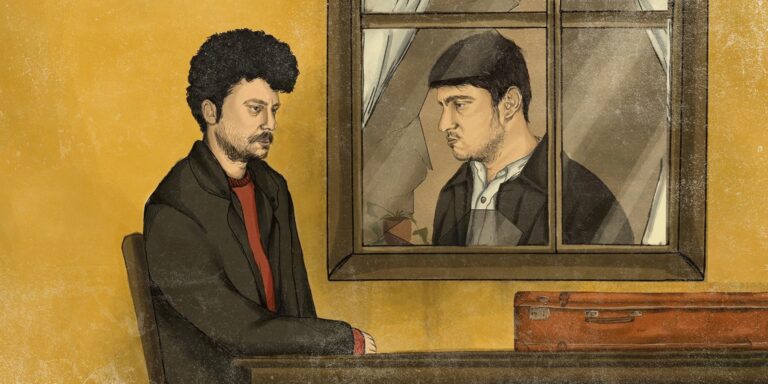يشتكي المسلمون عموماً، وبمختلف مذاهبهم، من إلصاق تهمة الإرهاب بدينهم من دون أي وجه حق. ويدخلون في جدل طويل مفنّدين كل الحجج التي تسوّقها مراكز أبحاث ووسائل إعلام منتشرة في العالم، إضافة إلى جهات رسمية وحكومية مخوّلة بمتابعة التحقيقات بشأن أي هجوم إرهابي قد تتعرض له البلاد (مجال سلطة تلك الجهات)، إذ يظهر تقريباً إجماع على لصق صفة الإرهاب بأي حدث عنيف يودي بحياة مدنيين أبرياء، ويكون منفّذه مسلماً. والسؤال الذي يطرحه المسلمون هنا: لماذا لا تُطلق هذه الصفة على أعمال عنف مارسها مرتكبون غير مسلمين؟!
بمعزل عن دوافع وسياقات أعمال العنف الأخرى التي يمارسها مرتكبون غير مسلمين، فإن السؤال أعلاه يغفل حقيقة مهمة جداً في تعريف ظاهرة الإرهاب، بصفته عملاً عنفياً يعرض حياة مدنيين أبرياء للخطر في سبيل تحقيق مآرب سياسية معلنة. والحق، أننا لو نظرنا إلى الغالبية الكاسحة من أعمال العنف الممارسة من منفذين مسلمين تحديداً، لوجدنا أن التعريف أعلاه ينطبق عليها. إذ عرضت حياة مدنيين للخطر، بل وأودت بها، لتحقيق أهداف سياسية معلنة، سواء لصالح تنظيمات إسلامية إرهابية، أو بدافع فردي للتعبير عن احتجاج ذي طابع سياسي في مواجهة الغرب “الظالم”. العمليات تلك ظهرت وتكاثرت بهذه الصفة، بالذات بعد الـ Masterpiece، جريمة 11 أيلول/ سبتمبر في أميركا.
يمكن أن نضيف أيضاً تلك العمليات التي نُفّذت قبل بزوغ ظاهرة الإسلام السياسي، بصفتها “خلاص” أمة المسلمين الأكيد. إذ درجت ظاهرة اختطاف الطائرات، واحتجاز رهائن مدنيين (عملية أولمبياد ميونخ، 1972، تندرج ضمن هذا التصنيف) للوصول إلى أهداف سياسية محدّدة، وذلك من خلال منظمات يسارية فلسطينية، مارست هذا الإرهاب المعلن، الذي، وللمفارقة، لم يجمع بعد الرأي العام العربي، الذي أصبح ذا نزعة إسلامية ظاهرة، حتى اللحظة، على اعتبار تلك العمليات، رغم مضي نصف قرن عليها، أعمالاً إرهابية أيضاً!
إن حاولنا البحث عن تبريرات لهذا الموقف الرافض كلياً القبول بتعريف واضح للإرهاب، فهذا يمكن أن يكون منطلقاً لصيغة قانونية شاملة، تحمي الضحية وتجرّم المرتكب. صيغة ستقود لا محالة، ولو بعد جهد ونضال طويلين، ولكن بالارتكاز على مبادئ واضحة مطبّقة على الجميع، الى تجريم أفعال أخرى مورست ضد العرب، والمسلمين في عمومهم، من جهات أخرى. أفعال تنطبق عليها تعريفات أشدّ هولاً، “الإبادة الجماعية” مثلاً، تلك التي تنطبق على ما يفعله جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة الآن. إن حاولنا البحث عن تلك التبريرات، فقد لا نجد أمامنا إلا تبريراً واحداً: إنه رد فعل اليائس عندما يقرر التمرد على صيغة يجد أنه ضمنها هو الأكثر ضعفاً وتعرضاً للاتهام، وهي لا تقيم وزناً لمصالحه، ولا حتى لوجوده نفسه.
لكن، هل الأمر كذلك فعلاً، أم أن هناك سياقاً كاملاً لا بد من النظر إليه بشمولية، وبعيداً من التشكّي وعقد المظلومية المزمنة، بحيث نستطيع أن نجد لأنفسنا، عرباً ومسلمين، مكاناً، في عالم لا يكفّ عن التشكل، بعيداً من كوننا إرهابيين، أو ضحايا إبادات جماعية؟ أعتقد أن السؤال إن طرح بهذه الصيغة، فقد يساعد على تلمّس أفق للخروج من تلك المعضلة التي لا تنفك تطبق على أنفاس الجميع، وتكرّس إحساساً وهمياً بالكامل، بالاختناق في عالم معاد لنا بشكل مطلق، كوننا عرباً ومسلمين فقط، وبالتالي لا مجال للخروج من تلك الحالة إلا بالمزيد من الإرهاب، الذي يصر قطاع واسع من المسلمين على أن يراه تمرداً مشروعاً!
وإن نظرنا إلى الحالة الراهنة، من منظور صراع مفاهيمي بالدرجة الأولى، فإن هذا الصراع حتى يصل إلى نتيجة ما، لا بد له من مرجعيات مشتركة تحال إليها تلك المفاهيم حتى لا ندخل في دوامة لن يخرج منها أحد معافى، إدراكياً على الأقل. فـ”دوامات” منطقتنا لا تطاول الأفكار والمفاهيم فقط، بل الممتلكات والأرواح أيضاً. تكفي نظرة إلى الخراب العميم الذي نعيش فيه لندرك إلى أي درك وصلنا. ومشكلة المرجعية بشأن الإرهاب تحديداً، إن اعتبرنا أن قدسية حياة المدنيين العزل هي حجر الزاوية فيها، وإن أردنا النظر إليها بعين محايدة قدر الإمكان، حتى لا نضيع في ضباب الاتهام بالانسحاق أمام “الغرب” ومفاهيمه المهيمنة بالقوة العارية للحضارة المادية فقط، إلى آخر تلك الديباجة، فالحق أننا سنجد أنفسنا وقد درجنا على اتهام الآخرين بأنهم يفرضون تعريفاتهم ليكونوا هم الاستثناء، فيما نصرّ على استثناء أنفسنا من كل شيء… حتى من الإدانة الأخلاقية لجرائم ارتُكبت أمام أعيننا بحق مدنيين عزل؛ سواء في أميركا (11 أيلول) أو في إسرائيل (7 أكتوبر/ تشرين الأول).
إقرأوا أيضاً:
ما حدث إبان “الطوفان” الأخير، خير دليل على هذه النزعة الطاغية، كأساس لعقدة مظلومية أريد لها أن تؤبّد من طرفنا. إذ عندما نقول إن هناك مدنيين أبرياء سقطوا أو أُخذوا رهائن، تقفز التبريرات في وجهنا: هذه مقاومة مشروعة، ومن أخذوا أو قتلوا هم محتلون وليسوا مدنيين؛ أو، في حال كان هناك اعتراف بمدنيين سقطوا، فإن أولئك المدنيين قُتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي فقط؛ أو أن سقوط مدنيين من الطرف الإسرائيلي خلال اشتباكات صباح السابع من تشرين الأول، كان نتيجة دخول عدد هائل من مدنيي غزة إلى المناطق التي تم اجتياحها من مقاتلي الحركة، وهم الذين أطلقوا الرصاص على المدنيين (كما ذهب العاروري نفسه في أحد التبريرات الموثّقة في قناة الجزيرة)؛ أو أن حماس، وكل أفعالها، مكروهة فقط لأنها إسلامية، وما التحجج بـ “الإرهاب” إلا ذريعة لإخفاء هذا الحقد الدفين على كل تيارات الإسلام السياسي؛ بل إن الأمر تطور إلى درجة أن واحداً من ألمع المثقفين العرب الحداثيين، وممن لا علاقة لهم، بشكل قريب أو بعيد، بالطيف الإسلامي كله، وصل إلى نتيجة مفادها أن السؤال نفسه حول الموقف من إرهاب حماس هو مجرد “سؤال سقيم ومحشو بالبلاهة”!
والحق أيضاً، أن التلطّي خلف عقدة مظلومية ما، لا يعفينا من إدراك ما هو أمَرّ. إنه ذلك “الإجماع” العربي على الأقل، حيث الحديث عن “إجماع” إسلامي يتطلّب إحاطة لا يمتلكها كاتب هذه السطور، الإجماع على تمجيد العنف بصفته “مقاومة” أو “بطولة” أو ما إلى ذلك من التبجيلات الجاهزة، وهو ما يعكس فكرة مقلقة جداً لا بد من التصدّي لها: إنه العنف بصفته “قيمة” في ثقافة تقاوم، وبعنف، أي تغيير ممكن!
وهنا يمكننا، إن تجرأنا ومضينا خطوة إلى أمام، أن نقر بأن مشكلتنا الحقيقية ليست في “مظلومية”، منفوخة حدّ الانفجار، في مواجهة عالم لا يريدنا أن نكون جزءاً منه، من دون التخلّي عن “قيمنا” و”ثقافتنا”، بقدر ما هي في تلك “القيم” و”الثقافة” نفسها، التي يريد أولئك المستفيدون من تكريس هيمنتها، حتى بما يتعلق بمفهوم أحادي للإسلام نفسه، أن يطوعوا الجميع ليخضعوا لها، أي لهم هم دون سواهم، وأمثالهم، من المستفيدين من فرض تلك الهيمنة عبر قرون طوال في منطقتنا التي كانت معزولة عن العالم، حال باقي مناطقه. ولكن، يبدو أن التاريخ استمرّ في حركته، وصار لا بد من تصغير هذا العالم، وبالتالي ما عاد أحد معزولاً، لمصالح “إمبريالية”، “كولنيالية”، “رأسمالية”… سمّها ما شئت. التغير حقيقة كونية، شكلت مسار تاريخنا كبشر. إذ إن العالم كما تغيّر مرات، سيعيد الكرة مرات ومرات، ومن دون تحديد مسبق للاتجاه، وهذا ما يجعل الرهان هنا مرعباً فعلاً. وبالتالي، يصبح السؤال دائماً، من جهة أولئك الذين يجنون ثمار وضع بات مهدداً بتحديات شتى: كيف بإمكان هيمنتنا أن تدوم في عالم دائم التغيّر، بحيث نجعل حتى هذا التغيّر لصالحنا على طول الخط؟
لكن، هل هذا التكريس لمفاهيم محدّدة لمصلحة فئة مهيمنة، ممكن الحدوث، بالنسبة الى أجيال كاملة من الشباب العرب، نشأوا وترعرعوا في عصر السوشال ميديا، بكل ما تضعه بين أيدي الجميع من ممكنات، ليس للتواصل فقط، بل للاستمرار في تصغير العالم وبالتالي الإمعان في تغييره؟! النظر إلى السوشال ميديا العربية الآن، بعد “يوم الطوفان المجيد”، يقول وبكل أسف إنه ليس ممكناً فحسب، بل إنه صار حقيقة واقعة! إذاً… ما العمل في ظل حالة كهذه؟!
بات المطلوب ليس أقل من مراجعة شاملة لمنظومة القيم التي تشكّل أساس وعينا (حتى ما قبل الإسلام)، وتحديداً لذلك الجانب المتعلق بمفاهيم مركزية كـ “الشجاعة” و “الرجولة” و “الإقدام”، ضمن سياق ذكوري كامل. هذه المراجعة لن تكتسب معناها من دون أن تكون قائمة على مقارنة واضحة بمفاهيم إنسانية أكثر رحابة وحداثة، تطرحها تجارب حضارية مختلفة، وأكثر تقدماً وبما لا يقاس، من المنظور الإنساني على الأقل، عن تجربتنا نحن. كيف، ولماذا هي متقدّمة؟! هذا جدال له مجاله الخاص بعيداً من تلك السطور التي تحاول الوصول إلى نتيجة محدّدة تتعلق بأولئك المستفيدين من تكريس ثقافة العنف الذكورية المذكورة أعلاه في منطقتنا: الأنظمة العربية المستبدة، بمختلف أشكالها، وحلفاؤها الإقليميون والدوليون.
لكن، هل هؤلاء المستفيدين فئة قليلة ومعزولة ولها مصالحها المحدودة التي تأتي على حساب مصالح الفئات الأوسع من عموم الشعب؟ العادة جرت أن “خط الصراع” هذا، بمقدار وضوحه، بمقدار ما يؤسس لوعي جديد، مناهض لذلك التقليدي الذي يريد الهيمنة الأبدية. ولكن، وعلى ضوء ما نشاهده ونسمعه من تلك “الفئات الأوسع” بعدما امتلكت وسائل إيصال رأيها وطرحه في أي مجال عام، حتى ولو كان افتراضياً، وهو غالباً كذلك، على ضوء هذا، فإن “خط الصراع” يبدو في مكان آخر تماماً، لا علاقة له بأية مصالح، سوى تلك المصالح التي يحددها “المهيمنون”، الذين فرضوا صيغة وصورة واحدة لكل ما يتعلق بنا، حتى لـ “الإسلام” نفسه، وكما يروه، وفقهاؤهم معهم.
“خط الصراع” الآن، في منطقتنا والعالم، يبدو أنه يتعلق بـ “منظومة قيم”، يفترض أنها “أصيلة”، في مواجهة “منظومة قيم” أخرى أجنبية، “غربية” تحديداً، تريد فرض هيمنتها على الجميع. وبمتابعتنا لما يقوله كثر ممن يرون الأمور من هذه الزاوية، من بطل العالم في قتل المدنيين، متفوقاً حتى على جيش الدفاع الإسرائيلي في التعمد المباشر للمدنيين والمنشآت المدنية، فلاديمير بوتين؛ وصولاً إلى نجم كرة قدم معتزل، وباحث عن دور خارج الملعب بحجم دوره هناك، محمد أبو تريكة؛ مروراً بعلي خامنئي، وتشي جي بنغ، ونجوم ماكينات الإعلام الممولة خليجياً بإفراط، وحتى عبد الفتاح السيسي، وسفاح الكيماوي المغرم بالتعريفات ونظرية الأواني المستطرقة، بشار الأسد؛ فسنجدهم جميعاً لا يتحدثون عن شيء سوى عن حق “الاختلاف” في عالم تريد أن تهيمن عليه ثقافة واحدة!
ضمن هذا السياق، يمكننا فهم كيف أن الإسلام نفسه حُشر في زاوية واحدة، ليس ممّن قاموا بتحديد معنى واضح للإرهاب، بل ممن يريدون للمعاني أن تضيع، في سبيل بسط هيمنتهم فوق رؤوس الجميع. وبالتالي، فإن الدفاع عن الإسلام، في مواجهة أية تهمة بالإرهاب، تتطلب تحريره أولاً من تلك الهيمنة لفتح الأفق أمامه للدخول في ذلك العالم الجديد. إلا إن كان البعض، وهم كثر للأسف، يرون أن هذا ليس عالماً جديداً.. إنه فقط عالم “غربي”، وهو، لذلك، لا يعنينا.
هنا، ليس بإمكان المرء إلا أن يصاب بالارتباك فعلاً، هذا إن لم يصل إلى حالة من الذعر الشديد، ليس فقط بسبب من يرون أن العالم يجب ألا يكون “غربياً”، من أمثال المذكورين أعلاه أصحاب المصلحة في فرض هيمنتهم؛ بل أيضاً لأن عدداً هائلاً ممن يفترض أنهم الأكثر تضرراً من تلك الهيمنة، بمختلف أشكالها، وأولها الثقافية، يدافعون عن هذا الرأي بكل ما أوتوا من قوة، وكأن المسألة لا تعدو كونها كيداً بكيد!
وحتى لا يبقى “الرأي العام” العربي والمسلم المناهض للغرب، والمؤيد لحماس، تحت ذريعة كونها مقاومة، متهماً وحده بالقصور والكيدية (مع أن المقال تناول “نجوماً” لتلك الظاهرة ليسوا عرباً أو مسلمين، إلا أنه لا يمكن تجاهل أن الظواهر الإنسانية في عمومها، قابلة للتكرار في أزمنة وأمكنة مختلفة، “شرقاً” و”غرباً”، ولا تقتصر على عرق أو فئة محدّدة من البشر، أو “جهة” من جهات العالم)، فإن نظرة على مكان آخر من العالم، الجهة “الغربية”، تعطينا الانطباع نفسه، عندما نراقب مثلاً “القاعدة الصلبة” من جمهور الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأميركية المؤيدة لدونالد ترامب. هؤلاء أيضاً لهم تعريفاتهم الخاصة والتي تطاول كل شيء، بعيداً من منظومة قيم، غريبة، تريد فرض هيمنتها على الجميع… هذه التعريفات الجديدة بدأت تعيد النظر في أعمال “بطولية” سابقة، مثل الأعمال الإجرامية لعصابات الـ “كلو كلوكس كلان” نفسها. بل إن هناك “مثقفين” من المحيطين بترامب، لم يترددوا لحظة بتطعيم خطابات “نبي الانتقام” الجديد هذا، بعبارات كاملة من خطب أدولف هتلر نفسه، ومن دون أي خجل أو تردد. وهذا طبعاً من دون تناول الصعود اليميني المتطرف في عموم المشهد السياسي الأوروبي، ودوافعه وآفاقه… هذا بحد ذاته فيلم رعب كامل.
حتى “الغرب” نفسه لديه ما يكفي من تحديات وصراعات داخلية، تجعله فاقداً تركيزه في تآمره اليومي الذي لا يكل ولا يمل، على العرب والمسلمين وحدهم، من دون بقية خلق الله، بحيث يمكننا أن ندرك، ولو للحظة، أن التعريف الذي وضع للإرهاب، بالاستناد إلى تجارب دموية مكلفة، كان يطاول الإرهاب وحده، كائناً من كان مرتبكه، وليس الإرهاب الممارس من مسلمين فقط.