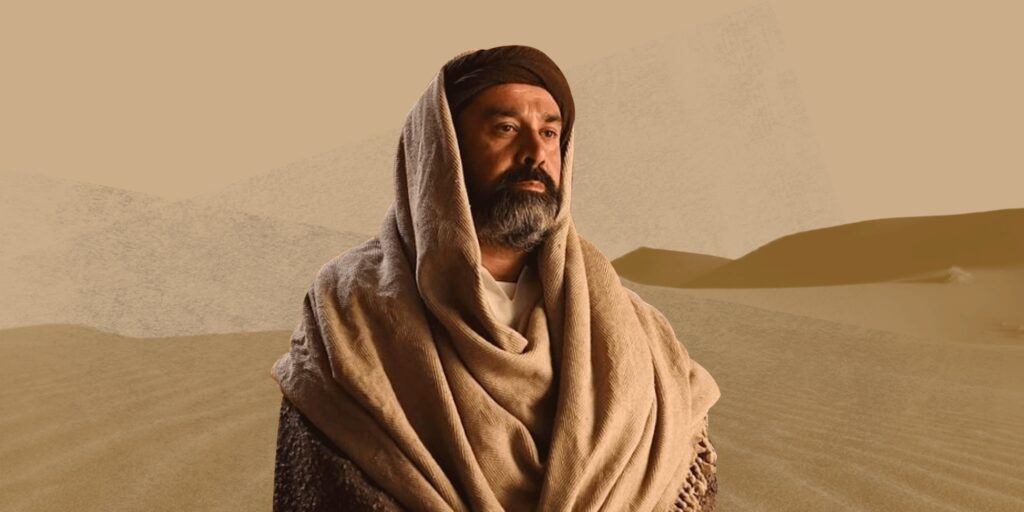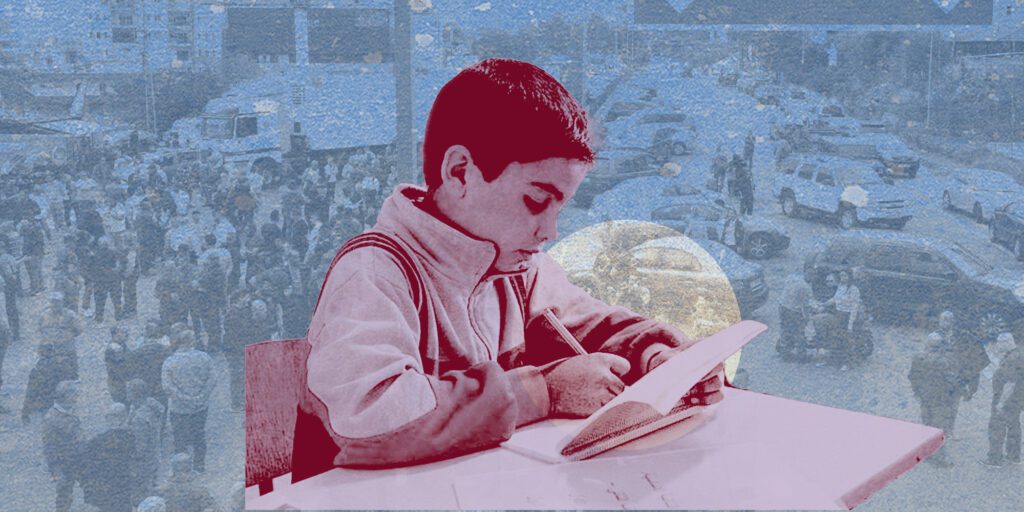احتجّ بعض السوريين، الدمشقيين منهم بالدرجة الأولى، إثر الشعبية الكبيرة التي حققها مسلسل “باب الحارة” الذي اشتهر في العقد الماضي وتكررت مواسمه الرمضانية. احتجوا على “التزوير” الصريح الذي مارسه صناع المسلسل على تاريخ مدينة دمشق وحاراتها.
كان مبرر الاحتجاج أن مدينتهم وحاراتها بالتالي، لم تكن مغلقة ولا شديدة التخلّف، بالطريقة التي قُدِّمت من خلال هذا المسلسل وأحداثه وشخصياته. بل إنهم استعرضوا مراحل “مضيئة” من تاريخ تلك المدينة التي بقيت منفتحة على كل جديد مفيد، ومتفاعلة مع كل الأفكار والرؤى والنزعات المتنوعة.
المدهش طبعاً، أن كل الشواهد التي استُحضرت كانت بالكامل قبل عهد الظلام البعثي، والافتراس الأسدي اللاحق. إذ حرص المستشهدون على حصر استشهاداتهم في فترة لم تتجاوز منتصف الخمسينات من القرن العشرين على أقرب تقدير، أي قبل الدخول في ورطة الوحدة مع نظام البكباشي، التي مهدت بدورها للظلام البعثي مباشرة!
طبعاً عذرهم كان أنهم يريدون فقط أن يقاربوا تلك الفترة التي تحدّث عنها المسلسل، وهي مرحلة “الاستعمار” الفرنسي لسوريا. وهذا طبعاً من دون أي ذكر لموضوع أن تلك الرؤى والنزعات والأفكار الجديدة والمتنوّعة إنما ساهم فيها الانتداب الفرنسي نفسه (الانتداب وليس “الاستعمار”، حيث يقول كثر من السوريين الآن: يا ليته كان استعماراً) بدور لا بأس به، ناهيك بجلب تلك النزعات والرؤى والأفكار وجعلها جزءاً من المشهد السوري العام. وذلك عبر إدخال الكثير من “المؤسسات” الحديثة إلى حياة السوريين، لتصبح أساسية في تطوير حيواتهم وفتح أفق جديد لها، لم يكن مفكراً به حتى، في ظل هيمنة العائلات المسيطرة، والبنى التقليدية التي دعمت تلك الهيمنة وحاولت أن تديمها.
وبغض النظر عن سوية المسلسل الفنية، وعجزه الواضح عن تقديم “رؤية” تحتمل ولو حد أدنى من العمق، فإن المسلسل كان وفياً فعلاً لفكرة بسيطة وواضحة: الحياة في ظل وضعية كل فرد فيها يعرف “مكانته”، وفي ظل سطوة “عكيد” شهم يحرس “القيم”، و”باب” يغلق دائماً في نهاية كل يوم على جميع أبناء الحارة، أكثر أماناً بكثير من الحياة في أي مكان آخر لا يملك تلك “المزايا”. وربما كانت هذه الرسالة، البسيطة جداً والواضحة، سبباً رئيسياً في شعبية المسلسل المذكور، غير المسبوقة في تاريخ الدراما العربية عموماً.
لماذا كانت هذه الشعبية الكبيرة، وعند شرائح واسعة من الجمهور السوري والعربي عموماً، عدا عن أولئك المحتجّين؟ لأنها ببساطة تسوغ الحياة في ظل الديكتاتور، الذي أحببنا أن نراه “عكيداً شهماً عادلاً”. إنها تقول لنا إننا طبيعيون جداً، ولا ينقصنا أي شيء. أي أننا لسنا أذلاء ومضطهدين وأقلّ من غيرنا من بني البشر بسبب هذا الذل والاضطهاد؛ بل إنها تزيد لتقول إننا أفضل وبكثير من غيرنا!
لم يلبث “باب الحارة” أن حُطّم، لأسباب لها علاقة بتلك اللحظات “المضيئة” التي استشهد بها رافضو المسلسل، وخرج سكان “حارة الضبع” إلى العالم الخارجي مطالبين بحقهم بأن يُعترف بهم كبشر وليس مجرد رعايا لـ “العكيد”… ولكن “العكيد” بدوره، لم يلبث أن أخذ المبادرة ورمّم الباب وأعاد حبس من لم يتمكّن من رعاياه من الفرار خلفه.
وعاد الجميع، من علق داخل الحارة، أو من تمكن من الفرار منها، إلى ندب حظّهم في مواجهة عالم غرّر بهم ودفعهم الى الثورة تحت شعار قيم إنسانية رفيعة، كالحرية والديموقراطية والمساواة، ولكنه غدر بهم وتركهم يواجهون مصيرهم الأسود وحدهم، لأنهم ببساطة اكتشفوا أن مصالحهم مع “العكيد” أهم بكثير من دفاعهم عن تلك القيم، التي يبدو أن العالم (الغرب) يرى أنها جديرة بالتطبيق في بلادهم فقط، من دون بقية البلاد… الحارات.
فهل هذا ما حدث فعلاً، أم أن “الحكاية” فيها تفاصيل أخرى أصرّ أهالي “حارة الضبع” على إخفائها، لأنهم ببساطة، وإن حطموا “باب الحارة”، إلا أن حاجز الخوف داخلهم، والذي توهموا أنهم حطموه، بقي في مكانه، بل وعاد أعلى وأكثر منعة مما كان سابقاً؟!
يتناول حازم صاغية في كتابة “رومنطيقيو المشرق العربي”، أسباب عجز ثورات الربيع العربي عن بلوغ أهدافها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواجهة الأنظمة التي ثار الناس ضدها، ولكن على الأرضية القيمية نفسها التي بنتها تلك الأنظمة ورعتها طيلة عقود حكمها الاستبدادي.
ويحلل، بشكل متألّق، حالتي سوريا ومصر، محدداً بدقة أين كان الخلل في تلك المواجهة، التي كانت تتم باستناد الطرف الثائر إلى “منظومة القيم” نفسها التي رسخها النظام الاستبدادي الذي ثار الناس ضده. في حالة سوريا، بقي السوريون يراوحون على الأرضية ذاتها التي أسّسها النظام، وبالتحديد في نقطتين مهمتين: فلسطين / إسرائيل، وموضوع هوية سوريا الجديدة، أهي عربية حصراً أم أنها ممثلة لمختلف مكونات الشعب السوري، ومن بينهم الكرد.
وفي مصر، كانت فكرة تقديس الجيش هي الأرضية التي وقف عليها النظام ومعارضوه على حد سواء. النتيجة في كلتَي الحالتين، السورية والمصرية، فشل ذريع في الانفصال، حتى خطابياً، عن النظام الذي ثار الناس ضده. لم يفلح الثائرون في تشكيل رؤية جديدة، مفارقة، لتلك التي كرسها حكم استبدادي دام عقوداً سوداء طوال، في كلَي البلدين، وفي نقاط في غاية الحيوية لخلق أفق جديد لأولئك الثائرين.
لكنْ، هناك سؤال يخطر في البال ما أن يستعيد أحدنا تلك الأيام التي عشناها في شوارع أعاد الناس احتلالها كفضاء عام ملك لهم، كما يجب أن تكون دائماً؛ هل كانت الحقائق أعلاه غائبة عنا في تلك اللحظات الاستثنائية التي عشناها، والتي باتت تشكّل أثمن ما امتلكه واحدنا في حياته كلها؟! لا… لم تكن غائبة، على رغم أننا لم نمتلك الجرأة كاملة للمضي خلف أحلامنا إلى نهاياتها، حتى ولو تطلب الأمر عبور خطوط حمراء وهمية، “مسلمات” كرّستها الأنظمة التي جلدت حتى أرواحنا، ولم نفعل شيئاً سوى أننا كرّسناها أكثر بتردّدنا وخوفنا هذا. بل إن الأمر استمر معنا إلى يومنا هذا، وتجلى في مواقف كثيرة “فضحت” نفاقاً واضحاً وخوفاً مزمناً، من طرفنا (نحن الذين يفترض أننا ثرنا) عندما يتعلق الأمر بمواجهة أي من تلك “المسلمات” المذكورة أعلاه.
يحار المرء في أمرنا، نحن من يفترض أننا كسبنا حريتنا بالخروج خارج “الحارة”، ومع ذلك بقينا مشدودين بخيوط فولاذية إلى تلك “المسلمات” التي تعيدنا إلى حيث كنا، منافحين عن قيم “العكيد”، ما أن نجد أنفسنا في مواجهة تفرض علينا مواقف واضحة. مقتلة غزة الأخيرة خير مثال. ولكن، قبل الوصول إلى تلك اللحظة “الفارقة” فعلاً، دعونا نعود قليلاً إلى بعض تجارب خروجنا إلى الفضاء العام، ولو بشكل مقنن وبرضى “العكيد” وشبيحته، قبل أن نتمرد عليهم جميعاً. ربما البداية، كما النهاية، هي دائماً مع فلسطين.
في التظاهرات الحاشدة التي كنا نعقدها في شوارع دمشق، أو القاهرة، أو بيروت، أو أي من المدن العربية، مندّدين بظلم إسرائيلي فادح بحق الفلسطينيين، الظلم الذي لم يتوقف عن البطش بضحاياه حتى يومنا هذا، كنا ندرك، على رغم علو صوتنا بمطلب محق لا ريب، أن الأمر حدوده هنا، ليس في ما يتعلق برؤى مختلفة لذلك الصراع المضني مع قوة احتلال غاشمة فعلاً، بل بمصيرنا نحن، الواقعين تحت ظلم لا يقل بطشاً وغشماً عن ذلك الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.
كنا ندرك يقيناً، وأصواتنا تملأ الفضاء مطالبين بالحرية والعدالة لـ… غيرنا، أن الشبيح الواقف على ناصية الشارع يراقبنا بكل مكر واحتقار، قادر على جلب أي واحد منا، ومسح الأرض به أمام الجموع، فقط من باب التنفيس عن غيظ، ربما ظهر بسبب علو أصواتنا، ولو ضمن السياق الذي حدده سلفاً “العكيد” نفسه.
لم تلبث أصواتنا أن طاولت الشبيح وعكيده في ما بعد، ولكن الشبيح، في الحالة السورية، بدأ يعيرنا بأننا نقوم بما قمنا به فقط خدمة لإسرائيل. مع أن “العكيد” نفسه، وعندما وجد أنه لن يلبث أن يهزم أمام ثورتنا، طلب العون فوراً من قوى خارجية، إيران وروسيا، وسلّمها زمام الأمور في البلاد كلها!
مع ذلك، لم ننجح في تجاوز تلك العقبة، محطّمين الأرضية التي وقف عليها “العكيد” معيراً إيانا بتنفيذ مخطط إمبريالي أميركي – إسرائيلي ضد حكمه، بل اكتفينا بتعييره أنه هو من لجأ إلى قوى خارجية لتبقي قبضته فوق رقابنا… بينما بقينا أحراراً مستقلين نرفض طلب العون من أحد، إذ إن عون ثورتنا المحقّة هو شرف لكل من يساهم في هذا (كاتب هذه السطور واحد ممن نافحوا وبحماسة منقطعة النظير عن هذه الفكرة)، من دون حتى أن نسمي جهات محددة نخاطبها بالاسم لمنحها هذا “الشرف”؛ أميركا والغرب عموماً.
اكتفينا بالنظر إلى ذلك “الغرب” بصفته غدرنا وباعنا لـ “العكيد” من دون حتى أن نقدم له أي شيء يقول له بوضوح إن مصلحته هي معنا وليس مع خصمنا، وأن نعطيه ضمانات واضحة بأن نصرنا، إن تحقق، فلن يعود العالم إلى كابوس “قاعدة” جديدة، وفي قلب الشرق الأوسط هذه المرة.
إقرأوا أيضاً:
أفضل ما تفتّقت عنه “عبقرية” بعض ممثلي ثورتنا، هو أن نطالب الغرب بألا ينظر فقط إلى “لحى” الثوار! هذا من دون ذكر حاجتنا إلى تحديد موقف واضح من إسرائيل. تلك التي عجزنا عن مخاطبة رأيها العام، على الأقل، لننقل لهم فكرة أن نجاح ثورة السوريين فرصة تاريخية، لا يجب أن تفوت، لجميع شعوب المنطقة، أقله السوريون والإسرائيليون والفلسطينيون واللبنانيون، ليعيشوا بسلام حقيقي للمرة الأولى في تاريخ الاحتكاك الدموي المزمن بينهم، وليجدوا وسائل أخرى للتفاهم في ما بينهم على كل الخلافات القائمة، من دون حمام دم عند كل احتكاك.
بقينا تائهين في تحديد معسكر حلفائنا، محلّقين في هواء أحلام طاولت السماء. بينما بقي “العكيد” وشبيحته على الأرض، محددين معسكر الأصدقاء والأعداء بدقة، وقادت نهاية المغامرة إلى إعادة ترميم باب الحارة وإغلاقه على من بقي منا داخلها، وتحويلهم من رعايا يمكنه فعل ما يشاء بهم، إلى رهائن يبتزّنا، نحن من تمكّنا من الفرار، من خلالهم!
وللإنصاف، فإن هذه “الرومنطيقية” الفائضة من جهتنا، لم تتأتَّ من قلة نضج ونحن نحتك بعالم جديد علينا كل الجدة، ونحن نخطو خطواتنا الأولى باتجاه أن نكون جزءاً منه، بقدر ما تأتت من ذلك الخوف الذي لم نستطع أن نتجاوزه، كما ادعينا ونحن نعيد احتلال شوارع مدننا من جديد. هذا الخوف الذي عاد يطل برأسه، في محطات عدة من مسار “تغريبتنا” الطويلة.
ليس أقل تلك المحطات، ذلك القرار المهين لعموم السوريين، بتعيين مراسل قناة حزب الله في دمشق مديراً لتلفزيون “سوريا”. المراسل الذي غطى مذبحة داريا ضد سكان المدينة التي نفذتها ميليشيات الأسد، بصفتها عملية عسكرية مشروعة ضد إرهابيين. الرجل لم يكلف نفسه عناء حتى أن يعتذر، وباشر مهام منصبه بصفته أول مدير لأول محطة تلفزيونية، بتمويل وإشراف قطري، يفترض أن تكون ناطقة باسم ثورة السوريين. حيث عمل تحت إدارته من كان يفترض أنهم ضحوا بكل شيء لاستعادة بلادهم.
المثير، أن عدد المعترضين على إثارة هذه النقطة بالذات، في مواجهة ذلك القرار المهين، ومن السوريين المنتمين إلى طيف “الثورة” العام، كان أكبر وبكثير من أولئك الذين ركزوا على هذه النقطة وطالبوا برفع تلك الإهانة، والاعتذار عنها. والذريعة كانت دائماً: لقمة العيش لأولئك الذين لا يمكنهم أن يفوتوا فرصة العمل في مشروع يمكن أن يشغل مئات منهم، بلا أي بديل واضح في الأفق… ها قد عدنا إلى “الأرض”، ولكن رغماً عن أنوفنا هذه المرة!
وهذه العودة بالذات، وبالطريقة التي تمت بها، هي ما تجعلني أشك دائماً في دوافع موقف أخير، أبداه كثير من السوريين والمصريين، والعرب عموماً، المهاجرين إلى الغرب، خصوصاً أولئك الذين شاركوا في الربيع العربي، الموقف المطالب بوقف إطلاق نار فوري في غزة، ومن دون أي ذكر للأسرى المدنيين لدى حماس.
المشكلة عندي، ليست في مشروعية الطلب، وهو مشروع ومحق من دون أدنى ريب، المشكلة في طريقة صياغته، تلك التي لم تلحظ أي حق للرهائن المدنيين الإسرائيليين، وبينهم أطفال رضع ومسنون بلغوا الثمانينات من أعمارهم، في أن يطلق سراحهم فوراً أيضاً ومن دون شروط مسبقة.
لم نجرؤ على المطالبة بهذا، ليس لأننا لا نزال مقتنعين بأن الإسرائيليين كلهم مجرمون مستوطنون يريدون قتل الفلسطينيين هكذا من دون تمييز (بين الرهائن سيدة إسرائيلية من المناصرين لحقوق الفلسطينيين وهي في ثمانيناتها، وهناك مصابة بمرض السرطان وبحاجة إلى عناية مستمرة، وهناك كثر من كبار السن..
ومع ذلك أخذوا رهائن ولم يطلق سراح معظمهم إلا بمفاوضات عسيرة مع الجانب الإسرائيلي، شديد العناد وغير الراغب في إيجاد حلول بدوره)، لم نجرؤ على النظر إلى هؤلاء بعين إنسانية بداية، لأننا لم نستطع مغادرة تلك الأرضية، “منظومة قيم العكيد”، ولكن هذه المرة المحمية بقوة أكبر بكثير مما كان الأمر عليه مع “عكيد” حارة الضبع، الذي أصبح بدوره أسيراً لمن أحضرهم لإنقاذه. بقيت منظومة القيم كما هي، ولكن هذه المرة تحت حماية “عكيد” جديد، والذي لديه من الموارد ما لم يكن لأي طاغية في الأرض أن يحلم به.
وما خلا بضعة أصوات، شجاعة، داخل العالم العربي وخارجه، وسمت ما حدث في صباح السابع من تسرين الأول/ أكتوبر بصفته عملاً إرهابياً يجب أن نراجع بشأنه كل منظومة مفاهيمنا لنتمكن أقله من إيجاد طريقة لفهم العالم الذي يحيط بنا، وللتواصل معه بطريقة أو بأخرى، ما خلا تلك الأصوات، كان الإجماع يكاد يكون تاماً على رفع الصوت فقط بحق الفلسطينيين، المشروع جداً والذي لا جدال فيه، بحياة كريمة، ولكن ونحن ننظر بخشية، بطرف أعيننا، إلى الشبيح الرابض على ناصية الشارع يراقبنا بمكر واحتقار، شبيح “عكيدنا” الجديد.
هل كنا عاجزين عن فهم حقيقة ما حدث، وأخذ موقف واضح منه، ونحن من شاء حسن حظنا، ولو على المستوى الشخصي، التمكن من الفرار من قبضة “العكيد” والعيش، ولو بأمان نسبي، في الغرب؟ الأصوات الشجاعة أعلاه، وهي لا تقتصر على المحظوظين الذين تمكنوا من الفرار فقط، تقول إننا لم نكن عاجزين أبداً.
إذاً، لماذا انقادت غالبيتنا الساحقة خلف “الكذب” القديم ذاته وبقيت أسيرة المفاهيم البالية ذاتها؟ لأننا ببساطة مجبرون على العودة إلى الأرض، رغماً عن أنوفنا مرة أخرى، والتفكير في مستقبلنا الشخصي، بعيداً من “أوهام” الحرية، فردية كانت أو جماعية، في غرب، اكتشفنا مصدومين، كم أن الحياة فيه صعبة وتتطلب تجاوز عقبات لم تكن تخطر ببالنا ونحن نسعى لاهثين الى الوصول إلى بره الآمن. حتى اللغة، وهي أول تلك العقبات، ما زلنا، وبعد سنين، نحبو في مراحلها الأولى، نحن الذين كنا “نخباً” في بلادنا.
وبعدما كنا تمكّنا من احتلال المتن، شوارعنا، بجدارة ولو للحظات، عدنا إلى الهوامش مرة أخرى، حيث كنا أعلنا ضيقنا بمسلسل حقق نسب مشاهدة مرتفعة، نراه غير جدير بها، من دون أن نحاول، وفي الحالتين، عندما كنا في الهوامش، وعندما قفزنا إلى المتن، أن نمس جذر المشكلة “منظومة قيمنا البالية”. وها نحن نعود إلى الهامش مرة أخرى، ناقدين “منظومة قيم الغرب” هذه المرة، كما نراها ظالمة ومنحازة الى إسرائيل بشكل مطلق، حيث لن يسمعنا أحد، إلا من نعرف سلفاً أنه الوحيد الذي سيسمعنا، “عكيدنا” الجديد، مرددين النغمة ذاتها التي يريد سماعها، ليعطينا خط رجعة إلى “حارتنا” الجديدة المزدهرة، حيث “جودة الحياة للمواطنين وضمانها، هي العنوان الأول”، ولكن الخاضعة في الوقت نفسه، حتى الخشوع، إلى منظومة القيم القديمة ذاتها. نعود طائعين مختارين، ومحتفظين بلقب “أحرار” من زمن مضى، ربما كنا آخر من يريد له أن يستعاد مرة أخرى.