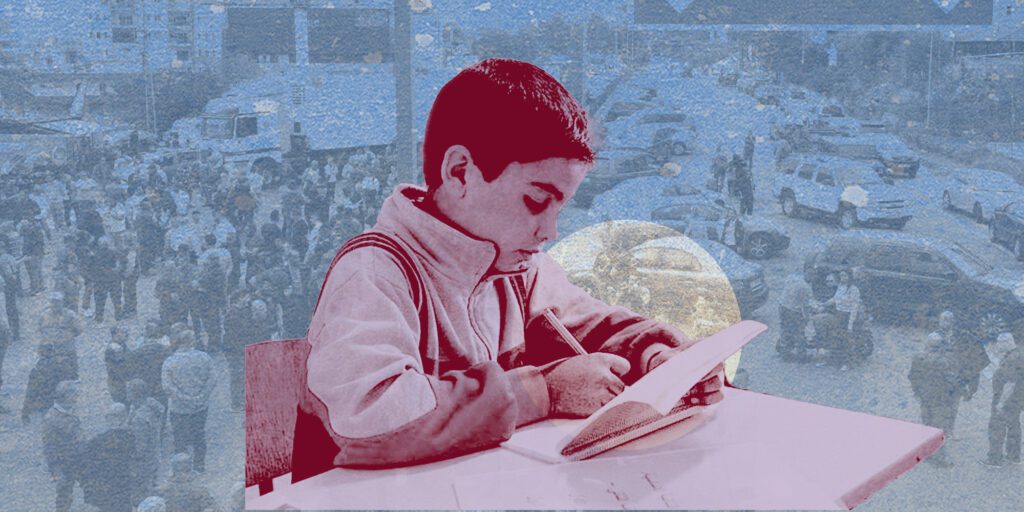نشأ المسلسل الدرامي المصري في أحضان التلفزيون حديث التأسيس والدولة الناصرية المركزية في الستينيات. حتّمت هذه النشأة أن يحمل النوع الدرامي في حمضه النووي فكرة الرسالة الموجّهة الى الجميع؛ فالتلفزيون مركزي، يصل الى كل بيت وأسرة، لا قنوات منافسة له، ولا فرصة للخروج عن الرسالة الموجّهة التي تتحكم بها جهة الإنتاج الوحيدة.
بحكم جاذبية الحدوتة وأدوات الدراما من التمثيل والتأثير العاطفي واستعمال اللغة العامية القريبة للجمهور، أصبح المسلسل الدرامي تدريجياً الأداة المثلى لتوصيل “الرسائل”. خلال أكثر من أربعة عقود، استثمرت الدولة المصرية في إنتاج المسلسل الدرامي الرسالي، بانتظام يبلغ مداه الأقصى في شهر رمضان، الذي تحوّل مع السنوات الى شهر “الفُرجة”، وتوازت طقوسه الاجتماعية مع إنتاج درامي مكثّف.
غابت المركزيّة وحضر صوت النادمين
لم تكن رسائل المسلسلات الدرامية تتعلق فقط بما تسعى الدولة الى توصيله من خطابات عن مركزيتها في حياة المصريين، ونوع القيم الاجتماعية التي تحاول تعزيزها أو نبذها. وإنما أصبح المسلسل تدريجياً قناة تلجأ إليها نخبة من المثقّفين والكتَّاب الذين تشبعوا بالخطاب الناصري حتى بعد زوال دولته، بل خصوصاً بعد زوال دولته.
فتحت الدولة قنواتها التلفزيونية (التي ظلت مركزية حتى بداية الألفية الثالثة) لفئة من مؤلفي المسلسلات تمتاز بالأساس بنبرة نادمة على فراق عهد المركزية التامة. تفلتت السينما والموسيقى كثيراً أو قليلاً من الإنتاج المركزي، إلا المسلسل الدرامي، الوعاء الوحيد لاستيعاب الناقمين على غياب سيطرة الدولة على الجمهور وذوقه، على القيم التي تبدَّلت ومصادر الرزق التي تبعثرت على غير ذوي الشهادات، على الحرفي الجاهل الكسّيب، على فضة المعدّاوي وأمثالها، على كامب ديفيد وعلى أحمد عدوية وبدرية السيد.
بفضل هذا الجناح النخبوي السلطوي الذي استوعبته الدولة، التي تسعى الى استيعاب الجميع، أصبحت رسالة المسلسلات في منزلة خطاب فوقي مهمّته الإجابة المتجدّدة عن سؤال “ماذا حدث للمصريين؟”- إجابة شاملة لسؤال شامل عن الكُل الواحد- كل المصريين. الافتراض الدائم في تلك المسلسلات هو أن ما حدث كان سلبياً في عمومه، يسعى كل كاتب الى تفسيره بطريقته، ولكن النتيجة محسومة سلفاً. سواء كان السبب هو المال الحرام أو تفريط الدولة أو فساد الأغنياء أو هزيمة الفارس جمال عبد الناصر. في كل الأحوال، هناك عطب ما، وهناك شعب لم يعد كُلاً واحداً، وهناك قيم ضائعة، وهناك دولة ارتخت قبضتها.
بحكم جاذبية الحدوتة وأدوات الدراما من التمثيل والتأثير العاطفي واستعمال اللغة العامية القريبة للجمهور، أصبح المسلسل الدرامي تدريجياً الأداة المثلى لتوصيل “الرسائل”.
الألفيّة الثالثة وتفكيك خطاب الإدانة الدراميّة
هذه اللغة والحالة الدرامية تحوّلت تدريجياً مع تحوّل نظم الإنتاج، مع تعدّد الشبكات الفضائية والدول العربية التي تدخل الى عالم المسلسل الدرامي باتجاهاتها المتعارضة، ومع اكتشاف الشرائح الجماهيرية ذات الأذواق والطلبات المختلفة أيضًا.
لم يعد ممكناً تقديم الإجابة الشاملة، ونسخة الدراما السنوية التي تحيط المصريين علماً بما حدث لهم وتفسيره. ابتعد جيل النادمين تدريجياً عن تصدّر عملية التأليف الدرامي، وبقيت بعض آثاره على أسلوب كتابة المسلسل، وانتقلت أصوات الشجب والندب إلى شبكات التواصل الاجتماعي، تنعي الدراما التي انهارت وفقدت “الريادة”، الشعار المفضّل لوزير الإعلام صفوت الشريف في آخر عهود السيطرة التامة لقطاع الإنتاج في الإذاعة والتلفزيون.
نتيجة لذلك التحوّل، انتقلت المسلسلات الى الموضوعات التفصيلية، التي تخص شرائح بعينها، والتي تبحث قضية محدودة، سواء كانت جريمة أو علاقة عاطفية أو طبيعة مهنة أو حياة أسرة من طبقة معينة، أو كل ما سبق في تشابكات معقدة. في كل الأحوال، لم تعد تسعى الى الإجابة نيابة عن الجميع، ولا لتفسير كل شيء.
أقصى ما تستطيعه هو تغطية حال محدد، لفئة محددة، من وجهة نظر محددة. ولكنها احتفظت في غالبية إنتاجها بسمة رئيسية موروثة من عهود سيطرة النادمين المنتحبين: الإدانة المسبقة التي تحرّك الدراما. فالمؤلف/ة يتناول ظاهرة محددة، سلبية، ثم يسعى طوال الحلقات الى توفير الأسباب والدوافع وبعض الأعذار للشخصيات، ثم ينتهي المسلسل بأن ينال الظالم جزاءه، أو يُعاقَب من انجرف في طريق الخطأ على غفلته وتقصيره. المسطرة القيمية حادة ولا ترحم، والمنحرف عنها لا بد أن تطوله لعنة ما.
بذلك، يمكن أن نتصوّر أن معظم الإنتاج الدرامي ظلّت مهمته هي إعادة التأكيد على تلك القيم، وإعادة إنتاج الخطابات الاجتماعية ذاتها، حتى لو أظهر المؤلفون تسامحاً أكبر مع الخطّائين من ذوي النوايا الحسنة أو البراءة الغفل، المسطرة واحدة.
أما المغامرون من المؤلفين فهم من رأيناهم في السنوات الأخيرة يمتحنون القيم ومسطرتها، من أقدموا على كتابة المسلسل من دون أن تكون الإدانة مثبتة سلفاً. والحقيقة، أن هذه الرؤية تتماشى أكثر مع طبيعة الإبداع والبديهة البسيطة. إذ ما هو المثير في عمل يبلغني ما أعرفه بالفعل؟ أو يؤكد لي أن توقعي نهايته سيكون صحيحاً معظم الوقت؟
بالإضافة إلى الأسئلة السابقة، لماذا تستمر كل تلك الممارسات السلبية التي أكدت مئات المسلسلات، قبل هذا الأخير، فظاعتها وسوء جزائها؟ ولماذا يُقبل عليها كل هؤلاء ويحتاجونها؟ لماذا لا تُرعبهم حرمانيتها الدينية ولا تردعهم عقوباتها القانونية؟ لماذا تُغري بالإقدام عليها على رغم العواقب المتوقعة؟ ولماذا تظهر منها تفريعات متجدّدة في كل عصر وأوان؟
الشخصيات الدراميّة على رقعة الشطرنج
في مسلسلَي “صلة رحم” (تأليف محمد هشام عُبيّة- إنتاج شركة “سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان)“) و”أعلى نسبة مشاهدة” (تأليف سمر طاهر عن فكرة ياسمين أحمد كامل- إنتاج شركة “إي بروديوسر”)، وضع المؤلفون السؤال قبل الدراما، أي جعلا السؤال مُحرِّك الدراما، وليس الإجابة التي يعرفونها ونعرفها. من هنا، تغيّرت الدراما نفسها.
في “صلة رحم”، تٌطرح مسألة الإجهاض والسعي الى تأجير الأرحام، وهناك بالطبع الإجابة السهلة والمريحة للمعتادين على الإدانة المجانية، الزِّلة التي يقع فيها الإنسان/ة، الذي يتبع رغباته من دون أن يحسب العواقب. لكن المؤلف يذهب الى تساؤلات أكثر تعقيداً. فتيات الإجهاض لسن جميعاً ضحايا رغباتهن.
هناك من تكره زوجها العنيف المتخلّف، وتخشى أن يورطها الإنجاب في علاقة أبدية معه. وهناك من تريد أن تبدأ حياة جديدة مع رجل يحبها عوضاً عن رجل اغتصبها. وهناك من تخشى الفضيحة. وهناك من لا تقدر على أعباء تربية طفل وحدها بعدما هجرها أبوه، سترميه حتماً للتشرّد واليُتم، فيما أهله أحياء. إلا أن ما يجمع كل تلك الفتيات هو وحدة الحساب. كلهن متيقنات أن حسابهن عسير، مختلف كليةً عن حساب الذكور الذين وضعوا معهن بذرة هذا الحمل.
هذا رأي دكتور خالد صاحب عيادة الإجهاض، الذي يوظف نظرته الاجتماعية لخدمة نشاطه غير القانوني، فينقسم في عين المشاهدين الى شخصية ذات أوجه، قواعدها صارمة في رفض إجراء عملية الإجهاض مرتين للفتاة نفسها، فالمرة الأولى إنقاذ والثانية تشجيع على الرذيلة. مجرم في عين القانون ومُصلح اجتماعي في عين نفسه. أما الممرضة سهام التي تشاركه عمله، من دون أن يدري زوجها الشيخ السلفي، فلا تحتاج الى كل هذه الفلسفة. هناك بيت فقير وأفواه جائعة، وزوج يعيش في الإنكار، يكره أن تنفق زوجته أكثر ولا يفعل شيئاً، يحتجّ على خروجها في ساعة متأخرة ولا يفعل شيئاً، يخطب ويزبد ويُهدد ويمنع ولا يفعل شيئاً.
في الميزان القيمي، يضع عبية شجاعة دكتور خالد، بعد ضبطه متلبساً في عيادته، في مواجهة الشجاعة المتعارف عليها، إبلاغ الشيخ الشرطة عن نشاط زوجته وتسليمها للعدالة وتطليقها. شجاعة ربما اضطر لها الطبيب بعدما أدرك أنه لن يفلت من العقوبة، ولكنه على أي حال يقذف بالأسئلة في وجه وكيل النيابة: أي فرصة لتلك الفتيات لو لم تُجرَ لهن عملية الإجهاض؟ في الوقت نفسه الذي يعود فيه شاكر، ابن الحارة، ليتزوج من الفتاة التي سبق له أن تخلى عنها عندما حملت منه، واضطرت لإجهاض نفسها تجنباً للفضيحة، وحيدة بمساعدة صديقتها. عاد شاكر وقبلت الفتاة، بل فرحت وسامحت، أحبته على رغم كل ما فعل. هل كان كل ذلك ممكناً لو لم تُقدم على الإجهاض؟ لو لم تقطع الطريق على الفضيحة؟
بالمثل فعلت المؤلفة سمر طاهر في “أعلى نسبة مشاهدة”، حين وضعت على لسان شيماء وأختها نسمة أسئلة عدة: عن الحب قبل تيك توك، وعن الحاجة قبل الاختراع، وعن لهيب الغيرة قبل فظاعة الشر. ابتكرت المؤلفة مفارقة درامية صغيرة استطالت منها خطوطاً درامية عريضة؛ الأخت التي أعدّت نفسها للشهرة، وحسمت موقفها من تشدّد أسرتها المحافظة، ووثقت في جمالها وطلاقتها وطموحها، واستحقاقها الثروة والحياة الرغدة مكافأة على هذا كله، لم تحصد القبول واللايكات والمشاهدات. بينما الحالمة المثالية، السلبية الخائفة، الحريصة على رضا الوالدين وفقاً لكتاب المحفوظات، والتي لا تشكك في شيء مهما عانت من قسوة الأهل وتجاهل الحبيب المُتخَيَّل، تُصادف نجاحاً عاصفاً وشهرة تتوالد بمعدلات أُسِّية، ومحبة تنهال عليها قبل أن تفاجئها بفداحة التكلفة وتعقُّد المسارات.
بُنيت الأحداث هنا على بديهية تغيب عن الأعمال الدرامية المشغولة بالنتائج والأحكام، وهي أننا لا نتحكم في كل شيء، لا الرغبات ولا المصائر ولا تصرفات الآخرين ودوافعهم. تُعامل المؤلفة شخصياتها من واقع سماتهم ومستوى ذكائهم ومرونتهم وطبقاتهم الاجتماعية، ولكنها تضعهم على رقعة شطرنج ديناميكية. بينما توجّه شخصية كل وعيها نحو هدف معين، تباغتها شخصية أخرى بحركة لم تتوقعها.
لا تتسرّع المؤلفة في إحالة هذه الحركة للتربص والشر وحدهما، بل للأهداف المتعارضة للشخصيتين، ولرغبة كل منهما في الفوز، أو على أقل تقدير، رغبتها في تجنب فخّ ما. على الميزان القيمي في “أعلى نسبة مشاهدة”، لن تشفع لشيماء براءتها وحدها، ولا رغبتها الصادقة في مساعدة أهلها في تكاليف المعيشة، تلك المبررات التي تسوقها دائماً للدفاع عن نفسها. ستضطرها الأحداث المتلاحقة داخل دور الشطرنج للتخلص من تلك المبررات، من الحاجة الى التبرير أصلاً، عندما تصرخ في وجه أهلها: “أنا صايعة وضايعة وبتاعة رجالة… محدش بقى ليه دخل في حاجة تاني”. شيماء هنا شخصية أخرى، تمسك زمام المبادرة للحظات، وتتخلى عن البكاء والمَسكنة، لتقطع الطريق على الابتزاز الجماعي بالفضيحة، بعدما شاركت في فيديو كليب مثّل ذروة الكارثة بالنسبة الى أهلها.
هذه المفردات كثيرة التداول مثل الصياعة، الضياع، الأحكام القيمية حول العلاقة بين الجنسين، كلها محل تساؤل في “أعلى نسبة مشاهدة”. من وماذا يُعرّفها؟ وكيف تختلف الأحكام والتصرفات باختلاف موقع من يفسّرها. كيف يصبح ما فعلته شيماء- وما فُعل بها- في سياق طبيعي بالنسبة إليها، شديد الفجاجة حين يتحوّل الى كليشيه إعلامي في برنامج تلفزيوني.
التساؤلات نفسها يمكن أن تشغلنا حين نلاحظ طريقة التسويق للمسلسل على بعض صفحات “فيسبوك” تحت عناوين مثل “خطر السوشيال ميديا اللي خربت البيوت“، “نهاية طبيعية لمدمني السوشيال ميديا“، “نجمة تيك توك باعت نفسها عشان تحقق حلمها“. كما تساهم الموسيقى والأغاني- العنصر الأضعف في المسلسل في رأيي- في تثبيت زاوية النظر تلك على عمل أوسع منها كثيراً، وهي زاوية أخلاقية تكرّست بصورة أكبر في الحلقة الأخيرة المرتبكة للمسلسل، غالباً بفعل ضغوط رقابية!
في العملين الدراميين، وبجهود كل من شارك في صناعتهما، توجّه أصيل لخلق الدراما من سؤال لا من إجابة. وهو فعل حرية للمبدع/ة، يتعلم عن طريقه ويعلّمنا كيف يزيح عن ناظريه وعقله ردود أفعال متوقعة، وخطوط حمراء معتادة، حتى يمد يده بشجاعة ليخلق شخصيات ملونة، ويحرِّكها بنظام فيزيائي طبيعي، متواضعاً لإملاءات معقّدة، نفسية واجتماعية وسياسية ودينية واقتصادية، ولفعل كل تلك العوامل المتشابكة، لا لخطابات فوقية سلطوية، تستعمل الشخصيات الدرامية لإسقاط رؤية جامدة في عقل مؤلفها، وموعظة كامنة في عقل سلطة ما.