مِن أين جاء كل هذا العنف؟ من أين جاءت فكرة تكفير الحاكم والدعوة إلى قتله، وتكفير من يرتضون به حاكماً والدعوة إلى قتلهم، وتكفير من ينادي بالديموقراطية، ثم العمليات الانتحارية، والحروب الأهلية والطائفية، والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والإرهاب العالمي، ثم داعش، وأخيراً هذا الإرهاب ذو الطابع الإسلامي الذي يضرب أوروبا منذ عدة سنوات… من أين جاء كل هذا؟ (راجع السلسلة).
ليست الجمهورية الفرنسية وحدها من تتعرّض للاعتداءات العنيفة بدافع الكراهية، فجريمة النمسا التي حدثت مؤخراً تدلّ على أن هذه الكراهية (ذات المُنطَلقات الإسلامية) موجَّهة لأوروبا، لقيم الديموقراطية والعلمانية الأوروبية، وتحديداً موجَّهة ضد دول تُؤثر قراراتها على مستقبل الاتحاد الأوروبي والعالم كله.
إن الإقرار بوجود مشكلة وتحديدها، هو العتَبَة الأساسيّة الأولى للولوج إلى كلّ استراتيجيات حلّها.
لهذا، يبدو أن الحاجة تزداد إلحاحاً اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، للحديث عن العلمانية، واللائكية الفرنسية تحديداً، نظراً لخصوصيّتها، وصراحتها، وعمق تجربتها؛ أعتقد أن وسائل الإعلام والصحافة (الحرّة) مُطالَبة أن تُعيد التأكيد والتذكير بمُخرَجات عصري النهضة والتنوير الأوروبي، طالما أن أشكال الحكم القديمة (العسكرية والدينية) لا تحاول في هذا الوقت فرض نفسها على السياسة العالمية فقط، إنما على العقل والواقع بحد ذاته، لا بل إنها تحاول العودة بالزمن ربما إلى مرحلة الإنفلونزا الإسبانية والحرب العالمية الأولى! عوضاً عن الاكتفاء بالانفلونزا الصينية (كوفيد ١٩) والحرب الباردة الجديدة (١,٥).
لهذا السبب ارتأى الكاتب أن يكرّس هذه المجموعة من المقالات في موقع “درج” للحديث عن المشكلة التي يَخلقها الاستخدام السياسي للدين (بوصفها عويصة ومستعصية)، وأن يشير إلى موضع الخلل في “النظام”، وينتصر بعقليّة الصحفي والباحث عن الحقيقة للأفكار التي تؤكّد التجربة التاريخية أنه يمكن البناء عليها لأجل حياة عادلة وكريمة، وذلك من واقع دراسته المعمَّقة للشريعة الإسلامية، وثقتهِ باللائكية.
إن المستفيد رقم ١ من هذه البلبلة التي يُثيرها الإسلام في العالم هو الرئيس التركي، ومِن ورائه المموّل القطري، ومن ورائهما كل من يستخدم الدين للغرض السياسي كالسعودية وإيران وغيرهما؛ إذ يلعب أردوغان دوراً كان قد لعبه قبله حافظ الأسد، ومن بعده ابنهُ ووريثه الأحمق.
ظلّ الأسد الأب يُريد احتكار تمثيل القضية الفلسطينية لنفسه داخل العالم العربي لأجل البقاء في الحكم، لذلك كان يسعى جاهداً للإساءة إلى كل مَن يمثّل الفلسطينيين، الهجمات الإرهابية على مطاري فيينا ومدريد في ديسمبر ١٩٨٥ شاهدان على ذلك، إضافة إلى حادثة “لوكربي” (Pan Am Flight 103) التي ترتبط به ارتباطاً مباشراً، وهو الذي حكَم سوريا ٣٠ عاماً باسم “المقاومة”، و “القضية الفلسطينية”، ومكافحة التطرّف الإسلامي، وادعى أيضاً بأن نظام حكمه علماني أيضاً حين قال “الدين لله والوطن للجميع”! وصدّقه معارضوه الإسلاميون في أنه علماني!.. المهم: لقد صنعَ حافظ الأسد أعداءه بنفسه وحافظَ على السلطة له ولأسرته.
بشار كذلك، استفاد من الإسلام المتطرف إلى أقصى الحدود، إبان الغزو الأمريكي أرسلَ بالآلاف من الجهاديين إلى العراق، وكان يسعى جاهداً لزعزعة استقرار البلد الجار، قام الجهاديون الذين انبثقوا عن الدعم المخابراتي السوري باستهداف المسلمين الشيعة وتكفيرهم، فاندفعوا نحو إيران يطلبون المساعدة، فسيطرت إيران على العراق كله، فأسعدَ ذلك بشار الأسد كثيراً.
وحين عاد الجهاديون إلى سوريا من العراق، ألقت المخابرات السورية القبض عليهم، وظلوا حتى العام ٢٠١١ حيث أفرجت السلطات عنهم (لأنهم أبرياء؟)، تغلغلوا داخل الانتفاضة السورية، فتدخّلت تركيا وقطر لدعمهم والاستفادة منهم، فتحوّلت الانتفاضة الشعبية إلى حرب أهلية.
ووسط المشهد، هدَّد المفتي العام في نظام بشار الأسد الشيخ “أحمد حسون” بإرسال الجهاديين إلى أوروبا إذا تعرّض النظام الديكتاتوري السوري للخطر، فانبثقت داعش، ولم تنبثق من فراغ، أفسدت حلم السوريين في بناء دولة، ثم هاجَمَت أوروبا، فانكفأ الاتحاد الأوروبي على نفسه مُنشغلاً بالإرهاب والهجرة وتبِعاتها، وتُرك الأسد وشأنه إلى جانب بوتين والمرشد الإيراني.
وفي حين يتلقى الديكتاتوريون العرب عادةً الدعم من السعودية والإمارات للحيلولة دون الديموقراطية ووصول الإسلام السياسي إلى السلطة، تلعب قطر وتركيا من جانبهما الدور الأخطر في رحلة ابتكار جديدة للقومية الإسلامية، مثلما فعلَ كل حكّام المنطقة منذ وفاة “محمد” وحتى اليوم.
صحيح أن السلطتين القطرية والتركية لا تحتاجان إلى مترجم لفهم الفشل في سوريا، لكن كل ما يحدث يشير إلى أنهما مُصرّتان على تسخير الدين للحصول على السلطة (الأزهر أيضاً يدعم السيسي برعاية السيسي)… لكن، في حين تُجنّد قطر مئات المواقع الإخبارية، ووكالات الأنباء، ومراكز البحث، والقنوات التلفزيونية، وصفحات السوشيال ميديا باللغات الكبرى لدعم أجندة الإسلام السياسي، وأطروحاته، والإساءة إلى القيم الأوروبية، ومحاولة ربط مفهوم العلمانية ببشار الأسد والسيسي، فإن تركيا بموقعها الجغرافي وقائدِها تحاول تسخير مَن بقيَ مِن السوريين على قيد الحياة في حروبها لتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي من الخارج، وتحاول حشد المسلمين المتطرفين وغير المتطرفين لتهديد مصالح الاتحاد الأوروبي من الداخل.
يبدو أن أردوغان يريد حرباً تُعوّضه عن عدم المشاركة في الحرب العالمية الثانية!، ويبدو أن نتائج الحرب الأهلية السورية لم تكن درساً مفيداً لقطر وتركيا، يبدو أن سلطة الدولتين لا تُدركان مدى المخاطرة التي تنطوي عليها ممارسة الدين في السياسة، ولا تُدركان أن محاولة تسخير هذا الأخير يُفضي دائماً إلى حشد الكراهية والعنف، ولا تُريدان الإقرار بأن الأفضلية ستظل دائماً لمن يثق بالآخرين، ويثق كل الثقة بالعقل والتجربة.

السلطة:
إن المشكلة وإن كانت دائماً تبدأ من الفرد، إلا أنه لا يمكن تحليلها إلا من خلال تحليل بنية السلطة التي تُمارس عليه.
إن السلطة هي علاقة قوّة، وهي رديف الهيمنة، والتسلّط، والتحكّم، والترويض، والتطويع، والحراسة، والعقاب.
تتحكم السلطة بكل شيء، بكل مناحي الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والديموغرافية.
والسلطة توجد في اللامكان، وتوجد في كل مكان، لا مركزَ لها، ولا أطراف، تُحكم قبضتَها على كل شيء، إنها -حسب ميشيل فوكو- نتاجُ مؤسساتٍ عديدة، كالأسرة، والشارع، ومكان العمل، والعيادة، والسجن؛ وهي ليست محصورة بالأجهزة الأيديولوجية ولا القمعية وحدها.
أياً يكن تعريفها، لا يمكن للسلطة أن تقوم دون (نسَق مَعرفي)؛ إنّ المعرفة هي من تُمهّد الطريق أمام السلطة كي تفرِض هذه الأخيرة عَبرها علاقةَ القوة؛ بواسطة المعرفة تُطوّع السلطةُ الواقع، وتُسخّر الطبيعة -بما فيها الإنسان- لصالحها.
إنّ التربية، والتعليم، والعادات، والتقاليد، والدين، والصحافة، والإعلام، والفنون، والآداب، وأدوات الخطاب على اختلاف أنواعها وأشكالها، والفيزياء، والكيمياء، والتكنولوجيا، والطب، وعلم الذرة.. إلخ، كلها أنساق معرفيّة تحتاجها السلطة لفرض علاقة القوة.
وإن كان سقراط يرى أن المعرفة هي “الخير الأسمى” ويَقصد بذلك معنى مُحدَّداً، إلا أن السلطة في حقيقتها إذ تدّعي “الخير” إنما هي تدّعيه بادّعاء “المعرفة”.
إن عالَم الأحياء كله يؤكد على الأفضليّة لصالح الأكثر (خبرة وقدرة على التكيّف)، والتي هي بدورها (معرفة).
وهكذا فإن السلطة هي (وصاية معرفيّة) على الواقع والطبيعة والإنسان، وهذه المعرفة ليست محايدة، إنما هي استراتيجية أساسية للبقاء والصراع في هذا العالم.
الدين:
الدين صنيعة ثقافة تأمّلية، وعقل متوحّد، سَئِمَ البحثَ عن إجابات، فأرادَ أن يَجد ما يربط به خيوط العالم جميعها؛ إنه فكرة ثورية في عالم غامض ومبهم.
إن تاريخ الدين هو تاريخ التجربة المبكّرة والوعي الإنساني القديم، وهو ردّ فعل الذهنية الإنسانية بشكلها التلقائي تجاه غرابة هذا العالم وإشكاليّته، وغموض المسعى الإنساني فيه (من أنا؟ مِن أين أتيت؟ إلى أين سأذهب؟ وكيف أعيش؟)
يرى الباحث السوري فراس السوّاح أن الإنسان كائن متديّن، وأنه لا يختار أن يُحس دينياً، وأنّ هذا الإحساس مَفروض عليه من داخله، وأنه لا يوجد إنسان عبر التاريخ إلا ولديهِ مثل هذا الإحساس.
لعلّ الأدق القول بأن الإنسان كائن (…) مَسكون في جوهره أصلاً بالعاطفة قبل العقل، مسكون بجملة من المشاعر والأحاسيس والدوافع غير العقلانية، وأنه فطريُّ التفاعل العاطفي مع الوجود، وفطريّ التعبير العاطفي عن ذاته.
وهذا باعتبار العاطفة والعقل مفهومين منفصلين ومختلفين، وباعتبار العاطفة أكثر أصالة من العقل، نلاحظ ملامحها الأولى غير المفهومة عند الأطفال، وعند الكائنات الحيّة الأخرى كالفِيَلة ومجتمعات الشمبانزي مثلاً.
إن الإنسان حين أدرك ذاتهُ أدركَ فيها مشاعرَه أولاً، أنه كائن (يشعر)، ويَختلف تفسيره الخاص لشعوره ذاك باختلاف جملة المعارف -بالمعنى الشامل للعقل والتجربة- التي تشكّل هويته.
وقد يصحّ القول بأن قرارات الإنسان يتّخذها شاعريّاً في قلبه، ويُفسّرها ويُبرّرها بعقله، وأن هذا “التبرير” يختلف بناءاً على جملة معارفه وتصوّراته عن العالم وعن نفسه.
إنّ كل ما يَبدر عن الإنسان (وليس الدين فقط) مَردُّه جملة من الأحاسيس غير المفهومة التي لا يمكن إخضاعها بالضرورة لمعايير العقل والمنطق؛ وهكذا فإن القول بأن الإنسان “كائن متديّن” هو اختزال مجحف لمشاعرهِ الأصيلة القديمة قِدَم العالم والطبيعة، وهو محاولة لتوسعة مفردة “التديّن” وَمَطّها لتشمل كلَّ الفراغ والبحث الإنساني المُضني عن معنىً ومبرِّر لكل ما يحدث له… إنّ شعور الإنسان بالاغتراب لا يعني أنه كائن متديّن.
لقد أحسَّ الإنسان -حين أحسّ- بثقل العالم والطبيعة، وأدركَ – بوعيهِ لذاته- مدى ضعفهِ وتورّطه في أن يكون موجوداً، وحاولَ منذ قديم الزمان ويحاول كل يوم أن يتملّص من ذلك، أن يَنفلت من إدراكه للعالم، ومن إدراكه لنفسه، ومن سَطوة المنطق والطبيعة وظواهِرِها عليه؛ كان يقف أمام قوّتها وجبروتها خائفاً مَشدوهاً لأنه يُدرك ضعفه، ولأنه في الوقت ذاته يَجهل ماهيّتها وماهيّة الموت؛ إنه عاطفيّ، إنه غير عقلاني، تَغلُب على طابعه مشاعرُ الاستياء، إنه متورّط في عالم مجهول، لذا فهو خائف، يبحث عن الراحة والسَّكينة والطمأنينة والعزاء؛ يقول فوكو: “إن الإنسان بصعوده نحو الله لا يرغب بتجاوز نفسه، إنما بالانفلات من ضعفه الأصلي”.
اعتقدَ الإنسان في بداية وعيه لذاته أنه يستطيع أن يهرب من نفسه وعقله ومِن السؤال إذ يَقبل ويُقْبل على (العودة) للعيش كسابق عهده مثل الكائنات الأخرى التي يعيش وإياها في هذا العالم، اعتقدَ أنّ بإمكانه أن يُنكر شعورَه وإدراكَه لذاته، وأن يُعبّر بنكوصهِ ذاك إلى مرحلة سابقة من تاريخه عن السعار الدامس الكامن في قلبه وضميره، وهو يعتقد أنّ بإمكانه أن يعيش حُلم الهروب والعودة من حيث جاء إلى رحم أمه (والطبيعة الأم) بعيداً عن عقله، وحقائق العالم غير الرحيمة.
إن الصِّدام الحاصل بين مشاعر الإنسان، وعقله، والتجربة التراجيدية، هو ما يُحرّك فيه هاجسَ الدين والله والعدميّة والجنون.
إنّ التديّن ليس سؤالاً ولا إجابة (باعتبارهما مسألة عقلانية بحتة)، ولا هو مجرّد تعبير عن الحاجة الملحّة للحصول على مُبررات، إنما هو حالة من الرضوخ العاطفي لتلك القوة التي (يَفترضُ الإنسان) أن تكون مُنبثّة من عالم آخر في عالمنا المادّي المحسوس.
وتتمظهر حالة الرضوخ العاطفية المعيّنة تلك في الاعتقاد والسلوك الذي نطلق عليه اسم (الدين) حين لا يجدُ المرءُ في واقع الطبيعة والتجربة والمعرفة ما يُفسر به العالم حوله، بمعنى أن التديّن (كحالة رضوخ عاطفي) والدين (كمعتقد وسلوك قائم على علاقة الرضوخ تلك) مرتبطان وجودياً بما هو مجهول.
وبمعنى آخر فإن المرء يرضخ عاطفياً (يتديّن)، ويمتثل لرضوخه ذاك (أي يمارس الدين اعتقاداً وسلوكاً) حين لا تُسعفهُ المعرفة، وحين لا يستطيع أن يُحيط عقلانياً بالعالم، وحين لا يستطيع إيجاد صيغة مفهومة يُبرّر فيها ما يمكن أن يَعتبره (قسوة أن يكون موجوداً)، وقسوة ما يَحدث له في عالم قد تورّطَ بالوجود فيه دون اختيار منه، أي أنّه يَرضخ عاطفيّاً حين يكون جاهلاً، ويزداد عاطفة وحساسية بقدر ما يَزداد جهلاً وانغلاقاً على نفسه.
والعكس صحيح، كلما تفتّحت واتّسعت مدارك الإنسان، كلما قلّ اعتباره لمشاعره، وقل اعتمادهُ عليها في الاستدلال على الحقيقة، وكلما ازدادت قوّته أيضاً، وقوةُ وضعه وموضعه.
يتديّن المرء ويمارس القناعة الدينية حين يُحاط بما هو غير قابل للتفسير بالعقل، حين يَعجز عن تفسير العالم حوله، حين لا يريد أن يفسّر العالم، حين يبدأ فيُريد أن يُنكر ذاته بأن يَجحدَ بحقيقةِ أنّ له عقلاً، وأنه مَحكوم بمنطق الطبيعة وظواهرها؛ يتديّن حين لا يريد أن يعترف بالحقيقة (والحقيقة هي كل ما هو موجود)، يتديّن حين يصير مشحوناً بالنزعة التدميرية للإنسان داخله والطبيعة؛ أقصد بالتدميرية أي حين يريد أن يُعبّر عن نكوصه إلى مرحلة ما قبل العقل، وما قبل الوعي للذات، وينغلق على مشاعر الاغتراب لديه.
لكن، حين يصير (المجهول) مَعروفاً ومُعَرَّفاً بالمعرفة العقلانيّة على صرامتها وقسوتها، يتراجع تعويلُ الإنسانِ على ارتباطهِ العاطفيّ بالوجود، وتتلاشى مع معرفتهِ العقلانيةِ للعالم حاجتهُ النفسيةُ والسلوكيةُ للتديّنِ والدين.
وهكذا باختصار فإن التديّن هو حالة تورّط عاطفي ناتجة عن (سوء تفاهم) بين الإنسان وعالمه، والدين هو امتثال لهذا التورّط، ومحاولة غير عقلانية للهروب.
وبهذا المعنى (قد) يصحّ إطلاق وصف (التديّن) على كل محاولات هروب الإنسان (غير العقلانية) من خوفه وورطة وجوده؛ ألا يمكن القول بأن ثقافة الاستهلاك العالمية أيضاً كمحاولة لإشباع رغبة مُبهمة هي شكل من أشكال الدين بوصفها نوعاً من أنواع الهروب؟ (هروب إلى الأمام/الهوَس بفكرة التقدّم/ وما ينتج عنها من تدمير للطبيعة والإنسان) … ولهذا فإنني لا أزال أبحث عن مفردة أُخرى تحل محل كلمة “متديّن” في قوله (الإنسان كائن متديّن)، كلمة من شأنها أن تربط بين الدافع للهرب نحو الدين، وبين الدافع لمحاولات الهروب الأخرى كالاستهلاك (بوصفهِ دين المجتمعات المعاصرة)، هل يصح القول بأنه كائن “مغترب”؟ وأن اغترابه قد يتمظهر في الدين، وقد يتمظهر في الإدمان، وفي هوس الاستهلاك، وفي كل أشكال الهرب التي تعبّر عن رغبته في أن يتم تخديره، وتعليبهُ، وقولَبَتُه، وتدجينه كالحيوانات الأخرى؟
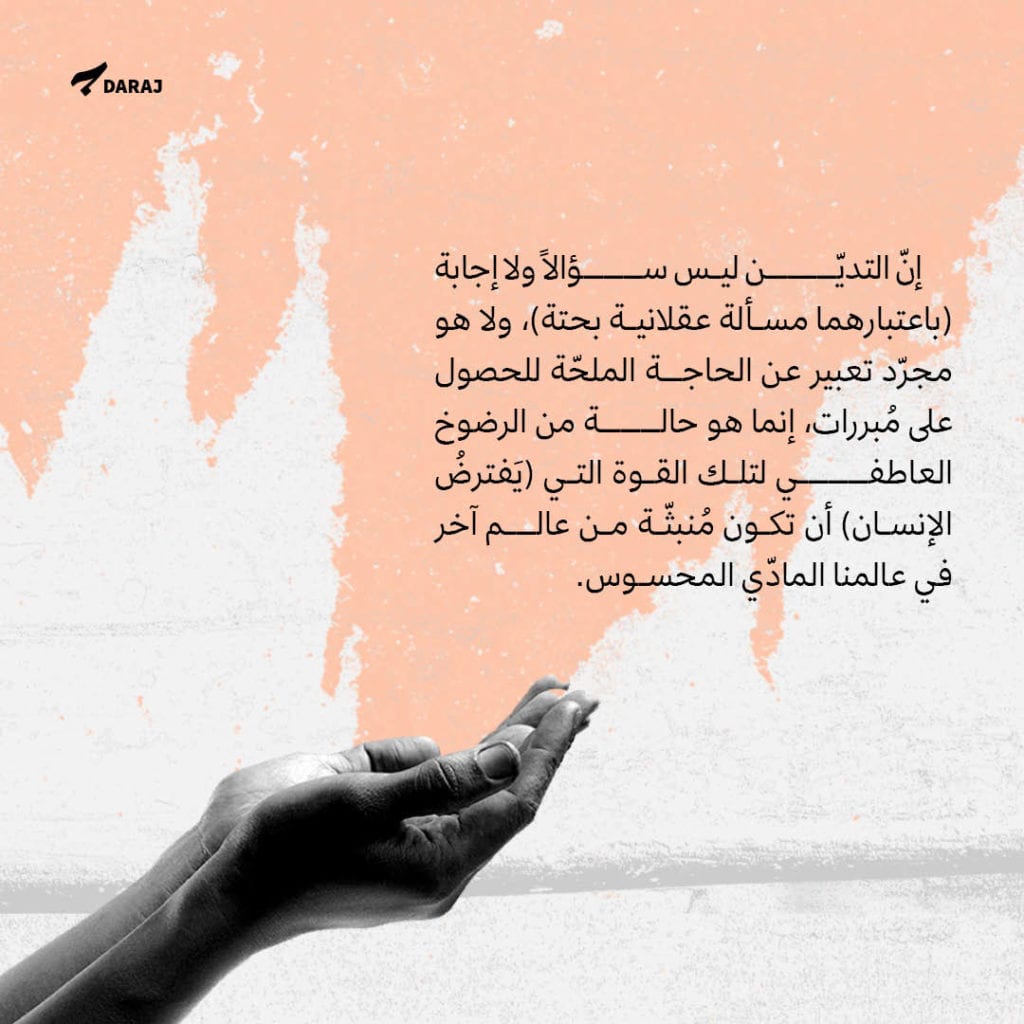
الدين والسُّلطة:
خلافاً لكل الأنساق الأخرى، يتّخذ (الدين) نمطاً معرفيّاً خاصّاً يُميّزه عن البقيّة في القِدَم والأسبقية، وفي شكل الخطاب ومضمونه، والأهم: في علاقته وارتباطه الوثيق منذ قديم الزمان بالسلطة.
يُخبرنا الباحث السوري فراس السوّاح أنه لم يكن لدى القبائل البدائية في العصر الحجري آلهة، وأن الإنسان القديم كان يشعر بأن العالم مقسوم إلى قسمين، عالَم منظور، وآخر غير منظور، وأنه من هذا الأخير كانت تنبثّ في العالم المنظور قوّة، غير مادّية، تتجلّى في ظواهر مادّية، وتقف وراء كل حركة؛ وأنه كان يُستعاض عن تلك القوة برمز تجريدي، أو (شَارة الألوهة)، كالفأس الحجري في مصر، والفأس المزدوج في بلاد الشام، وقرني الثور نواحي الأناضول حين لم يكن حيوان الثور وقتها من الحيوانات المدجّنة الخاضعة لسلطة الإنسان عليها، وكان يُعتبر آنذاك أقوى حيوانات البرّية، لذلك كان يرمز بقرنيه إلى الألوهة أو منتهى القوّة.
كذلك يخبرنا السواح أن إنسان العصر الحجري كان أكثر قدرة على التجريد حين لم يكن في ذلك الوقت يشعر بالسلطة تُمارس عليه من أي جهة، وأنّ كبرى التجمعات البشرية التي لا يتخطى تعدادها الـ ٢٠٠ شخص كانوا مُتفقين بشكل تلقائي على الأفضليّة في القيادة لشخص ما، كـ (الشامان أو شيخ القبيلة)، وأنه كان من الممكن تغييره في أي وقت، وأن تلك التجمّعات البشرية كانت عملياً دون سلطة، وبلا طبقات اجتماعيّة؛ وأنّه في مجتمعٍ الكلُّ فيه متساوون من حيث الثروة والمركز الاجتماعي، وفي حال انعدام السلطة كانت تنعدم بالمقابل الحاجة التاريخية إلى ظهور الآلهة.
ويشير السوّاح كذلك إلى أنه حين انتقل الإنسان إلى العصر الزراعي، ومع بداية تشكّل القرى الزراعية وتطوّرها إلى أشباه مدن، أحدثَ ذلك تغييرات جذريّة في بنية المعرفة، في وسائل الإنتاج، والمُلكّية، وعلاقات القوّة، وفي مفهومي الدين، والسلطة؛ وأنه حين صارت المنشأة البشرية في العصر الزراعي محكومة بسلطة مركزية، خَلقَ ذلك لدى الإنسان إحساساً بأن الكون كله محكوم بسلطة مركزيّة مشابهة، وأنّ الحاجة إلى الآلهة عبر التاريخ كانت تبدأ بالظهور حين يَتولّد في المجتمع مفهوم جديد للسلطة.
وكنتيجة لذلك انتقلَ الإنسان من الترميز التجريدي للسلطة الإلهية بـ (شارة الألوهة)، إلى شخصنة وتجسيد تلك الألوهة/السلطة، كـ (الإله زيوس/الآلهة عشتار)؛ وهذا التجسيد هو نتيجة للتغيير الذي طرأ على علاقة القوة التي أفرزتها السلطة عبر نسقها المعرفي الزراعي آنذاك.
وحين دخلت المنشأة البشرية طور المملكة الكبيرة والإمبراطورية، ظهرت معها أشكال سلطة أُلوهيّة جديدة أكبر وأكثر قدرة وشمولاً يُجسّدها (كبير الآلهة) الذي تحوز سلطته سلطة الآلهة الأخرى جميعاً، كالإله “مردوخ” مثلاً في الحضارة البابلية الذي كان يُنادى بأسمائه الخمسين.
ثم بعد ذلك ظهرت فكرة (التوحيد/الإله الواحد) مع “زردشت”، وظهرت مع التوحيد مفاهيم الهرطقة والزندقة والكفر والخروج على “الملّة”.

هكذا غيّرَ عصرُ الزراعة بشكل جذريّ النسقَ المعرفيّ الإنساني، من آليات الإنتاج، والمُلكيّة، وعلاقات القوة، وشكل الحُكم والسلطة التي غيّرت بدورها تَصوُّرات المحكومين عن العالم وعن أنفسهم، وغيرت شكل الدين، الذي تطوّرت دعوته وأدواته بتطوّر أشكال السلطة، وتحت إشرافها ورعايتها.
لاحقاً، صار الدينُ النسقَ المعرفيّ الإنساني الأكثر قرباً من السلطة والتصاقاً بها نظراً لقربه من الجماهير بالدرجة الأولى، وذاك لقُدرة قصصهِ و “معارفهِ” وسرديّاته العجيبة عن عوالم المتعة والعقاب في التأثير على فهم تلك الجماهير لنفسها والعالم، والإحاطة بمدارِكِها، ومخاوفها، وآمالها، وتطلّعاتها، وحتى معنى حياتها ووجودها.
إلى يومنا هذا، لا يزال الدين في الكثير من دول العالم رفيق درب الحكومات، وأداتها الناجعة في ممارسة السلطة؛ ولولا أنّ مفرزات عصري النهضة والتنوير، والثورة الفرنسية والصناعيّة قد وَضعت لاستغلاله السياسي وتطلّعاتِه السلطويّة في نهاية المطاف حَدّاً، لظلّ كالمرض يشلّ حركة الدولة والمجتمع والتاريخ، ولكنّا نعيش الآن في عالم يشهد صراعاً دينياً، عالم أكثر خراباً وبؤساً وشقاءاً بالتأكيد مما هو عليه اليوم.
لكن، ماهي المشكلة التي يفرضها الدين؟ ولماذا يكمن الحل النهائي لهذه المشكلة في اللائكية الفرنسية تحديداً؟
إقرأوا أيضاً:








