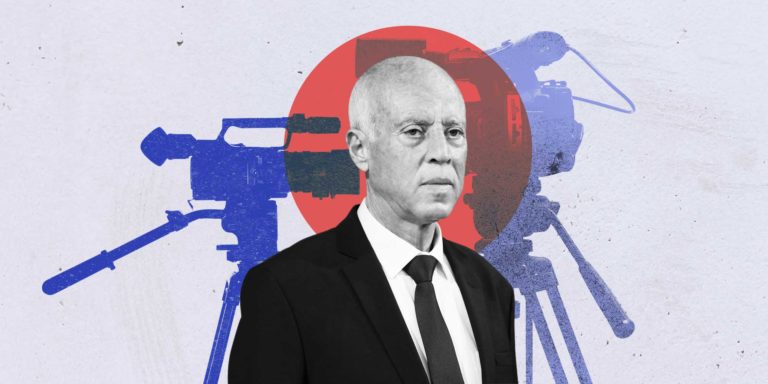تتسارع التطورات في ليبيا في منحى يتجه أكثر إلى الصدام منه إلى حلحلة الأزمة قبل أشهر قليلة من الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، حيث دخل المسار السياسي منعطفاً جديداً مع سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وهي السلطة التنفيذية التي على عَاتقها تهيئة الظروف للاستحقاق الانتخابي أواخر العام الحالي كنهاية للمرحلة الانتقالية.
الخلافات والانقسامات بين مُعسكري شرق وغرب ليبيا بددت آمال إنهاء عقد من الفوضى وبناء دولة ديموقراطية مدنية، قبل الاستحقاق الانتخابي وهو مرحلة مفصلية في مسار انتقالي بدا ملغوماً منذ الوهلة الأولى لولادة سلطة تنفيذية جديدة بدفع أممي ودولي قفز على الكثير من العُقد الكامنة تاريخياً والمتأصلة جغرافياً في المشهد والجسد الليبي.

الهالة الإعلامية التي رافقت إعلان ملتقى الحوار الليبي عن انتخاب رجل الأعمال عبدالحميد الدبيبة رئيساً لحكومة وحدة وطنية مؤقتة والدبلوماسي السابق محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، برزت معها وفي لحظتها رغبة دولية جامحة لانجاز سياسي، تجاهلت معه كل التناقضات القائمة وإرث من الصراع التاريخي بين شرق وغرب ليبيا بما جعل البناء هشاً والأسس مربكة وحظوظ نجاح العملية السياسية ضعيفاً، فلم تكن نتيجة الانسداد صدفة في سياقاتها، لكنها كانت مفاجئة في توقيتاتها.
فالانجاز السياسي المرغوب دولياً افتقد لأسس البناء والتأسيس: أولاً من حيث الهدف كان واضحاً أن هناك استعجالاً في دفع الفرقاء الليبيين بكل تناقضات المشهد إلى توافقات مستحيلة.
ثانياً: من حيث السقف الزمني للانجاز كان المطلوب تسوية ضامنة لانتقال ديموقراطي في عشرة أشهر فقط لإنهاء عشر سنوات من الفوضى والاقتتال وهو أمر لا يستقيم حتى بمنطق حسابي بسيط، فعشرة أشهر لا تكفي لترميم أبسط التصدعات والانقسامات التي مسّت المجتمع الليبي بمكونه القبلي والمناطقي.
وباعتبار أن التَوزع الجغرافي للصراع المتناثر من غرب البلاد إلى شرقها ومن شمالها إلى جنوبها والمحكوم بالعصبية المناطقية والقبلية، تُصبح المعالجة كالسير في حقل ألغام.
بالمُحصلة، الاقتتال بين السلطتين المتنافستين في غرب وشرق ليبيا خلّف جروحاً غائرة يصعب أن تندمل في عشرة أشهر خاصة مع الحضور القوي للعقلية القبيلية والمناطقية في المجتمع الليبي.
الدفع الدولي لانجاز سياسي وفق خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وَضع على عاتق السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة في حكومة الدبيبة ومجلس المنفي، توحيد مؤسسات الدولة ولجم سلاح الميليشيات والمصالحة الوطنية وتهيئة المناخ لأول انتخابات عامة (تشريعية ورئاسية) بسقف زمني مربك: عشرة أشهر فقط لتسوية تراكمات عشر سنوات من الفوضى والاقتتال والتدخلات الخارجية!
ثالثاً: الصراع في ليبيا استقطب قوى أجنبية من بينها تركيا وروسيا والإمارات ومصر وآلاف من المرتزقة الأجانب وهي معضلة أخرى تُثقل على جهود حلحلة الأزمة ووضع فرقاء ليبيا على سكة المصالحة وإعادة البلاد بكل مُكونها السياسي ونسيجها المجتمعي إلى سيادة مفهوم الدولة.
رابعاً: حضور دول الجوار الليبي في عملية الدفع إلى تسوية سياسية سلمية كان أقل مما يفترض أن يكون بل إنه لم يخل من الاصطفافات لهذا الشق أو ذاك حتى وإن لم يكن معلنا بشكل صريح، مع أنها المعنية أكثر بتوفير حزام دعم إقليمي للعملية السياسية على قاعدة أن أمن واستقرار ليبيا من أمنها واستقرارها.
حين يَغيب مفهوم الدولة ويسود منطق الغنيمة
المشهد السياسي في معظمه والذي تشكل في 2011 ما بعد العقيد القذافي (الزعيم الليبي الراحل) وما بعد مفهوم الزعامة المطلقة لدولة تدور كُليّاً في فلك الزعيم، لم يكن نتاج لحظة فارقة في تاريخها أو فعلاً سياسياً متناغما مع الذات والهوية الوطنية أو تأسيساً لدولة مدنية ديموقراطية قائمة على التداول السلمي للسلطة.
المشهد ما بعد “الزعيم” كانت فيه عقلية الغنيمة هي الغالبة وكان المنطق السائد بكل تلوناته السياسوية والميليشاوية هو السلاح وهو المنطق الذي ألغى مفاهيم الدولة والسيادة والقانون رغم أن المعلن لكل تشكيل سياسوي أو ميليشاوي كان استحضاراً لكل تلك المفاهيم كهدف وغاية وان اختلفت أساليب إدارة الصراع.
فَهْم مآلات الوضع بعد عشر سنوات من الفوضى أو تشخيص المشهد السياسي الراهن لا يمكن أن يكون بمعزل عمّا تأسس عليه المشهد لمرحلة ما بعد القذافي، فالمقاربة السياسية القائمة لم تغادر متاهة المحاصصة والنزاع على الغنيمة.
في الشرق حيث كانت الجماعات الإسلامية المتشددة بمختلف تسمياتها (أنصار الشريعة، مجلس شورى ثوار بنغازي، مجلس مجاهدي درنة، “داعش” وفروعه والقاعدة وفروعها…)، تنشر الرعب في كل مكان لإرساء نظام إسلامي مبني على تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، برز العسكري السابق المشير خليفة حفتر بعد أن نجح في تشكيل قوة عسكرية ضخمة تعاظمت قوتها بدعم من عدة دول تناهض جماعات الإسلامي السياسي وأجنحتها العسكرية.
طموح حفتر يذهب إلى أبعد من مجرد عملية عسكرية وطنية لتطهير ليبيا من الإرهاب، إذ أنه يبحث بشكل محموم عن تتويج مسيرته بقيادة ليبيا وقد هيأ نفسه لذلك.
قوة حفتر العسكرية تحولت إلى جيش شبه نظامي منظم بقيادات عسكرية ورتب مختلفة وترسانة أسلحة متطورة، خاض بها حربه المعلنة على الإرهاب، راسما لنفسه صورة القائد الذي قهر الجماعات الدينية المتطرفة.
ومن ثمة أصبح رقماً صعباً في أي معادلة سياسية في ليبيا، لكن بدا أن طموح رجل الشرق القوي أكبر من أن يتوقف عند تلك الحدود الجغرافية، فحاول التمدد إلى غرب البلاد حيث تتمركز سلطة سياسية تنفيذية مؤقتة مدعومة أممياً ومسنودة أيضاً من ميليشيات تُقلّب ولاءها حسب مصالحها وبعضها أجنحة مسلحة لأحزاب سياسية.
تحرك حفتر العسكري كان محكوماً أيضاً بمنطق الغنيمة، شأنه في ذلك شأن القوى السياسية في غرب البلاد. تراجع هجومه على طرابلس في 2019 بفعل تدخل عسكري تركي، لينخرط بعدها من حيث المبدأ في العملية السياسية التي انبثقت عن ملتقى الحوار الليبي برعاية أممية وهو الملتقى الذي أسس لولادة السلطة التنفيذية الحالية بقيادة كل من الدبيبة والمنفي.
طموح حفتر يذهب إلى أبعد من مجرد عملية عسكرية وطنية لتطهير ليبيا من الإرهاب، فالضابط السابق في جيش القذافي وأحد المشاركين في الانقلاب على الملك محمد إدريس السنوسي في مطلع سبتمبر 1969، يبحث بشكل محموم عن تتويج مسيرته بقيادة ليبيا وقد هيأ نفسه لذلك.
قبول حفتر وبرلمان طبرق بسلطة تنفيذية جديدة (حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي برئاسة المنفي) لم يكن صكا على بياض بل اقترن بطموح الرجل لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعلى ضوء ما سبق بدا واضحاً أن كل المسار السياسي من البدايات إلى ما هو راهن الآن تأسس على منطق الغنيمة والمحاصصات السياسية، فغاب مفهوم الدولة أو غُيّب “لمآرب في نفس يعقوب”.
سَحْب برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) برئاسة المستشار عقيلة صالح وهو من الموالين لحفتر، الثقة من حكومة الدبيبة، كان متوقعا في خضم الحسابات السياسية لمعسكر شرق ليبيا، فجاء قرار حجب الثقة بعد فترة وجيزة من بروز خلافات بين المجلس الأعلى للدولة بقيادة خالد المشري المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ومجلس النواب الليبي.
ويبدو في المقابل أيضاً أن منطق الغنيمة كان حاضراً بقوة لدى جماعة الإخوان المسلمين التي كان لها نفوذ واسع في حكومة الوفاق الليبية السابقة فدفعت بقوة نحو تلغيم المسار الانتخابي باقتراحات مُنَاقضة للرغبة الدولية والمحلية لتأمين الانتقال الديموقراطي والتأسيس لدولة مدنية.
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا كان قد وجه انتقادات عنيفة لقانون انتخاب الرئيس الذي أقره عقيلة صالح مؤخراً، معتبراً أنه قانون على المقاس لخدمة شخصية بعينها في إشارة إلى خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.
وفي أحدث حلقة من حلقات التوتير، اقترح خالد المشري الفصل من حيث التوقيت بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية على خلاف ما نصت عليه خارطة الطريق السياسية التي أقرها ملتقى الحوار الليبي بدعم من المجتمع الدولي.
وبالمنطق السياسي قد يبدو الاقتراح قابلا للنقاش لو كان الوقت يسمح بمثل هذه المبادرات، ولو كان سياق المبادرة الدفع نحو تعزيز المسار الانتقالي، لكن سياقاته تميل أكثر إلى إعادة خلط الأوراق في مشهد يُكابد للخروج من مربع الاضطراب.
ويَعتبر المشري أن إجراء الانتخابات في الظرف الحالي “لن يولد استقرارا”، وأن “الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها وأن الغاية هي إحداث استقرار في البلد”.
عقدة قانون الانتخابات
النزاع بين البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة كشف عن هوة عميقة بين سلطتين متنافستين ومتناقضتين ايديولوجيا، فسلطة البرلمان تشريعية وسلطة مجلس الدولة وهو من ارث حكومة الوفاق السابقة، استشارية.
بالمنطق السياسي وبموجب مبدأ التوافقات، يفترض أن يكون هناك تكامل بين السلطتين لدفع العملية السياسية، لكن على اعتبار الثغرات التي رافقت عملية الدفع السياسي المستعجل وصل الطرفان إلى طريق مسدود.
الخلاف حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية كان متوقعا، فالرهان كان قائماً على توافق الفرقاء والعمل على تهيئة الأرضية الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات ضمن جدول زمني ضيق لا يتيح نقاشاً مستفيضاً حول النقاط الخلافية للمقترحات من الجانبين.
العقدة في المشهد الليبي الراهن هو أن كل الدفع جرى على قاعدة “العربة قبل الحصان”، فآل الوضع إلى ما هو عليه الآن، إذ كيف يمكن ضمان تهيئة المناخ لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة في ظل غياب أرضية دستورية تنظم المسار الانتخابي ويسار إليها عند الضرورة.
المفارقة أنه في خضم حالة التعطيل والثغرات القانونية والدستورية والشدّ والجذب بين طرفي الأزمة، أنه ثمة إجماع لدى كافة الأطراف في ليبيا وحتى لدى الأطراف الدولية المتدخلة والمنخرطة في الصراع، على حتمية إجراء الانتخابات.
المجلس الرئاسي بقيادة الدبلوماسي السابق محمد المنفي أعلن مؤخرا من نيويورك بمناسبة الاجتماع السنوي للجمعية العام للأمم المتحدة، أنه سيدعو المرشحين لانتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل إلى عدم الترشح “ما لم يتم التوافق بينهم على الإطار القانوني للتصويت”، مضيفا أن عدم وجود رؤية واضحة للاستحقاق الانتخابي أمر يهدد بتقويض العملية السياسية برمتها.
من زاوية جيوسياسية الأمر يبدو مربكا فعلا وممارسة، وهو ما يفسر نتيجة التجاذبات بين المكون السياسي الليبي باختلاف توجهاته والإخفاق في التوصل لاتفاق على أساس دستوري للاقتراع.
لدى شق واسع من السياسيين والمحللين في ليبيا قناعة بأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية إذا تمت في ظل الثغرات القانونية والدستورية، لن تكون نهاية للصراع بل بداية جديدة ربما تكون أكثر دموية فلا ضامن بأن يقبل الخاسرون فيها وبينهم قادة ميليشيات مسلحة بعضها متشددة دينيا، بنتائجها وهو ما يؤسس لعودة قوية لمربع الفوضى الأمنية والسياسية.
إقرأوا أيضاً: