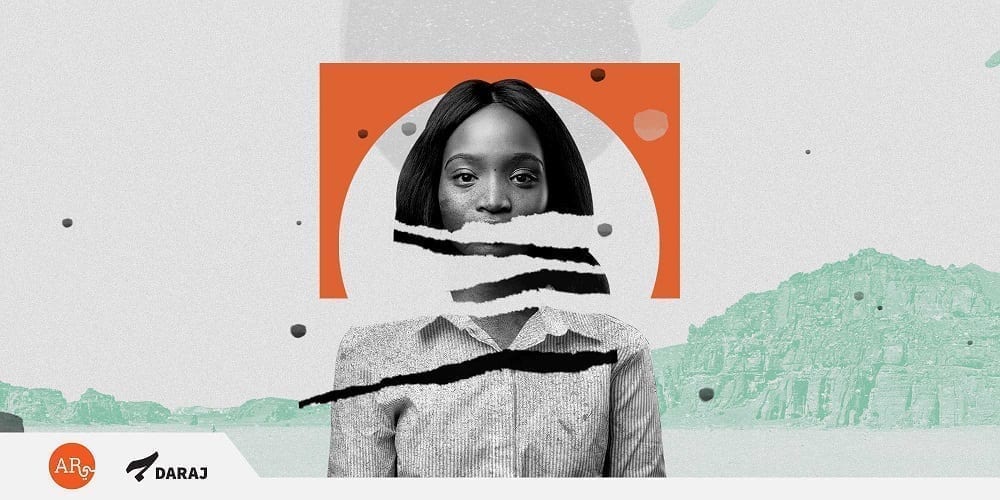ينشر هذا النص بالتعاون مع “مبادرة الإصلاح العربي”
في مرحلة ما بعد الاستقلال، فضلت “النخب” الاستبدادية في الجزائر تعريف الشعب الجزائري بأنه “نسيج متجانس ذو ثقافة واحدة (عربية-إسلامية)، ودين واحد (الإسلام)، ولغة واحدة (اللغة العربية)”، لأن التنوع بالنسبة إليهم يمثّل مصدراً للانقسام وتهديداً لاستقرار البلاد ولسيطرتهم على مقاليد السلطة. بيد أن قضايا الهوية، التي يصرّ النظام على الهيمنة عليها، تستخدم أيضاً لبث الفُرقة وإدارة البلاد على قاعدة “فرّق تسد”. ومع إدراكه لذلك، قلل الحراك الجزائري منذ البداية من أهمية الهوية والاختلافات الموجودة داخل الحركة الاحتجاجية وركز على التخلص كلياً من السلطة (المتمثلة في النخبة العسكرية وحلفائها المدنيين الذين يحكمون البلاد ويستغلونها)، واقتلاعها من جذورها.
سعى النظام إلى الانتقام كالمعتاد، ونجح جزئياً في إضعاف قدرة الحراك(نشط عاميّ 2011 و2019) على البقاء جبهة موحدة ضده. فقد قوضت الدولة وحدة الحراك الهشة أصلاً من خلال اللعب على التوترات القائمة بالفعل بين العرب والأمازيغ وبين الإسلاميين والعلمانيين، مع محاولة الإبقاء على هيمنة النظام التامة على مسائل الهوية.
قاومت مجموعات الحراك، هذه المحاولات وطالبت بإجراء نقاش عام مفتوح وإشراك منظمات المجتمع المدني من أجل وضع دستور يشمل الجميع، وإرساء ديمقراطية حقيقية، وبناء مجتمع جزائري متصالح مع تنوعه، بمكوّناته كافة.

تزايدت العنصرية ضد السود في الجزائر بشكلٍ ملحوظ مع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين السود القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى -غالبيتهم بشكل سري- على مدى العقدين الماضيين، وقد أتوا إلى الجزائر بحثاً عن فرص تعليمية واقتصادية أفضل، أو من أجل السفر عبر البلاد إلى أوروبا.
يشكل الأمازيغ الذين يتحدثون اللغة الأمازيغية الأصلية “تمازيغت” حوالي من 20% إلى 25% من الجزائريين، مع وجود نسبة كبيرة من الأمازيغ المُسْتَعْرَبين. منذ الاستقلال، يناضل الأمازيغ الأصليون من أجل تحقيق المساواة ضد دولة تصر على فرض هوية عربية مسلمة على كافة الفئات السكانية في البلاد. فقد أدرج الدستور الجزائري الأول في مرحلة ما بعد الاستقلال، الذي اعتمد بعد استفتاء شعبي عام 1963، الإسلام واللغة العربية بوصفهما العنصرين الوحيدين المكوِّنَين للهُويّة الجزائريّة المعترف بهما دستوريّاً.
وفي الدساتير كافة التي اعتمدت منذ ذلك الحين، لم تنحرف الدولة الجزائرية، رغم الضغوطات الشعبية، قيد أنملة عن صيحة عبد الحميد بن باديس، رائد النهضة الإسلامية في الجزائر(توفي في العام 1940)، لتكريس الهوية العربية والإسلامية للجزائر، التي أطلقها في وجه أنصار الاندماج الثقافي، الذين بعد أكثر من قرن على الاستعمار الاستيطاني ما زالوا ينظرون إلى فرنسا باعتبارها وطن الجزائر الأم.
تصدى الناشطون الأمازيغ لتأكيد الدولة على تجانس الهوية العربية الإسلامية. وأدى النضال الأمازيغي، الذي اشتمل على تنظيم احتجاجات شعبية حاشدة وتقديم مشاريع من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي يهيمن عليها الأمازيغ، إلى إجبار الدولة على تقبل الهوية الأمازيغية دستورياً بوصفها أحد مكونات الهوية الجزائرية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المنهج التعليمي الثانوي، والاعتراف باللغة الأمازيغية بوصفها لغة وطنية للدولة ثم الاعتراف بها لاحقاً بوصفها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
لكن هذه الإنجازات الدستورية لم تؤمن الموارد ولا الدعم الحكومي الضروريين لضمان التنفيذ الكامل والوافي لتلك التعديلات. أحد الأمثلة على الخطوات القانونية التي تبدو ظاهرياً إيجابية لكنها تحول دون تحقيق المساواة الكاملة، هو ما حدث في نيسان/أبريل 2020، عندما سارعت الحكومة إلى إصدار قانونين، أحدهما يجرم “الأخبار الكاذبة” التي ترى الدولة أنها تضر “بالنظام العام وأمن الدولة والوحدة الوطنية”، بينما يعاقب الثاني على التمييز وخطاب الكراهية، وهو ما يعد في الواقع أداة لفرض رقابة على النشاط الأمازيغي وقمعه.
فقانون تجريم الأخبار الكاذبة ما هو إلا ذريعة لتمكين الحكومة من قمع حرية الصحافة والتعبير عن الرأي. فيما يرى ناشطون أمازيغ أن قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية لا يكفل أيضاً المساواة الكاملة على أرض الواقع. ويعتبره كثيرون غامضاً للغاية، مما يعطي مساحة للقاضي لتفسيره بحسب رؤيته وبالتالي إتاحة الفرصة أمام النظام لممارسة الضغوط على الجهاز القضائي الذي يعتبر بعيداً كل البعد عن الاستقلالية.
السود هم السكان الأصليون لجنوب الجزائر. فقد عاشت فئتان سكانيتان في الجزائر منذ العصر الحجري الحديث على الأقل: كانت إحداهما تتمتع بسمات سكان ساحل البحر الأبيض المتوسط بينما كانت الأخرى ذات “ملامح زنجية”.
ولهذا، يمكن اعتبار السود، الموجودين في جنوب الجزائر قبل حتى تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى التي دامت 13 قرناً، جزءاً من سكان الجزائر الأصليين تماماً كالأمازيغ.
نظراً لانتشار غالبية الجزائريين السود في الصحراء الجنوبية الشاسعة، وهي جزء من البلاد يجهله عدد كبير من الجزائريين، فإن غالبية الجزائريين البيض لا يعلمون اصلاً بوجود مواطنين جزائريين سود البشرة.
لكن، وعقب توجه إقليمي يهدف إلى إخماد قضايا التنوع الديموغرافي، لم تجرِ الحكومة الجزائرية قط تعداداً سكانياً لتحديد العدد الإجمالي للمواطنين الجزائريين السود في البلاد، حيث لا تزال تتركز غالبيتهم في الصحراء الجزائرية. وقد أسس الجزائريون السود أيضاً مجتمعاتٍ في بعض المدن الشمالية: كالجزائر العاصمة ووهران. لكن العدد الإجمالي للجزائريين السود تُرك للتخمين: 3.5 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. هذه تقديرات أوّلية.
ونظراً لانتشار غالبية الجزائريين السود في الصحراء الجنوبية الشاسعة، وهي جزء من البلاد يجهله عدد كبير من الجزائريين، فإن غالبية الجزائريين البيض لا يعلمون اصلاً بوجود مواطنين جزائريين سود البشرة.
وبطبيعة الحال، ذكر كثيرٌ من الجزائريين السود أن إعلانهم عن الانتماء للهوية الوطنية يُلاقى دائماً بالشك في مناطق الجزائر الشمالية، سواء كان ذلك عند حواجز الشرطة أو في المطارات وحتى عندما يمارسون أبسط أمور الحياة العادية، من قبيل الإجابة عن سؤال أحد المارة حول الوقت، “عندما أمشي في الشارع ويرغب أحد المارة في سؤالي عن الوقت، فإنه يحدثني باللغة الفرنسية، اقتناعاً منه أنه يتحدث إلى شخص نيجيري أو تشادي، في إشارة إلى أن الجزائري لا يمكن أن يكون أسود البشرة”، كما ذكر شريف الوزاني في شهادات نقلها في مقالة منشورة في العام 2004.
مجتمع ما بعد الاسترقاق
عندما يفكر الجزائريون في التمييز “العنصري”، فإن أول ما يخطر ببالهم على الأرجح هو المعاملة التي تلقاها الجزائريون العرب والأمازيغ على يد الفرنسيين خلال الحقبة الاستعمارية (1830-1962)، ولاحقاً في فرنسا ذاتها. فقد صرح أحمد بن بلّة، أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال، خلال زيارته للعاصمة الغانية أكرا عام 1963، قائلاً “إن الإمبرياليين هم الذين حاولوا التمييز بين ما يسمى الأفارقة البيض والسود”.
رغم ذلك، لا يزال استعباد الأفارقة السود يشكّل جزءاً من التاريخ الجزائري. فقد تسببت تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى التي استمرت على مدى 13 قرناً، في إحضار 65 ألفاً من الأفارقة السود إلى الجزائر في الفترة ما بين 1700-1880 وحدها.
وعلى الرغم من إلغاء الفرنسيين لتجارة الرقيق في مناطق الجزائر الأخرى، فقد استمرت هذه الممارسات في المناطق الصحراوية طيلة فترة الاستعمار الاستيطاني الفرنسي (1830-1962).31
اختلفت أنماط استخدام الرقيق في الجزائر بين ساحل البحر الأبيض المتوسط والصحراء الجزائرية. ففي المناطق الشمالية من الجزائر قبل الاستعمار، كان العبيد السود يعملون بصفة رئيسية في الأعمال المنزلية. وفي الصحراء الجزائرية، اتخذت العبودية شكلاً أقسى. فقد أسس البيض العرب والأمازيغ اقتصاداً يعتمد على عمالة الرقيق السود من “الحراطين” (وهم المستعبدون أو السود المؤسلمون أو المستعربون المعتوقون حديثاً، والذين ما زالوا عرضة لممارسات السخرة).
واليوم يعمل “الحراطون”، ومعظمهم من المزارعين المستأجرين، في ظل ظروف عمل قاسية يصفها البعض بأنها شكل حديث من أشكال العبودية، إذ إنهم “يحفرون الآبار ويرعونها، ويشقون ويحافظون على قنوات الري الجوفية، ويروون الحدائق، ويرعون الماشية، ويزرعون النخيل”، بحسب شهادات تنقل عنهم. فضلاً عن أن العمل الشاق والدؤوب للري في الصحراء ينطوي على حفر قنوات تمتد إلى عشرات الأقدام في الرمال مع احتمال مواجهة خطر الغرق أسفل منها. ويدّعي البعض أنه لولا عمالة السكان السود المستعبدين، لما كانت الصحراء الكبرى صالحة للعيش على الإطلاق.

انتهت العبودية ببطء في الجزائر التي استعمرتها فرنسا عام 1830. فقد أصدر الفرنسيون قراراً بإلغاء العبودية والرق بصورة نهائية وبطريقة رسمية في البلاد عام 1848. وفي عام 1906، اتخذ الفرنسيون خطوات أشد صرامةً لإلغاء هذه الممارسة، على الرغم من أن الاعتبارات العملية للحكم الاستعماري أدت إلى بعض القبول لهذا العُرف.
فقد أفسح الفرنسيون مجالاً للعبودية في الصحراء الجزائرية أكثر من أي مكان آخر. وحصل سادة العبيد والتجار على تصريح للاتجار بالعبيد والإبقاء على ما يملكونه حتى القرن العشرين. في مقابل ذلك، قدّم النخاسون والتجار معلومات استخبارية حول المناطق البعيدة إلى السلطات الاستعمارية.
في معظم الحالات، انتهت ممارسات العبودية الزراعية والمنزلية تدريجياً في الجزائر خلال القرن العشرين. ولكن ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن السود المستعبدين ما زالوا يُستغلون في الأعمال الزراعية في الواحات الجنوبية من مدينة ورقلة وغرداية حتى يومنا هذا (من قبل الأسر الغنية، وأصحاب مزارع النخيل الكبيرة والحقول والمزارع)، وفي بعض الحالات، من قبل الطوارق شبه الرحل.
لم تتبن الدولة الجزائرية قط أي سياسات ترمي إلى اتخاذ إجراءات إيجابية، لمساعدة سكانها السود على التعافي من أثر أجيال من العبودية والمعاملة الوحشية. بل سعت بدلاً من ذلك إلى إضفاء الشرعية على هوية البلاد العربية الإسلامية البيضاء فقط. وشككت في ادعاءات التمييز من خلال التأكيد على أن التمييز العنصري والعرقي أمر مستحيل لأن الدستور يكفل الحق في المساواة بين جميع المواطنين الجزائريين.
ومع ذلك، غالباً ما يظل أحفاد “العبيد السود المحررين” (الحراطين) في المناطق الصحراوية في الجزائر يعتمدون على “الأسياد” السابقين. ومعظمهم يعملون مزارعين مستأجرين في ظروف مشابهة للرق. ويواجه الجزائريون السود أيضاً التمييز في المناطق الحضرية من البلاد. إذ إنهم يواجهون المواقف والإهانات العنصرية التي يواجهها أي شخص آخر ذو بشرة سوداء داخل الحدود الجزائرية.
وفي نسخة أخرى من التهميش والإقصاء، غير المنظور، يلاحظها باحثون عن قرب، يمنع على السود تقلّد مجموعة من المناصب المرموقة والمجزية في الاقتصاد والجيش والحكومة والعمل كممثلين وعارضي أزياء.
إقرأوا أيضاً:
رهاب السود
لا يزال المجتمع الجزائري يعتبر نفسه مجتمعاً قد عانى من العنصرية الاستعمارية الخارجية أكثر من كونه مجتمعاً قادراً على استعباد أقلية من سكانه وإخضاعها للممارسات العنصرية؛ الأمر الذي يتجلى في معاملة الجزائريين السود كما لو كانوا جزائريين غرباء، أو مواطنين أشباح. لأنه عندما يكون الجزائريون السود على مرأى من مواطنيهم البيض، يمكن للكلمات والنظرات أن تفصلهم عن باقي المجتمع وتحاول إذلالهم، بأوصاف عنصرية. فنجد أن كلمة “الأكْحَل” (الأسود) حُرّفت إلى “كَحْلُوش” (الشخص ذو البشرة السوداء)، و”مير أوبا” (أسود بلون الفحم)، و”قربة كَحْلة” (وعاء أسود لحفظ الماء مصنوع من جلد الماعز)، و”بطاطا سودا” (الشخص ذو الأنف الأسود الكبير الذي يشبه البطاطا)، و”حبّة زيتون” (في إشارة إلى لون الزيتون الأسود)، و”باباي” (الزنجي)، و”أكلي” (العبد الأسود في بعض مناطق الأمازيغ)، و”روجي” (وهو الشخص الأَصْهَب أو يوصف بأنه سويدي في إشارة إلى أن هذا الشخص الأسود يشبه ذوي البشرة البيضاء من الناحية الثقافية والاجتماعية، مثلما يجب على الجميع أن يكونوا)، و”ساليغاني” (أي أنه من السنغال).
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يتعداه إلى استخدام إشارات مباشرة تُعبر عن أوضاع العبودية القديمة من قبيل: “الحرطاني” (وهو العبد الأسود القاتم أو العبد المحرر الذي يُجبر على العمل خارج بيت سيده)، و”الخادم”، و”الوصيف” (العبد الذي يعيش في المنزل)، و”العبد”، و”عبد مقانا” (العبد الأسود القذر). يُرسي استخدام مثل هذه المفردات ضد المارة الجزائريين السود أسس الاختلاف والازدراء والشعور بالغربة والرفض والتباعد والإقصاء.
يتخذ رُهاب السود أشكالاً عديدة في الجزائر. فقد أشار باحث أكاديمي جزائري أسود إلى أنه بالإضافة إلى الإهانات العنصرية، “لا يزال مجتمعنا يعتبر أن الأسود يرمز إلى الحظ السيئ. بل والأسوأ من ذلك: في حكايات الجدات، نجسد الشخصيات الشريرة، أو مختطفي الأطفال، أو اللصوص، أو المتشردين، بأنهم دائماً سود. وبينما يأتي العرب والأمازيغ في سياق التاريخ المشرف المعروف في الجزائر، ليس هناك مكان لبطل أسود في الذاكرة الجمعية لِشعبي”.
ولعل افتتان الجزائريين البيض بـ “الموسيقى القناوية”، والاحتفالات الشعائرية (ديوان) التي تتمحور حول السود، يتناسب مع هذا الإطار الثقافي الشعبي الذي يحيط السود باعتبارهم مواطنين جزائريين عاديين، تماماً مثل أي شخص آخر، لكن الوقائع الإجتماعية تعاكس هذا التمنّي، اذ لا تزال حالات الزواج المختلط بين الأعراق نادرة ويعتبرها الكثيرون من الجزائريين البيض، إن لم يكن معظمهم، من المحرمات. وإذا تزوجت امرأة أو رجل جزائري “أبيض” من شخص أسود، فثمة احتمالاً قوياً بأن يُقابل هذا الرجل أو هذه المرأة بالرفض من عائلة الشخص الآخر. ويضرب المثل عن أحد القوميين الجزائريين السود الذي قاتل ضد الفرنسيين تعرض لانتقادات من جانب رفاقه بسبب زواجه من امرأة فرنسية. فكان رده على ذلك: “من منكم قد يود تزويجي شقيقته؟”.
وحتى الآن، يكاد يكون من المسلم به أن محاولات الجزائريين “البيض” للزواج من الجزائريين السود ستُقابل بالرفض من الأسر البيضاء؛ وفي بعض الأحيان يتبع هذا الرفض ملاحظة خبيثة بأن “هناك العديد من البيض يُمكن الزواج بهم. إذا كنت تود الزواج سأجد لك شخصاً مناسباً”.
علاوة على رفض الزواج المختلط بين الأعراق، سجّلت حالات رفض فيها جزائريون “بيض” السكن مع السود أو الدراسة معهم في الجامعة.
في حين يُعد تتويج الشابة الجزائرية خديجة بن حمو، وهي امرأة سوداء من الصحراء الجزائرية، بلقب ملكة جمال الجزائر لعام 2019 بمثابة خطوة إلى الأمام في الحد من رُهاب السود، إلا أن ذلك أثار جدلاً حاداً وموجة من السخرية والتعليقات العنصرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
يكاد يكون من المسلم به أن محاولات الجزائريين “البيض” للزواج من الجزائريين السود ستُقابل بالرفض من الأسر البيضاء.
السود الآخرون
ازدادت حدة رُهاب السود في الجزائر وتفاقمت بوصول “السود الآخرين” من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين هاجر عشرات الآلاف منهم إلى الجزائر في العقود القليلة الماضية. فقد فر العديد منهم من العنف، أو الفساد، أو الفقر، أو الحرب الأهلية، أو بسبب انهيار دولهم. إذ يسعى معظمهم إلى العبور غير الشرعي إلى أوروبا. أما الآخرين فقد جاءوا من أجل الحصول على التعليم أو فرص اقتصادية أفضل في الجزائر. في أغلب الأحوال، لم يكن هؤلاء المهاجرون السود موضع ترحيب. ومع ذلك، فقد سلط الضوء عليهم. وبسبب الضغوط المفروضة على الجزائر لحملها على السيطرة على حدودها من الاتحاد الأوروبي، تعرض المهاجرون من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى لحملات التحقير من قِبَل الحكومة الجزائرية وبعض المنصات الإعلامية، ووجهت إليهم اتهامات -غالباً ما تكون باطلة- بالضلوع في جرائم العنف، وبيع المخدرات، والمجون، ونشر الأمراض التناسلية، وإدامة الفوضى، واغتصاب النساء الجزائريات.
وبقدر كبير من المفارقة، دعت بعض الكتابات الجدارية ومواقع التواصل الاجتماعي المهاجرين إلى “العودة إلى أفريقيا”. في حين اعتقلت الحكومة الجزائرية آلاف من هؤلاء المهاجرين السود ونقلتهم إلى مناطق بعيدة من الصحراء الكبرى، في مناطق حدودية أو عبرها، حيث تركوا هنالك من دون أن تتوفر لهم السبل اللازمة للبقاء على قيد الحياة في الصحراء. وقد أدى الغضب الدولي إزاء هذه المعاملة للمهاجرين الأفارقة السود إلى بدء الحكومة الجزائرية في معالجة وضعهم القانوني.
على الرغم من ذلك، في أواخر عام 2020، يؤكد هذا العنوان الرئيسي في تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” أن المسألة لم تُحل بعد: “الجزائر: طرد مهاجرين وطالبي لجوء. طرد الآلاف، بينهم أطفال، إلى النيجر بدون إجراءات قانونية”.
إقرأوا أيضاً: