مرّت عشر سنواتٍ أو أكثر بقليل، لم أفتح خلالها خزانة أسطواناتي المضغوطة للاستماع إلى إحداها. تذكّرت هذا الأمر فجأة عندما أهداني صديق لي أسطوانة موسيقية من نتاجاته الجديدة. ولم يكن السبب في هذا الجفاء بيني وبين خزانة الأسطوانات الثمينة عائداً إلى قرار شخصي في الابتعاد من عادةِ الاستماع إلى الموسيقى، وهي عادة مُنتظمة مُنذ حداثتي، بل يعود السبب في هذا إلى تغيير جذري في الوسائط والأدوات التكنولوجية.
هذا التغيُّر الدائم والتبدل السريع نسبياً في هذه الوسائط التكنولوجية يطرح مجموعة أسئلة قد لا تكون مُستجدّة، إنْ من حيث الصناعات التكنولوجية الحديثة من جهة والدعوة إلى الاستهلاك وترويجه من جهة ثانية. كما قد تطرأ أسئلة من النوع التقليدي، حيث المفاضلة بين قيمتين متصارعتين؛ القديمِ من الوسائط والأدوات التكنولوجية من ناحية وأجدها حداثة من ناحية ثانية.
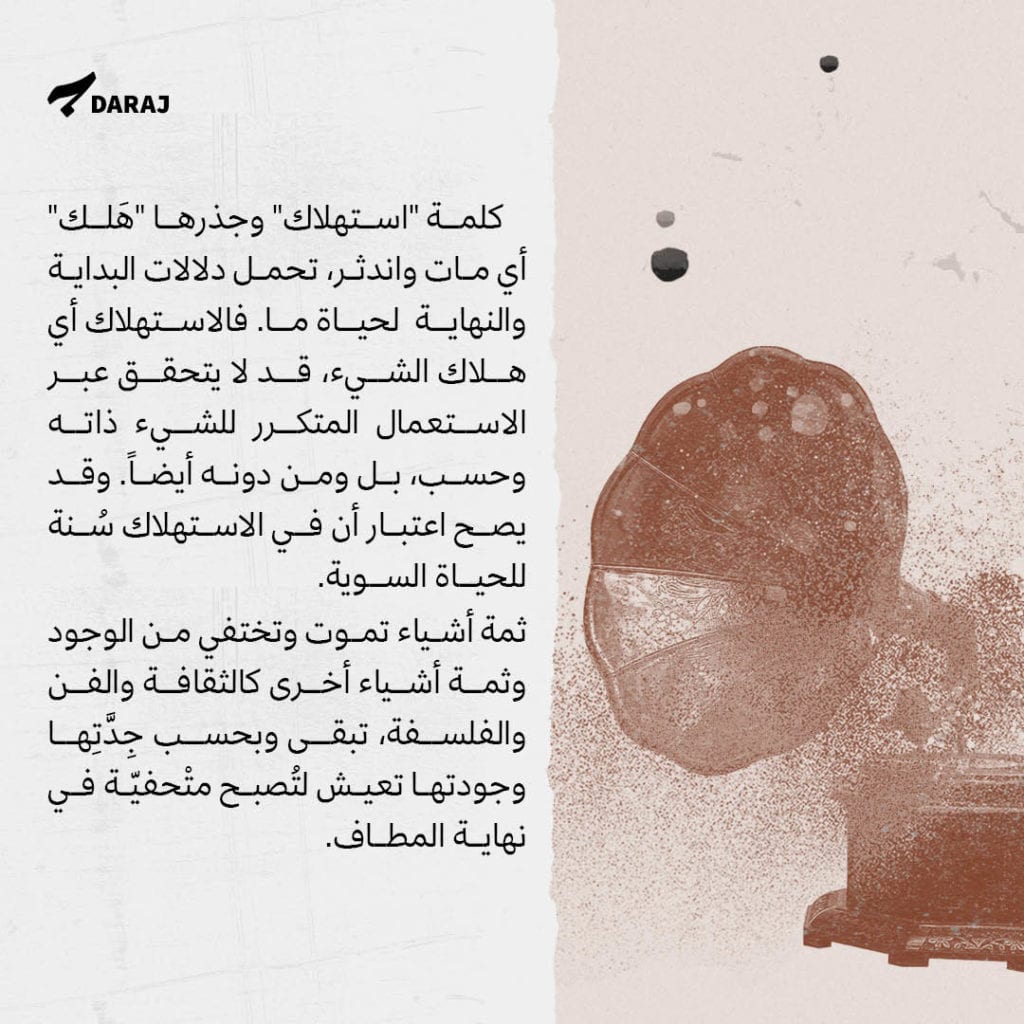
ولكن السؤال المُستجد في هذا الموضوع يدور حول الوسائط الجديدة في عملية إصدار التسجيلات الموسيقية الجديدة وبثها وقدرتها على الانتشار في أوساط جمهور المُستهلكين. لِيَبْرُز سؤالٌ حول، ماذا نفعل بكل هذه الوسائط والأدوات المتقادمة في الزمن، المُتراكمة والمتهالكة في مساحات البيت وخزائنه. ومنه يتفرع سؤال جانبي: ماذا سأفعل أنا شخصياً بخزانتي المُحتوية على الكثير من الأسطوانات المضغوطة والتي كلما تقدم الزمن هنا تحديداً في لبنان، تأكد بُعدي منها؟ وهذه الأدوات والوسائط أحصرها هنا في مقالي بمجال الموسيقى والأغاني بثاً وتسجيلاً.
فبدءاً من عصر تكنولوجيا الراديو والبث الإذاعي الذهبي، وصولاً إلى عصرنا هذا الرقمي- الثوري وما نتج عنه من وسائل تواصل في مختلف الميادين، مرّ 80 عاماً تقريباً، 30 سنة منها كان التحول فيها كثيفاً وجذرياً حاملاً معه أدوات تكنولوجية لا حصر لها، بحيث أن “عسراً في الهضم” قد أصاب جمهور المستهلكين بالمعنى المجازي للكلمة الذي قد يُشار به الى صعوبة الإحاطة بتعقيدات تشغيل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية.
فمَع كلِّ اكتشاف تكنولوجي جديد يبرز مولود جديد كأداة له، يعزل المولود السابق، وينفيهِ الى بؤرة معزولة بحيث يتكفل الزمن بإنهائه من حيز الوجود. هكذا انتهى الغرامافون مثلاً وبعده مُشغّل الأسطوانات “33 لفّة”.
في الطريق إلى “الكاسيت”
في هذا السياق، احتدمت معارك طويلة بين جهازي الراديو والتلفزيون، بين الغرامافون ومُشغِّل الاسطوانات الحديث، بين الأسطوانة السوداء “33 لفّة”، وبين “الكارتردج” الذي لم يعش طويلاً ليتربع مكانه الشريط المُمَغنط (الكاسيت). و”الكاسيت” هذا كان بنى ما يُشبه “امبراطورية”، قبل أن ينهار لمصلحة الأسطوانة المضغوطة “سي دي”، التي تهيأ لنا أن شمسها ستسطع إلى الأبد، معلنة نهاية العلم واكتشافاته التكنولوجية في مجالي البث والتسجيل. بيد أن الثورة الرقمية أطاحت به وجعلت عالم هذه الأسطوانة المضغوطة يذوي شيئاً فشيئاً من دون الإجهاز عليه بشكل كامل ونهائي. نرى اليوم أن سيطرة ساحقة تحققت للذاكرات المتناهية في الصِغر حجماً ذات السعة الهائلة، بحيث تتسع لمُحتوى عشرات آلاف الأسطوانات المضغوطة.
في كواليس مسرح هذه المعارك تقف على قدم وساق مراكز أبحاث صناعية تضم مخترعين ومبدعين ومُطورين في مجالات العلوم التطبيقية والإنسانية كافة.
ولكن الجدير بالملاحظة هنا هو أن الحاضر الذي نعيشه لا تتحقق فيه سيطرة وسائط وأدوات تكنولوجية على اُخرى، والأرجح أنّ ثمة غلبة لوسائط على أخرى. والغلبة كما تبدو لي جليّة، تميل كفّتها لمصلحة الثورة الرقمية وما تُنتجه من مواليد جُدد كأدوات جذابة ومختزلة في الحجم والمهمات، تهتم بعملية الإنتاج الموسيقي والاستماع وأهمها على الإطلاق: جهاز الكومبيوتر المحمول والذي حل محله سريعاً الهاتف الخليوي الأصغر حجماً او الأجهزة اللوحية الرقمية التي اختزلت مجموعة كبيرة من الأجهزة، مثل الكاميرا والتلفزيون والإذاعة والراديو والساعة والمايكروفون والآلة الحاسبة والمكتبة والجريدة وغيرها، حتى إنها بدَّلت في مُجريات بعض المِهن. واحتوت على منصات خاصة لسماع الموسيقى والتسجيل والبث على أنواعها، مثل “يوتيوب”، “آبل ستور”، “سبوتي فاي”، “أنغامي” والكثير من المنصّات والتطبيقات المتخصصة بالبث والتسجيل.
إقرأوا أيضاً:
هذه التطورات التكنولوجية كلها، جعلت من عملية إصدار كميات من الأسطوانات المضغوطة في وقتنا الحالي، أمراً لا جدوى منه على الصعيد المادي، مع صعوبات بالغة المشقّة لناحية التسويق والنشر.
ومع عدم قدرة الجمهور الواسع على مواكبة الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا ومواءمتها، يحاول مطوِّرو الشركات التكنولوجية جهدهم في ابتكار حلول بسيطة لإعادة بث حياة ما، في أوصال أدوات تكنولوجية قديمة مثل مُشغِّليّ الأسطوانات “33 لفّة” وشريط “الكاسيت” المُمغنط، وذلك عبر إضافة فتحة للإخراج الرقمي، واضعين نُصب أعيُنهم هدفين: الأول هو تأكيد نهاية صلاحية هذه الأدوات ومُنتجاتها والثاني هو إعادةُ وصلٍ لأجيالٍ انقطعت او تكاد تنقطع عن التكنولوجيا الرقمية وانسلخت بالتالي عن جمهور مُستهلكي أدواتها الجديدة.
وقد يصح القول في أن هذين الهدفين يصبّان حتماً في موضوع التنافس على الأسواق واجتذاب أعداد المُستهلكين، من دون إغفال حقيقة أن الاكتشافات العلمية، وخصوصاً التكنولوجية منها، مرتبطة بالتنافس الشديد بين الشركات الصناعية الكبرى على الدخول في أسواق جديدة لاجتذاب جمهورها من المستهلكين.
من دون أن أرى أنّ ثمة مُشكلة فعلية تكمن في كلمة “استهلاك”، إلا إذا كان هذا الاستهلاك صفة ملازمة ومُبالغاً فيها لمجتمع لا يُنتج شيئاً مما يستهلكه. أمّا في ما عدا هذا فَفِعْلُ الاستهلاك ليس بالضرورة فعلاً مكروهاً، كما يُتدوال في أوساط المتمسكين بصُوَر الماضي وأدواته، إذ يُطلقون عليه “الزمن الجميل”، ويناجونه لدرجة القداسة، مُترحِّمين على وسائله وأدواته البدائية، كمَثلِ ذاك الذي لا تُطرب اُذُناه إلا من خلال الاستماع إلى موسيقى أسطوانة الشمع ممزوجة مع ضجيحها الصادر عن الغرامافون.
في تفكيك “الاستهلاك”
حسبي أن في الاستهلاك رفاهية ومُتعة في حياة حاضرِ أيِّ زمنس عاش فيه البشر. كلمة “استهلاك” وجذرها “هَلك” أي مات واندثر، تحمل دلالات البداية والنهاية لحياة ما. فالاستهلاك أي هلاك الشيء، قد لا يتحقق عبر الاستعمال المتكرر للشيء ذاته وحسب، بل ومن دونه أيضاً. وقد يصح اعتبار أن في الاستهلاك سُنة للحياة السوية.
ثمة أشياء تموت وتختفي من الوجود وثمة أشياء أخرى كالثقافة والفن والفلسفة، تبقى وبحسب جِدَّتِها وجودتها تعيش لتُصبح متْحفيّة في نهاية المطاف.
أميل إلى اعتبار أن الاستهلاك هو فعل إنساني فطري يندرج في سياق حب الحياة والتمتع بها. كأن تُسلّم نفسك لمتعة الأكل والشرب واستهلاكهما مستمتعاً مع يقينك في نهاية الأمر، بأن هذا قد يُحدث خللاً في جهازك الهضمي أو لربما قد يعطب بعضاً من أضراسك الضرورية لمتابعة هذا الاستهلاك المُمتع. لا أرى في هذا الميْلِ مذمّة أو نقيصة، إذا كان الاعتدال هو القاعدة، لا بل قد يكون مؤشراً على أن رياح الحياة تجري كما تشتهي أشرعةُ الرغبة.
لعلّني لا أبدو لِلقُرّاء الأعزاء كمُنظِّرللاستهلاك على طريقة مُروجي السلع في وسائل البث التلفزيونية. كما أنني لا أنفي إطلاقاً علاقة التصنيع الاستهلاكي عموماً بخراب البيئة الطبيعية للأرض والمناخ، هذا أمر يقع على عاتق حكومات الدول الصناعية الكبرى وحوكمتها الرشيدة في التخفيف من أضراره. ولكنني هنا أتحدث عن الاستهلاك العقلاني الذي يتعلق بالفرد وخياراته الشخصية.

وقد لا يكون كشفاً جديداً القول إن حال عيْش المواطنين اللبنانيين في هذه المرحلة المُعقدة، وبعد قفزتهم الحُرّة من على شفيرِ هاويةٍ، لطالما أرجحتهم عليها الطبقة السياسية الفاسدة، هي حال كارثية على الصُعُد كافة، وخصوصاً حال نظامهم السياسي والاقتصادي المأزومين، وحال تدهور عملتهم النقدية إلى الحضيض ليخسروا وظائفهم ورواتبهم ومُدخراتهم، ومعها قدرتهم الشرائية والاستهلاكية الطبيعية، وبذلك يفقدون مستوى عيشهم اللائق واستهلاكهم الباذخ الذي اعتادوا عليه وبالغوا في ممارسته. ولكن الإنصاف يقتضي القول إنّ للسلطة الفاسدة في لبنان المسؤولية الأكبر في هذا.
فهذه السُلطة السياسية التحاصصية التي شجعت نظام الزبائنية وأرست لوقت طويل بالتكافل والتضامن مع أصحاب المصارف، نظاماً اقتصادياً قام على الريوع والفوائد المصرفية الخيالية لاجتذاب رؤوس الأموال من كل حدب وصوب، خلقت بذلك فُقاعة ضخمة للاستهلاك والرفاهية المبالغ بهما من ضمن اقتصاد غير منتِج. وفي سنة واحدة انقضت منذ انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، أصبح الشعب اللبناني بمعظم طوائفه وشرائحه الاجتماعية شعباً فقير الموارد بحيث تدنت قدراته المالية على الاستهلاك، إلى ما دون الحدود الطبيعية. مرَّت المئة سنة الأولى من عمر الجمهورية اللبنانية، ولم تصل بعد سلطات الأمر الواقع في لبنان من زعماء وأحزاب تقليدية وزعماء طوائف دينية، إلى امراء الحروب و”شهدائها القديسين”، إلى استنتاج بأن صيغة هذا النظام وأعرافه قد اُستهلكت إلى الرمق الأخير وانتهت بالتالي صلاحيته في الزمن.
ألَمْ يحِن الوقت بعد لهذا “اللبنان” بكل أساطيره المؤَسِسَة وشخصياته التاريخية المُخترعة منها والحقيقية، وبصيغة عيشه الفريدة بإنتاج الحروب والويلات، بأن يوضع في المتحف كما الغرامافون؟
كل هذا يُعيدني إلى سؤالٍ طرحته على نفسي في البداية، حول ماذا سأفعل بخزانتي التي تحتوي على ما يقارب ألفاً من الأسطوانات المضغوطة، جمعتها طيلة 30 عاماً وصرفت عليها من مالي الكثير. لا قرار حاسماً بشأنها في الوقت الحالي، على رغم أنني مُتيَقِّن من أن الهُوَّة بيني وبينها أصبحت كبيرة، ولكن الحكمة تقضي بأن أبقيها كاحتياط “ذهبي” ليوم أسود لا أتمنى وصوله، وفيه قد يُصبح راتبي بالليرة اللبنانية مساوياً لبضعة دولارات. وبعد هذا بقليل سأكون قد استنزفت احتياطاتي المالية، عندها فقط سأتوجه إلى سوق الأحد الشعبي الذي سيصبح في البلاد سوقاً بديلة لكل الأسواق، ويفتح على مدار الأسبوع ليتقاطر عليه معظم سكان لبنان الفقراء، ليبيعوا ما بقي في بيوتهم وقد يصلح للبيع أو للمقايضة. وهناك سأطرح “احتياطي الذهبي” أقصد أسطواناتي كلها للبيع، لعلّني أقع على شارٍ ثريٍ، يُنقدني في مقابله بضعة دولارات لأشتري شيئاً أسُدُّ به جوعي ورمقي.
إقرأوا أيضاً:










