قليلةٌ هي الروايات التي تبقى محافظة على مستوى الجذب، ومنسوب الدهشة، وفتنة السرد وسحره، من صفحاتها الأولى وحتّى الأخيرة. ما قدّمته الروائيّة السوريّة نجاة عبدالصمد في “لا ماء يرويها” من ذلك الصنف الفخم، الذي يمتلك سرداً ممغنطاً، مشحوناً بلغةٍ شعريّةٍ رقيقةٍ، بسيطةٍ، عميقةٍ وآسرة. لغة بعيدة تماماً عن استبداد وسطوة الشعر على السرد، وغلواء تحكّمه بالنصّ الروائي. ذلك الاستئثار الشعري الطغياني على السرد، وتوظيف لغةٍ مستوردة من كتب التراث، أو منحوتة على شاكلتها، ابتعدت الروائيّة منهما، وقدّمت نموذجها الحيوي الذي يراعي؛ اللهجة العاميّة – المحليّة، وتطعيم المتن بالأقوال والأمثال الشعبيّة المأثورة، أو مقاطع من الأغاني الفلكلوريّة، بتلك التلقائيّة التي يعيشها كلّ واحد منّا أثناء الأحاديث العابرة. فضلاً عن ذلك؛ “لا ماء يرويها” رواية تقدّم تركيبة خاصة وخلطة معقّدة من حيوات ومصائر متقاطعة، وآلام وخيبات متوارثة، من جيل إلى آخر.
جدل العنوان
أتى عنوان الرواية ملتبساً، لا ينفي وجود الماء، ولا يؤكّده. لكنه يشير إلى استمرار الظمأ، حتّى مع وجود الماء. فربّما مع الإقرار بوجوده، إلاّ أنه فقد صفة الروي، أو أن حجم وعمق العطش الحاصل يتجاوز كميّة الماء أو المياه الموجودة. زيدوا على هذا وذاك، “هاء الغائب” صحيح أن تعود إلى مفردة مؤنّثة غائبة – “حاضرة”، إلاّ أنها لا تفصح كنه تلك المفردة؛ وهل ذلك الكائن المؤنّث؛ امرأة، مدينة، شجرة، نبتة، غابة، طيور، غزلان، قطط، ذئاب، أيّام، ذكريات، أحزان…؟ وعليه، العنوان جاذبٌ للتأويل. في حين أن متن الرواية يشير في أماكن عدّة، إلى عائديّة “هاء الغائب” تلك: “أينما حللن سيكنّ نساء العطش ونساء المُرّ، ونساء الملح، وسيبتلَيْن بالهجران” (ص117). إذاً، يفترض أن يكون العنوان: “لا ماء يرويهن”! وطرح الحديث في الصفحة 142 عن شحّ المياه والأمطار الذي يضرب المدينة. وحين نقرأ: “شبّ الأبناء والأحفاد وفي حلوقهم جفاف، وفي مراياهم غولُ العطش، تمرّ سنوات خيرٍ وترتوي الأرض وتمتلئ المناهل ولا يزول خوفهم. ترعبهم سنينُ محْلٍ تكمن لهم في كرّاسة الغيب وقريباُ ستلوح، من أين لهم حينها بماءٍ يغنيهم عن أعطيات سماءٍ بخيلة؟” (ص134-135). هنا، وكأنّ العنوان يفترض به أن يكون “لا ماء يرويهم”! بينما حين نقرأ: “تضمّ كأس الماء الذي شربتُ نصفه، تخمش قلبي بفرحةٍ مباغتة، ترشف نصف كأسي حتى القطرة الأخيرة، وأرشف رجفة صوتكِ في لفظ: (عطشان) أشفَّ من طعم قبلةٍ طويلة. لو من يدي أسقيك كمشة ماءٍ مجبولٍ بتميمةٍ تبقيك قربي إلى الأبد”. ثم تضيف: (يهسّ الهمسُ في كبدي: أنا العطش الصرف، أنا الشوق المُصفّى) (ص117)، هنا، ينجلي الغموض عن “هاء الغائب”ـة، وتكشف العبارة؛ إلى مَن تعود، مع كشفها طبيعة العطش، وأن مياه الحبّ والوصال، هي المقصد والمبتغى والمرتجى.
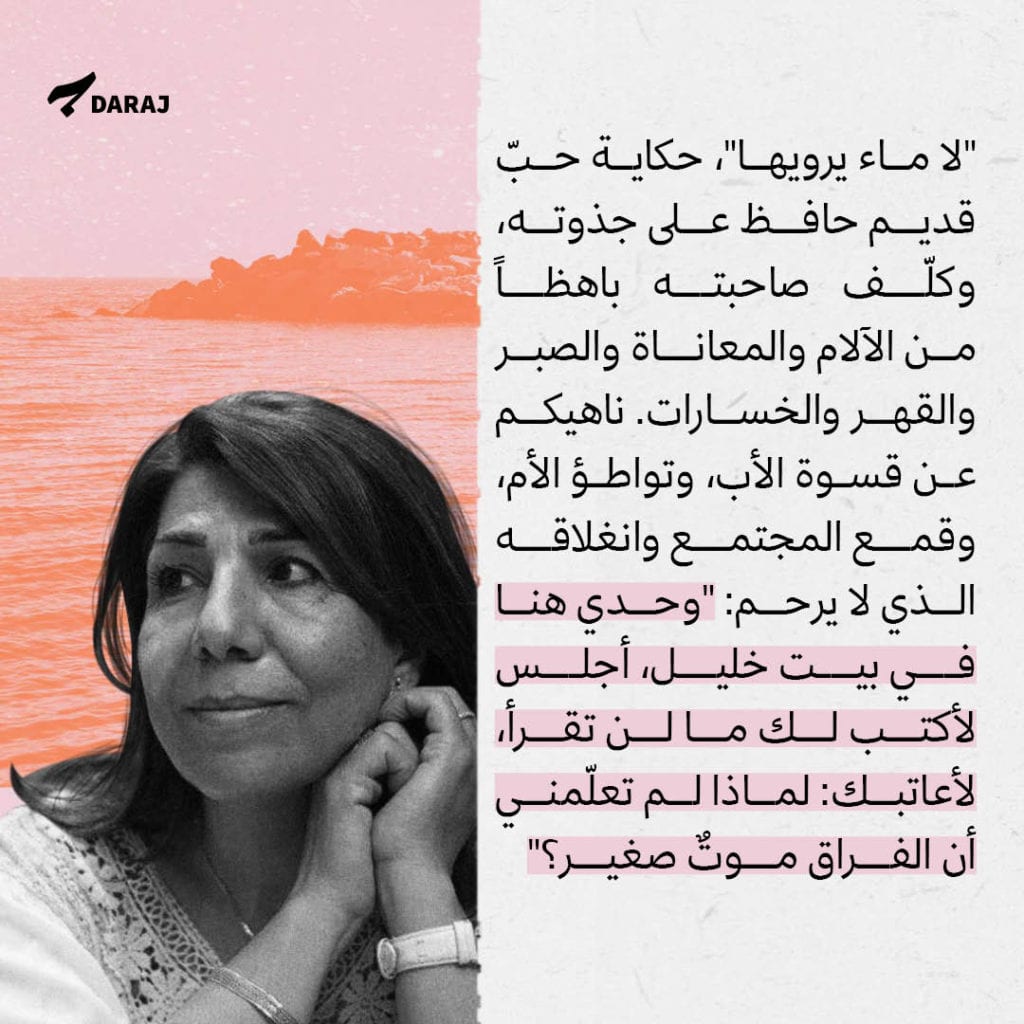
آلام بلا حدود
“أن تكوني امرأة، هذا ألم. تتألّمين حين تصيرين صبّية وحين تصيرين حبيبة تتألمين وحين تصيرين أّمًّا… ولكن ما لا يطاق على هذه الأرض هو أن تكوني امرأة لم تعرف هذه الآلام كلها”. فاتحة الرواية، وعتبتها الأولى، تفصح عن تعريف موجز لحياة المرأة على أنها عصارة آلام متلاحقة، وأنها إذا لم تعش تلك الآلام، فهي امرأة لا تُحتمل. ذلك المقتبس هو للشاعرة البلغاريّة بلاغا ديمتروفا (1922-2003) التي انتخبت نائباً لرئيس بلغاريا سنة 1992، وتركت منصبها في نفس العام، نتيجة خلافات مع الرئيس جيليو جيليف (1935-2015). وارتكاز واستناد الروائيّة على ذلك المقتبس وكأنّها تضع في يد قارئها رأس خيط سرديتها في “لا ماء يروها” على أن “هاء الغائب” في العنوان، تعود على المرأة، وأن كينونتها لا معنى لها إن لم تكن مقرونة بالآلام: “ما لا يطاق على هذه الأرض هو أن تكوني امرأة لم تعرف هذه الآلام كلها”! وكأنّ المرأة لا يفترض بها أن تستسلم لتلك الآلام وحسب، وبل تفتخر بها أيضاً. ذلك أنها كائن لا يطاق، بدون آلامه. معطوفاً على ما سلف، تستهلُّ الروائيّة الفقرة (1) من الرواية بالحديث عن المآتم السبع التي تعيشها المرأة في حياتها: ولادتها كأنثى، بدء الحيض، ليلة الدخلة، آلام المخاض والولادة، فطام كل مولود، موت الزوج أو طلاقها منه، وآخر الميتات، وهو علني؛ “إسلامها الروح إلى بارئها” (ص14). في حين أن حكايات الرواية التي تتقاطع وتتناسل، لا تخلو أيّ منها، من الألم. بالتالي، بطلة الرواية تلجأ إلى القراءة هرباً من آلام الحياة: “يأتيني ناجي بكتب غادة السمان لأقرأ، تأتيني نجوى بالكتب من مكتبة أبيها ومكتبة فوّاز، قد لا يخرج فواز من السجن ولا يعرف كم علقت أصابعي فوق بصماته على صفار الورق، (…) تغويني الكتبُ بأن أُسلم ظهري للريح وأهرب من خليل، ولا أعرف إلى أين أهرب” (ص183). وعليه، رواية “لا ماء يرويها” بحقّ عن آلام المدينة وقاطنيها، في إطار حكاية بطلة العمل التي سمتها الكاتبة عمداً “حياة”.
الحكاية والبناء
الحكاية الرئيسة في الرواية، عادية، يمكن أن تكون حكاية أيّ امرأة في بلاد الشرق. فتاة في مجتمع فقير منغلق، تقع في حبّ ابن الجيران. أسباب وخلافات تافهة، تعيق هذا الحبّ، ولكنها تفشل في اغتياله طيلة عقدين ونيّف. لا شكّ في أن الفكرة ليست جديدة، لكن نجاة عبدالصمد بطريقة معالجتها، ضمن نسيج معقّد من الحكايات، وعبر تقنيّة تعدد الرواة، وبلغة ساحرة وممغنطة، جعلت الرواية استثنائيّة، ومحلّ ثقة النقّاد الذين منحوها جائزة “كتارا”، عن فئة الروايات المنشورة، دورة 2018. وعليه، فضلاً عن كونها رواية تستحق الجوائز، تستحق أن تتحوّل إلى عمل درامي تلفزيوني أيضاً.
الرواية الصادرة عن منشورات “ضفاف والاختلاف” عام 2017، قسّمتها كاتبتها إلى 36 فقرة متفاوتة الحجم، واستهلّتها بفصل غير مرقّم، حمل عنوان “ليس آخراً”. وعادةً، ما يتمّ استخدام هذه العبارة في نهاية رسالة، أو معروض أو مقال، لكن عبدالصمد، استخدمتها كعتبة للفصل الأوّل، إن جاز اعتبار الفقرات الـ36 فصولاً للرواية. صحيح أن الكاتبة ركّزت على تجربة بطلتها؛ حياة، إلاّ أن بقية الأبطال، ذكوراً وإناثاً، ناصر، مهرج، خليل، سالم الأخوث، نجوى، أرجوان، ذهبية، زين المحضر، رجاء، ناجي، الراهب وطفا… وآخرين، يمكن أن يكون أيّ واحد منهم بطلاً رئيساً، وبقيّة الشخصيّات، بقصصها وتجاربها، تدور في فلكه.
كما أسلفت، اعتمدت نجاة عبدالصمد على تقنيّة تعدد الرواة في هذا العمل. فكلّ واحد، يروي نفسه، وأحياناً؛ يروي آخرين. بينما الراوية تسرد حكاياتهم: المدينة، حياة، نجوى، ناجي، أرجوان..، على سبيل الذكر لا الحصر. لذا، نراها تكرر:
“من مرويّات المدينة الشفهيّة” (ص14)، “من مدوّنات المدينة؛ ترويها الأمّهات للبنات الواقعات في الحبّ المستحيل” (ص168)، “من مدوّنات المدينة الشفهيّة الشديدة السريّة؛ يتبادلها الخاصّة في ما بينهم بصمتٍ بليغ” (ص192)، و”من مرويات المدينة السريّة”. واتخذت من هذه العبارات- التوصيفات، ترويسة لمقاطع من الرواية، بدأتها بعبارة “كان يا ما كان” أكثر من مرّة. لكأنّ نجاة عبدالصمد، في روايتها، تفشي أسرار مدينة، بقيت دفينة الصمت والخوف والجهل والتجاهل والإهمال.
كما حظيت نجوى؛ (صديقة البطلة حياة) الطالبة ثم الطبيبة، والناشطة السياسيّة على ما يبدو، بنصيب هام من الحضور في السرد. إذ أحالت الروائيّة إليها بعض المعلومات والتفاصيل على أنها “من أوراق نجوى”، وكررت ذلك 5 مرّات في الصفحات (14)، (142)، (159)، (169) و(219).
جاءت لغة “لا ماء يرويها” متعددة المستويات؛ مطعّمة بالعبارات العاميّة المحليّة أحياناً، سواء على مستوى الجمل، أو توظيف مقتطفات من الأغاني والحكايات والأمثال الشعبيّة. لغةٌ مشوبة بالنفحات الشعريّة أيضاً. زاد منسوب الشعر في الفقرة 36 الأخيرة، وما نقلته الراوية من دفتر حياة. حضور الشعر في سرد نجاة عبدالصمد، كان حنوناً وأنيقاً، بعيداً من التسلّط والتجبّر والطغيان. ولم يمنع ذلك من تسرّب الشتائم التي خدمت النص، كوظيفة فنيّة، على سبيل الذكر لا الحصر، أن تشتم امرأة حبيبها، أثناء آلام مخاض الولادة، وهي على ذمّة رجل آخر، وتلد طفلاً من زوجها، لكن آلامها أطلق العنان للسانها وفضحها شتمها للحبيب الغائب: “كس أمك يا ناصر. في وجع الحشا الأعمى فلْتتْ مسبتي، وانفلق السرّ وانفضحتُ” (ص110). “حرامٌ أن يكون جسدُ امرأةٍ في أرض وقلبها في أرض أخرى. تستحقّ امرأة تستغيث بحبيبٍ وهي تلد ابن رجلٍ آخر أن يفسّر هذا الحبيب لماذا اختفى” (ص246).
إقرأوا أيضاً:
الطائفة الباطنيّة
محافظة السويداء في الجنوب السوري، ذات غالبيّة درزيّة، ولأن طائفة الموحدين الدروز، أقرب إلى الباطنية، وكونها أقليّة مذهبيّة مقموعة، إلاّ أن الروائيّة تناولت بعض الجوانب البسيطة من العادات والتقاليد الاجتماعيّة، وحتّى الدينيّة. وأشارت الكاتبة إلى قصص الحب وزواج البنات من خارج الطائفة، وتبعات ذلك، كنوع من الانغلاق والجهل، عبر سرد حكاية سحر وزواجها من فلسطيني، ما أدّى إلى مقتلها على أيدي أهلها. كما أشارت الكاتبة إلى ضلوع الدولة والطبّ الشرعي في الجريمة: “تمّ تشريح الجثة بحضور القاضي الشرعي الذي دوّن في تقريره أن سبب الوفاة سقوط عفويّ واصطدام بأداةٍ حادة. لم يشر في تقريره إلى آثار الخنق على عنقها، ولا إلى أنها ليستْ عذراء. أخذوا الجثة قبل طلوع الفجر، لم يقيموا لها مراسم عزاء، دفنوها سرّاً كأية قطةٍ أو جروة في أرض بعيدةٍ عن مدافن العائلة” (ص171). كذلك حكاية “رجاء” (أخت البطلة حياة) وتسبب أمّها بمرضها عبر إطعامها خفيةً طحين الزجاج مخلوطاً بالفطائر التي تحبّها، ثم موتها والجنين الذي حملته من علاقة عابرة. كذلك حكاية “سعيدة” التي حملت من بدوي يرعى أغنام والدها. ودرءاً للفضيحة، أجبرتها أمّها على إجهاضها، عبر إدخال سيخ في مهبلها. ثم ترقيع بكارتها عند طبيب في دمشق (ص192). كما أتت الرواية على ذكر كتاب “رسائل الحكمة” المقدّس عند الدروز، أكثر من مرّة، إضافة إلى ذكر العديد من العادات والتقاليد المتوارثة (ص189). “لا معنى لزيارة القبور في عقيدة الدروز. بل هي مكروهة” (ص216). وأشارت إلى عقيدة التقمّص عند الدروز: “يقولون أنّ علمهُ ولِدَ معهُ، يحمله في رأسه من حيواتٍ سابقة” (ص93). ونوّهت الرواية عَرَضاً إلى دور سلمان (الفارسي) في العقيدة الدرزية (ص94)، وفي الصفحة نفسها، كان حديث عن كرامة إحدى الشخصيات “الثانوية” في الرواية؛ سلامة. وذكرت دور ووزن الرجال المتدينين (الأجاويد) في حياة المجتمع الدرزي. وعليه، من الروايات القليلة، وربّما النادرة جدّاً، التي تناولت جانباً أو بعض التفاصيل من حيوات طائفة الموحّدين الدروز، هي رواية “لا ماء يرويها”.
اللافت في العمل، أن معظم الأمهات كُنَّ متواطئات مع أزواجهن ضد بناتهن: أم سحر، أم رجاء، أم سعيدة، باستثناء شخصيّة “زين المحضر” التي خففت من سوداويّة دور الأم في الرواية.
السويداء حبّاً ونقداً
تتحدّث الرواية عن مدينة السويداء، ذات الأغلبيّة الدرزيّة، على أكثر من صعيد. وتشير إلى التقسيم الطبقي– الاجتماعي والاقتصادي في المدينة، عطفاً على التقسيم العمراني ودلالاته: “من خاصرتها، شطر الشارعُ المحوريُّ السويداء إلى نصفين: شرقيٍّ مرتفعٍ ومدلّل وغربيّ منخفضٍ ومنسيّ. في أواخر الثمانينات اكتمل المحوري شرياناً رئيساً يربط شمال المدينة بجنوبها، ويعتلي جسرَ الرئيس في وسطها (…) وخطابات التدشين لم تعتذر عن المحوريّ الذي هشّم وجهَ المدينة القديم وطمسَ شامات فخرها، ولم تعتذر عن الآثار التي نُبشتْ من تحته ونُهبتْ، وطُمِر منها ما لا يمكن اقتلاعه. والجسرُ أكمل رفعَ السدّ بين غرب المدينة المُهان بالإهمال، وشرقِها الآخذ في البرجزة والتعالي على غربها. والجسر رفع أسعارَ العقارات حول ضفتيّه، وباعها أو استثمرها مالكوها، أبناءُ المدينة الأصيلون، واغتنوا وازدادوا علاء على الريفيين الذين اكتفوا بمتابعة العيش على حافة المدينة راضين بما قسم الله لهم والحكومة” (ص204).
تتحدّث الرواية عن عالم المسحوقين والمشرّدين تحت جسر السويداء الذي قسّم الناس إلى فقراء وبرجوازيين، أثناء سردها حكاية سالم الأخوث الأليمة: “تحت الجسر، وفوق التراب والصخر، رسم المشرّدون بخطوط الطبشور حدود قريتهم الضئيلة وحدودَ مراقدهم فيها. مفارشُ الأرض كرتون أو ورق أو نايلون يختلط فوقه الغبار ببقايا الأكل بالأوساخ بالبصاق بروائح الصنّة. لا أثاث كثيراً يعوزهم، لا يعوزهم أيُّ أثاث، أنعالهُم وسائد للنوم، ينامون بكامل ثيابهم، وفيها يطمرون غلالَ الشحاذة أو الأعطيات أو المسروقات، وإلى خواصرهم يربطون صرر الليرات القليلة أو الكثيرة ملفوفة بإحكامٍ وبعُقَدٍ أكثر من أن تُعدّ وأضنّ من أن تنكشف على المشرّد الجار أو الجارة. يقتتلون على حزّ بطيخ، يجوع واحدهم ولا يعترف جارُه بامتلاك رغيفٍ كامل الاستدارة يخفيه في طبقات جيوبه، وقد ينشبُ واحدهم سكيناً في خصر جاره إذا حاول خطف حبة التفاح الهزيلة من يده، ودوماً يتشاتمون بأقذع المسبّات، وكلّ ليلةٍ ينامون متباعدين مفتقدين إلى الدفء والثقة” (ص213).
كما تحدثت عن أمير جبل الدروز، سلطان باشا الأطرش، في أكثر من مكان، وأشارت إلى جانب من تشييع جنازته: “في محفل قائد الثورة السورية ابتلّ ريق السويداء ببعض إنصاف، تمهّدت شعاب الجبل الوعر تستقبل وفوداً رسمّيةً ووفود سفارات، كان أبو عمار أوفى الحاضرين من خارج المكان المنغلق على نفسه كقوقعةٍ منسّية، حضر ممثّل جمهورية لبنان ومنح المجاهد الراحل وسام الأرزة اللبنانية، بينما لم يمنحه رئيس الوزراء السوريّ أي وسام. آلافٌ، مئات الآلاف، كبارٌ وصغارٌ وعجائز من أهل المكان حجّوا لوداعه، غنّى الشباب والصبايا له، لحزنهم، لفخرهم، والتقى العشاق يومها من غير خوف” (ص219-220).
في حديثها عن السويداء، استخدمت الروائيّة أحياناً الجانب الوثائقي في نصّها: “(وكان رب الأسرة بلباس رأسه الأزرق ووجهه الأشقر المتطاول وقد كرّس نفسه لابنه الصغير الوحيد. هنا لا بدّ أن أذكر أنني لم أشهد أبداً من يداعب ابنة له في هذه البلاد) فريا ستارك – رسائل جبل الدروز 1928” (ص184). ومن الجوانب التي تناولتها الروائيّة أيضاً، إماطة اللثام عن الصراعات والخلافات بين العوائل الاقطاعيّة (الدرزيّة) المعروفة، وكيف ينجرّ إليها القرويون البسطاء، دون أن يعرفوا حقيقة تلك الصراعات التي تخفي تواطؤات وانتهاكات أخلاقيّة. على سبيل الذكر لا الحصر: الصراع بين “جاد الله بيك” و”حمدان بيك”، وكيف أن الصراع بينهما اختتم بمصاهرة، بحيث زوّج جادالله بيك ابنته من حمدان بيك، كي يحافظ على الزعامة. لكن الثاني اعتدى على أخت زوجته، وحبلت منه. وكي يبقي جادالله بيك الزعامة تحت إمرته، ضحّى بشرف بنته القاصر، وزوّجها هي أيضاً من حمدان بيك (ص 233-234). في هذه الحكاية، التي سردتها الكاتبة تحت عنوان “من مرويّات المدينة السريّة” نقدٌ لاذع لصور الوجاهات والزعامات الجميلة، التي تخفي خلفها قباحات وانتهاكات فظيعة. كذلك انتقدت مدينتها؛ انتقادها للعادات والتقاليد: “أين سيلتقي مُحبّان في مدينة نمّامة؟ مغفورة كل الخطايا، إلاّ خطايا الحبّ غير مغفورة” (ص249).

أسرار غرفة الكَرَش
“يهجرها أهل البيت ويؤوون فيها أراشيف أعمارهم الضائعة، وفيها تلتقي قوافل ذكرياتٍ يابسة، ومنها تُسمع تمتماتُ ماضٍ لا يموت. على أرضها يئنُّ البلاس العتيق الخشن المجدول من شعر الماعز الأغبر، وعلى حوافها تتمطّى مطاوي الفرشات الآيلة إلى التقاعد حين تهلهلتْ، وتبقّعتْ بخرائط بول الأطفال ونقوش ريلاتهم، وعشّش فساءُ العجائز في صوفها الموهون. لا تكتمل البيوت العربية إلا بغرفة الكرش. يُخزّنون فيها لغائلة الزمن كلَّ الكراكيب التالفة أو المعأّلة، “ما من غرض ترميه إلا ويقول لك الزمن: هاته”. ويمر الزمن والكراكيب في مكانها صورةً مجازية من رُهاب الماضي، دمغة الخوف من الفقر. (…) في غرفة الكرش تلاعب القطط الصغيرة بعضها كأطفال البشر، وتتقاتل القطط الكبيرة بحقدٍ مثل كبار البشر. هنا قد تلتقي امرأتان لتتما روي الأسرار أو النمائم، وإلى هنا يلج عاشقان ضاقت بوجدهما الأمكنة. وهنا يعثر أحد أفراد البيت على أسرار الجميع فيما هو يبحث عن غرضٍ سريٍّ نسي أين كان خبّأه” (ص193-194)، وبمزيد من هذه اللغة التصويريّة المشوبة بالحساسيّة الشعريّة، تصفُ الروائيّة غرفة من غرف البيت، على أنها غرفة المهملات، إلاّ أنها مكمن أسرار العائلة وأرشيفها، ومخبأ شتائم أبناzها.
السياسة
تناولت الرواية أوضاع البلاد في الثلاثينات، وحتّى الثمانينات والتسعينات، وتجنّبت الإشارة إلى الانفجار الذي شهدته سوريا من سنة 2011 ولغاية تاريخ كتابة الرواية 2016. وعليه، قدّمت عبدالصمد نصّاً، حساساً وحذراً جدّاً من التورّط في أوحال السياسة ورمالها المتحرّكة، ما كان سينعكس سلباً على فنيّة النصّ، بالدرجة الأولى. لكن نصّها انتقد السلطة البعثيّة الحاكمة في أكثر من مكان في الرواية. على سبيل الذكر لا الحصر، الحديث عن الاعتقالات التي طاولت قيادات وأعضاء “حزب رابطة العمل الشيوعي”، وسرد حكاية أم فوز الذي أفقدها اعتقال ابنها عقلها (ص176). فضلاً عن تلخيص الحياة على زمن حافظ الأسد بالقول: “في بلدنا نعيش سنوات الفقر والكساد وطوابير الخبز والزيت والسمنة والمحارم والاعتقالات السياسية واقتياد الناس بالعصا إلى مسيرات التأييد للقائد الصامد في وجه الرجعية والصهيونية والامبريالية العالمية وعصابة الإخوان المسلمين العميلة، والناس مرعوبون حتى من تمثال رئيس البلاد الذي يرفع في الفضاء يداً تتوعّد أكثر مما تعد” (ص177-178).
السرديّة الفلسطينيّة
تتسرّب السردية الفلسطينيّة إلى داخل حكايات الرواية عبر حكاية ناصر، الشاب الدرزي الذي ينتسب إلى حركة “فتح”، فيما أسرته في لبنان. ثم يترك الحركة، عائداً مع الأسرة إلى بلده. وبعد رفض أمّه حبّه لحياة وتعلّقه بها، وطلبه الزواج منها، عاد ناصر والتحق مرّة أخرى بـ”فتح” (ص215-224). ودخل سجن الحركة، لأنه عصا أوامر مسؤوليه، بالدخول في حرب ضد الجيش السوري الذي شنّ حرباً على المخيمات الفلسطينيّة في لبنان: “قال لقائده: لن أروح إلى قتال الجيش السوريّ في لبنان. خذوني إلى جبهةٍ أخرى. أقاتل الإسرائيلي: نعم. لكنني لن أقاتل جندياً سورياً قد يكون أخي أو جاري” (ص220). ثم قاتل ناصر ضد الغزو الاسرائيلي للبنان عام 1982، وخرج إلى تونس مع مَن خرجوا، واستقر في رومانيا، وترك النضال، وأصيب بالخيبة: “قلت لي: صارت حزمة الخيبات فضفاضة أكثر من حزمة الأحلام، وانتهينا إلى فراغ” (ص254). كذلك تحضر السردية الفلسطينية بمشاركة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في تشييع جنازة سلطان باشا الأطرش (ص219) وفي أماكن أخرى: “أبكي على أحلى هداياك في العلبة: سلسال فضّةٍ يحمل خريطة فلسطين” (ص254).
“لا ماء يرويها”، حكاية حبّ قديم حافظ على جذوته، وكلّف صاحبته باهظاً من الآلام والمعاناة والصبر والقهر والخسارات. ناهيكم عن قسوة الأب، وتواطؤ الأم، وقمع المجتمع وانغلاقه الذي لا يرحم: “وحدي هنا في بيت خليل، أجلس لأكتب لك ما لن تقرأ، لأعاتبك: لماذا لم تعلّمني أن الفراق موتٌ صغير؟” (ص253).
إقرأوا أيضاً:










