“كانت عليّ عدم الموافقة على المرور من منطقةٍ ذات حراسةٍ أمنية مشددة”، هذا كلّ ما رددته بعدما مررنا من ذلك الحاجز المشؤوم. حين قال لي السائق العجوز سنسلك طريقاً مختصرة، لم أدرك أنه سيمرّ من إحدى المناطق التي شهدت قصفاً عنيفاً وما زالت منازلها مهدمة بشكل شبه كامل. على أحد الحواجز وبينما الضابط يفتش السيارة ويتأكد من هوية السائق الشخصية وهويتي، كان جنديان يحتسيان الشاي، تحرشا بي لفظياً وأطلقا عبارات مخجلة عن جسدي وشكلي.
تمثالُ فتاةٍ عند حاجز للنظام
إنها المرة الأولى التي أتعرض فيها لتحرشٍ لفظيّ مباشر على حاجز أمنيّ، اكتفى رجال الأمن سابقاً بنظرات مريبة.
لم أنظر إليهما، واصلت النظر إلى الأمام من دون إبداء أي رد فعل، تحولت إلى تمثال لا تعابير في وجهه، فأي حركة خاطئة قد تعرضني للخطر، ربما يجبراننا على التوقف لساعة وربما يفعلان أكثر من ذلك.
للحظة تذكرت حاسوبي، هل حذفتُ موادي الأخيرة والمكتوبة باسم مستعار؟ في بضع ثوان هبطت عليّ عشرات الأفكار، وعلى رغم حرصي على حذف أي مقالات أو أفكار معارضة أو محادثاتٍ عن حاسوبي وهاتفي إلّا أنني شككت في نفسي، ربما نسيت إحداها، ربما لم أتخلص من آخر محادثة سألتُ فيها عن مفقودين لدى النظام، صارت تلك الدقائق كساعات وتعمد الضابط إطالة وقوفنا على الحاجز، متأملاً إياي بطريقة مقززة، وهو يسأل: “إلى أين تذهبون”، “لماذا مررتم من هذا الطريق؟”.
غاب الجنود وكلماتهم وبتُّ أسمع “يسلملي هالطول”، كأنّها آتية من مكان بعيد وحضر في رأسي حاسوبي مجدداً، وصرت أكثر حذراً، سأجعل وجهي ثابتاً، لا علامات للقرف أو الغضب أو الاشمئزاز أو حتى الابتسام، لن أمنح الجنود أي فرصة ليغضبوا ويطلبوا تفتيشاً دقيقاً لأشيائي، وصرت تمثالاً لفتاة خائفة واقفة عند حاجز للأمن السوري. لو نجوت هذه المرة لن أنسى حذف أي مادة مع أنني متأكدة من حذفها، لكن ولأن أيّ هفوة صغيرة تمنح الأمن السوري فرصة لاعتقالي بات تفكيري مشوشاً، تابعت إلهاء نفسي بمونولوغ داخلي، فسأكون أكثر حذراً في مراتٍ مقبلة، ولن أرضى بأن يوصلني السائق من طرق مختصرة وخطيرة، أنقذني هذه المرة فقط يا الله ولا تجعلني جميلة ومغرية في أعينهم.
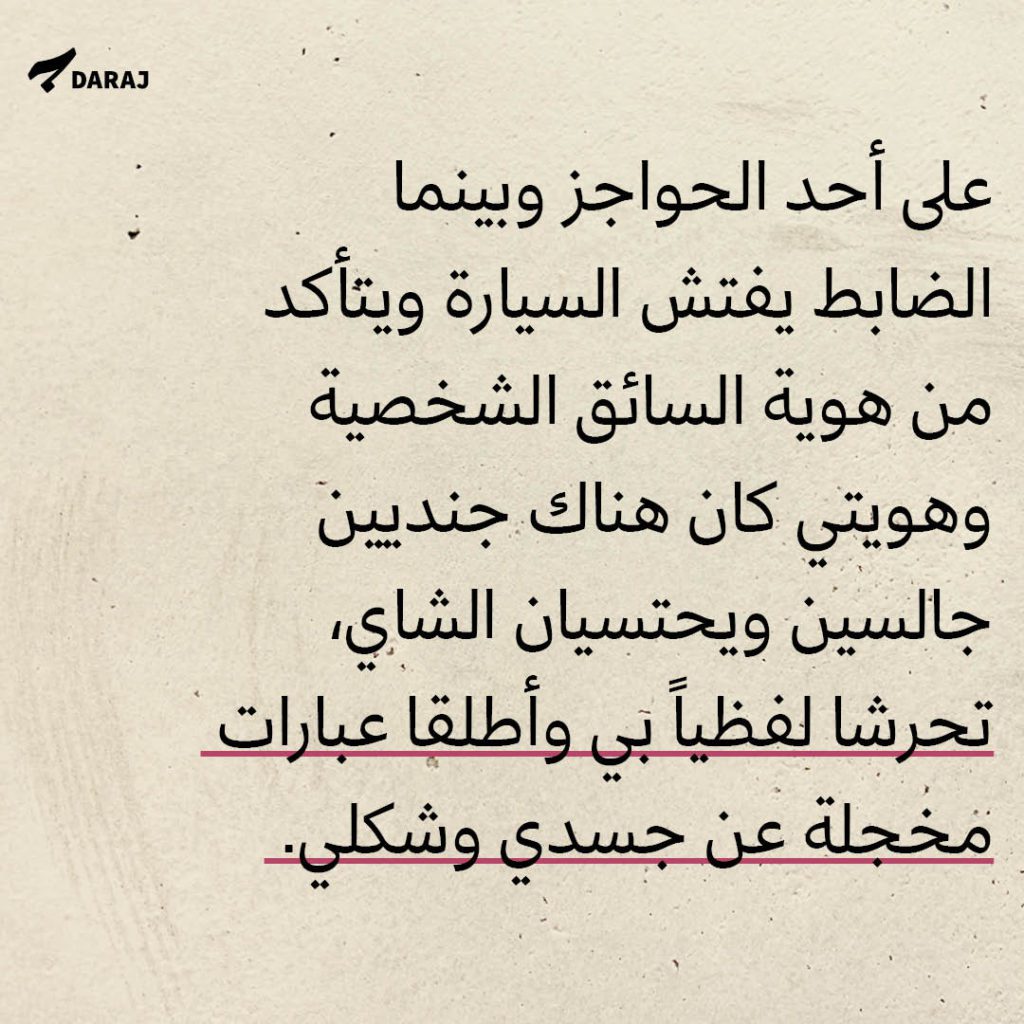
لسنا مذنبات!
عندما تنحصر خياراتكِ ما بين تحرش لفظيّ وآخر جسدي، فإنك بلا شك تقولين لا بأس بما قالوه بما أنهم لم يحاولوا تفتيشي، وهو أمر تواجهه مئات النساء اللواتي كانت خياراتهن اعتقال وموت أو اعتقال واغتصاب، هما الخياران اللذان يطوّقان الفتيات في الشوارع الخطيرة، تحرش لفظي أم جسدي. تقول صديقتي: “منيح ع القليلة ما لمسني”، وهي تعني شاباً تعقّبها الطريق كله وهو يرمي كلمات بذيئة، لكن صديقتي تريد تصديق أنه ولو لمسها، لكان الأمر أكثر سوءاً من الكلمات البذيئة، نحن فتيات محكومات ببلاد تمنحنا رفاهية الاختيار بين تحرش وآخر، بلاد تظن الكلمات أقل إيلاماً من اللمس!
هل ندرك خطورة أن تجد النساء تحرشاً أخف وطأة من آخر؟ فالتحرش اللفظي أهون من التحرش الجسدي، والتحرش الجسدي لا يقارن بمحاولة الاغتصاب، لكن محاولة الاغتصاب تغدو رحمة لو تمّ الاغتصاب، أي أن عشرات النساء يحاولن التعايش مع الاعتداءات الجسدية بإقناع أنفسهن بأنهن نجون من الاغتصاب، وهو السؤال الذي يُطرح على الخارجات من سجون النظام: “عملولك شي؟”، وهذا يعني هل اغتصبك رجال الأمن؟ وتبرد القلوب حين تنفي الفتاة ذلك، لكنهم يتجاهلون بشكل كامل جميع أنواع التحرش الجسدي واللفظي الأخرى التي تعرضت لها وكأن النجاة تعني عدم التعرض للاغتصاب وحسب!
لا أخبر عائلتي بما حصل، كيف يمكن التخلص من رعب النظام وتعرض ابنتكَ لدقائق خطيرة تدعى تفتيشاً أمنياً، لا أخبرهم بالكلمات البذيئة التي سمعتها وعجزي عن مجرد النظر بغضب نحو الجنود، لقد أخذوا منا حتى هذا، لا نجرؤ على الاشمئزاز، فنظرة في غير مكانها قد تعني النهاية. أشعر بالألم لأنني فتاة وأتذكر عبارة أمي حين تود تأكيد صعوبة حياة النساء هنا “همّ البنات للممات”، والتي تعني أن العائلات تظل تحمل همَّ بناتها طيلة عمرها، همومٌ لا تنتهي. هي هموم نرميها على عائلاتنا الخائفة على الدوام من المارة والحواجز والحياة الطبيعية أو التي يجب أن تكون كذلك. كان يجدر القول “همُّ البلاد للممات”، لسنا مذنبات لأننا نساء، الذنب على المكان الذي نعيش فيه، أقول لأمي وأشرح لها حاجتنا لقوانين تحمينا وأفرد لها أمثلة عن بلاد تمتلك فيها النساء حقوقاً لا نحلم حتى بها، فتوافقني لكنها عندما تخاف عليّ في مرة أخرى تكرر: “همّ البنات للممات”.
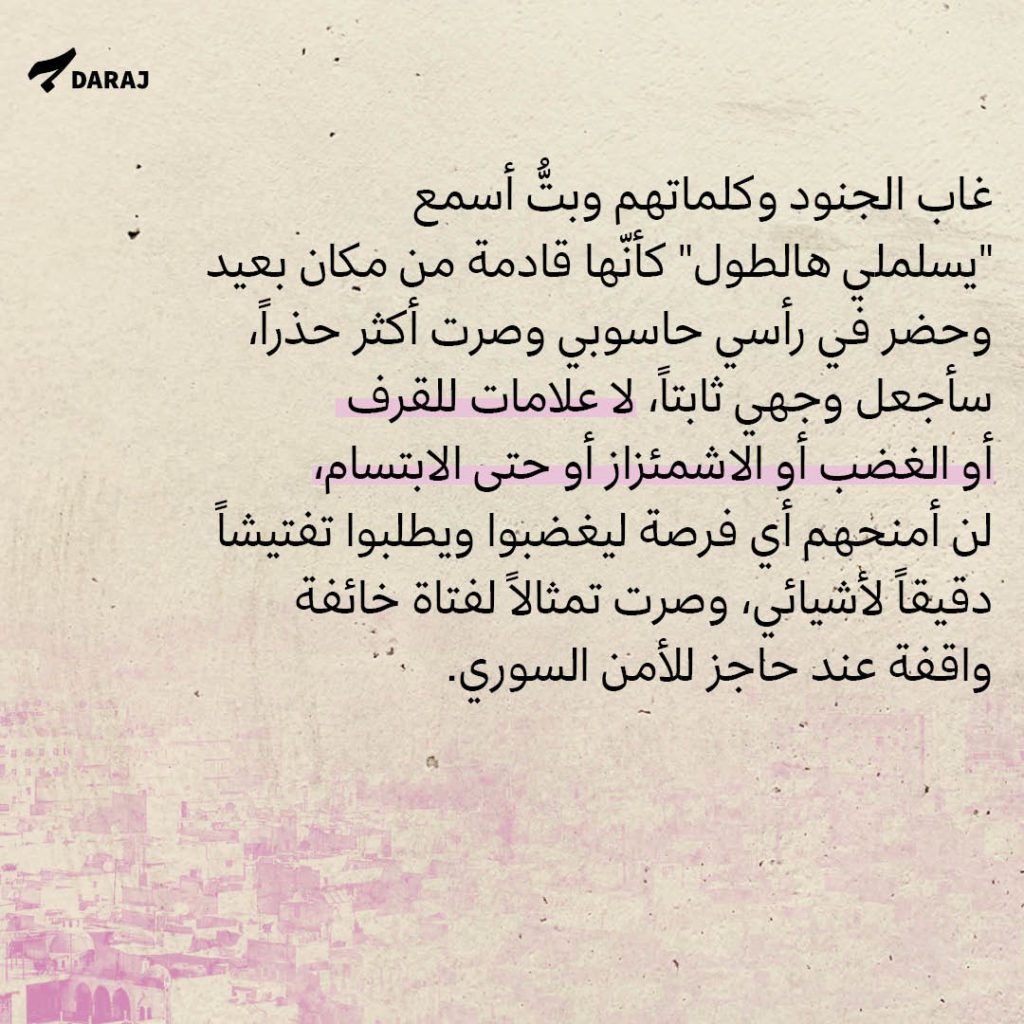
آسفة لأننا نعيش هنا!
حين سمح لنا الحاجز بإكمال طريقنا وبعد بضعة أمتار تنفست مرددة بصوت عالٍ: “خرا عليكن”، كنت أحتاج إلى التنفيس عن غضبي، مواجهة ما حصل بأي طريقةٍ. رمقني السائق في المرآة، لم ينبس بكلمة، بات يشبهني حين كنتُ منذ دقائق تمثالاً خائفاً. لا بد أنه يلعن الساعة التي وافق فيها على إيصالي، شعرت بأنني محاصرة، إنه الشعور الدائم التي تمنحني إياه الحياة هنا، هل أعتذر للرجل العجوز الخائف مثلي فقط لأني فتاة؟ آسفة لأننا نعيش في بلاد نخاف فيه على حياتنا وأجسادنا في كل عمل روتيني كركوب سيارة أجرة أو عبور شارع أو العودة إلى المنزل، آسفة لأننا نمضي نصف أيامنا في الخوف، نفكر بطريقة النجاة من الأمن السوري والرجال الخطيرين وإيجاد سبل الحياة؟
أعود إلى مراقبة الطريق، منازل فارغة، بعضها بلا أسقف وأخرى سقط أحد جدرانها، بعضها تملأه فتحات تركتها القذائف والرصاص. ولإبعاد بشاعة الموقف استذكرت حاجزاً آخر. كنا قد خرجنا ليلاً وكان أحد الجنود، لا يتجاوز الثامنة عشرة، أستطيع تذكر وجهه الطفولي والوبر الخفيف في شاربيه، وحين فتش هوياتنا رفع مصباح اليد الذي يحمله وراح يشعله ويطفئه في وجهي، فأغلق عيني حين يسطع الضوء في وجهي ليبتسم هو، ضحكت معه في ذلك اليوم، إنه ضحية مثلي، سُحِب من طفولته ووضع على حاجز.
أشحت نظري عن مراقبة الأبنية المهدمة ونظرت إلى وجه السائق الحزين، وددت لو قلت له: أعلم أنك لم تستطع مساعدتي أو منعهم من التحرش بي، لا أحد يستطيع مساعدة أحد هنا. كان أثر الإهانة بادياً عليه، أتخيل موقفه، رجل في السبعين، يتحرش رجال الأمن بفتاة ركبت في سيارته. للإهانة أشكال كثيرة هنا، وحين نظر نحوي في المرآة قلت له: “آسفة لأن عايشين هون”، فهزَّ رأسه بأسى، هذا كلّ ما تبادلناه طوال الدقائق العشر، قبل ان أنزل على الجهة الأخرى من المدينة وأمضي يوماً آخر في بلدٍ تدعى سوريا الأسد.
إقرأوا أيضاً:








