باب الشقّة مصفّح، وكأنه باب خزنة مصرف مركزي. لكننا كنا قدّ خططنا قبل يومين للاقتحام. راقبنا العمارة التي تحمل اسم “زهراء الجزيرة” جيداً، والتقطنا الصور هناك. وزاد التحدّي عندما وجدنا قوة أمنية تحرس المكان. عسكريان بالأحرى، أحدهما يقف خلف درع حديدي، والثاني يستلقي على الأرض كأنه يرتاح من ثقل حراسة الزمن. هل كانا مفروزين لحراسة شقة عبد حليم؟ الناطور الذي استدرجناه في الكلام، قبل يومين من موعد الاقتحام، قال إن العسكر موجودون لحراسة سفارة موجودة في المبنى. أي سفارة هذه في مبنى سكني كان يعيش فيه عبد الحليم حافظ؟ لكن الرجل الصعيدي، بثيابه التقليدية (جلّابية وقبعة) تواطأ معنا على تأمين “الاقتحام”.
جنّدناه بعدما أخبرناه أننا تكبّدنا الرحلة من بيروت إلى القاهرة لتنفيذ هذه العملية التي تعني لنا الكثير. قال إنه سيحاول جهده أن يساعدنا على الدخول إلى الشقة التي لا تفتح للعموم إلا في يومين خلال العام: عيد ميلاد العندليب الأسمر، وذكرى وفاته. وفي السنتين الأخيرتين أقفلت جائحة كورونا الشقّة حتى في هذين اليومين. وسيكون صعباً أن يؤمّن لنا ناطور العمار استثناءً يخوّلنا الدخول إلى الشقة. لكنه أعطانا رقمه، وقال: اتصلوا بي غداً، وسأحاول أن ارتّب لكم دخولاً إلى الشقة بعد استئذان صاحبتها، ابن أخت العندليب، التي تسكن في الشقة المقابلة، وتركت جناح عبد حليم على حاله، كما تركه بعد وفاته.
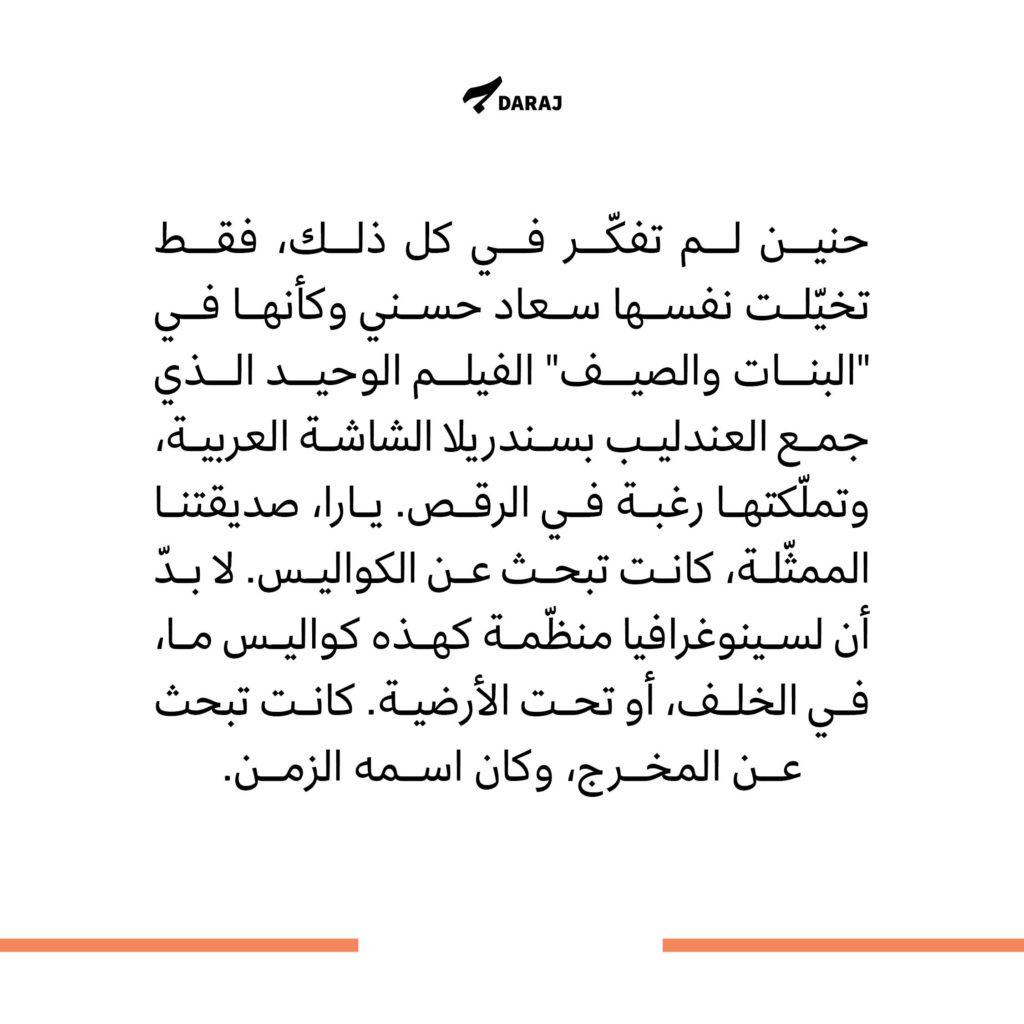
انسحبنا من المكان محمّلين بالخيبة المرّة كشاي أسود ثقيل، أضاف إليه الناطور الصعيدي ملعقة صغيرة من سكّر الأمل. لكن الطعم كان يستحق أن نحتسي كوب الشاي على مهل. وقررنا التمسّك بالملعقة التي تحرّك الأمل، حتى لا يترسّب في القعر، وحتى يذوب كلياً في الخيبة فيخفف من أثرها علينا. كان الانتظار ثقيلاً، لكن القاهرة بسحرها كانت قادرة على تسلية العصابة التي أتت من بيروت لتقتحم شقة حليم. ذهبنا إلى حفل في “معهد الموسيقى العربية” تلك الليلة لأغان من ألحان محمد عبد الوهاب، موسيقاري المفضّل، و”مولانا” كما يحلو لي أن أسمّيه. في قاعة افتتحها الملك فؤاد عام 1923 جلسنا على مقاعد خشبية مطعّمة بالقماش الفاخر. لا يزال المكان يحافظ على الكثير من حالته الأولى. لولا بعض اجهزة الصوت والإضاءة الحديثة، والهواتف الذكية في أيدي الجمهور، لالتبس علينا الأمر ولظننا أننا دخلنا في آلة للانتقال عبر الزمن. 99 عاماً إلى الوراء، وكأن عبد الوهاب نفسه يغني في افتتاح المعهد بحضور الملك فؤاد. وحينما غنّى الشاب الصغير “إمتى الزمان يسمح يا جميل” بصوته الوهّابي، أغمضت عينيّ على دموع مكتومة، وشعرت أنني في حضرة “مولانا”، ثم صفّقت له كما لو انني معجب مراهق يعيش في منتصف الثلاثينات.
كان الخروج من آلة الزمن، والعودة إلى شوارع القاهرة، صعباً بالفعل. الحادية عشرة ما قبل منتصف الليل. نجد مكالمة فائتة من رقم مصري. السكّر في الشاي. أحمل الهاتف وطعم المرارة الممزوجة بالسكر في فمي. في الجانب الآخر صوت الناطور الصعيدي. قال إنه برفقة شخص يمتلك مفتاح الشقة ويستطيع ادخالنا، وإنه يريد أن يتحدث معي عبر الهاتف. أعطاه الجهاز وقال إنه ينتظرنا غداً الأحد أمام بوابة العمارة، وقال إنه يريد أن ندفع له مئة وخمسين جنيهاً عن كل شخص. لم أجادله في السعر، ولا فكّرت في أنها أشبه برشوة، فنحن عصابة وما نريده لا يجب ان يخضع لأي تأنيب ضمير. سوف ندخل الشقّة مهما كلّفنا الأمر.
في اليوم التالي، وبمبلغ قارب الألف جنيه (ستين دولاراً تقريباً)، دخلنا آلة الزمن من جديد، لكن إلى منتصف السبعينات هذه المرة. ركبنا المصعد القديم إلى الطبقة السابعة من المبنى، وهناك عند الباب المصفّح، بدا الأمر أشبه بمعبد. آلاف المعجبين والمعجبات كتبوا ورسموا ووقعوا أسماءهم على كل سنتم في المساحات الاسمنتية المطلية المحيطة بالباب. إلى جوانبه كلها، في الأعلى، وعند باب “الأسانسير”، كلها رسائل تترحّم على حليم وتتمنى له الطمأنينة والسلام، وأخرى تعبّر عن الحب بين أسماء مختلفة استناداً إلى أغنيات مشهورة للعندليب. أحدهم رسم وجه حليم على الحائط بالحبر.
وقفت أتأمله ريثما يُفتح باب الخزنة بعدما قرع الرجل الذي اصطحبنا الباب. انتظرنا في الخارج، ولوهلة شعرت بأن من سيفتح هو حليم نفسه، لابساً روب النوم، وسيستقبلنا بابتسامة متعبة بعدما انهكه المرض، وسيدعونا، رغم تعبه، إلى الدخول لنشرب معه الشاي على الشرفة المطلّة على حديقة الأسماك. لكن سيدة تبدو كأنها خرجت من فيلم سينمائي من الستينات هي التي فتحت الباب. مدبّرة المنزل الشابة، التي يبدو أن الزمن توقف عندها، تماماً كما توقف عند الأثاث واللوحات على الحائط والتلفون القديم والراديو الخشبي العتيق ذي الصوت الضئيل الذي تخرج منه آيات قرآنية. كان كل شيء يوحي بأنه إما مشهد سينمائي مدبّر بعناية، أو أن الزمن سجن في هذه الشقّة وأقفل عليه بإحكام بباب حديدي مصفّح حتى لا يتسرّب إلى الخارج.
صديقنا محمد قال إنه شعر للوهلة الأولى حينما زاغت عيونه في أرجاء شقّة عبدالحليم بأنه يريد الهرب. شعر بأنه محاصر وأن الزمن يمكن أن يسحبه إلى المجهول. تمالك نفسه، ومسحوراً أكمل الجولة.
صديقنا الآخر جاد، الذي تغلّب مرتين على مرض السرطان، تسربت إلى أنفه رائحة المرض، خصوصاً من غرفة نوم حليم، هناك حيث ترك رأسه الذي كان يلقيه أثناء مرضه على ظهر السرير بقعة أبدية. حتى في الحمّام الذي ترك على حاله، تراءى حليم لجاد وهو يعاني بمساعدة أحدهم على الاستحمام بين جولات المرض المرهقة.
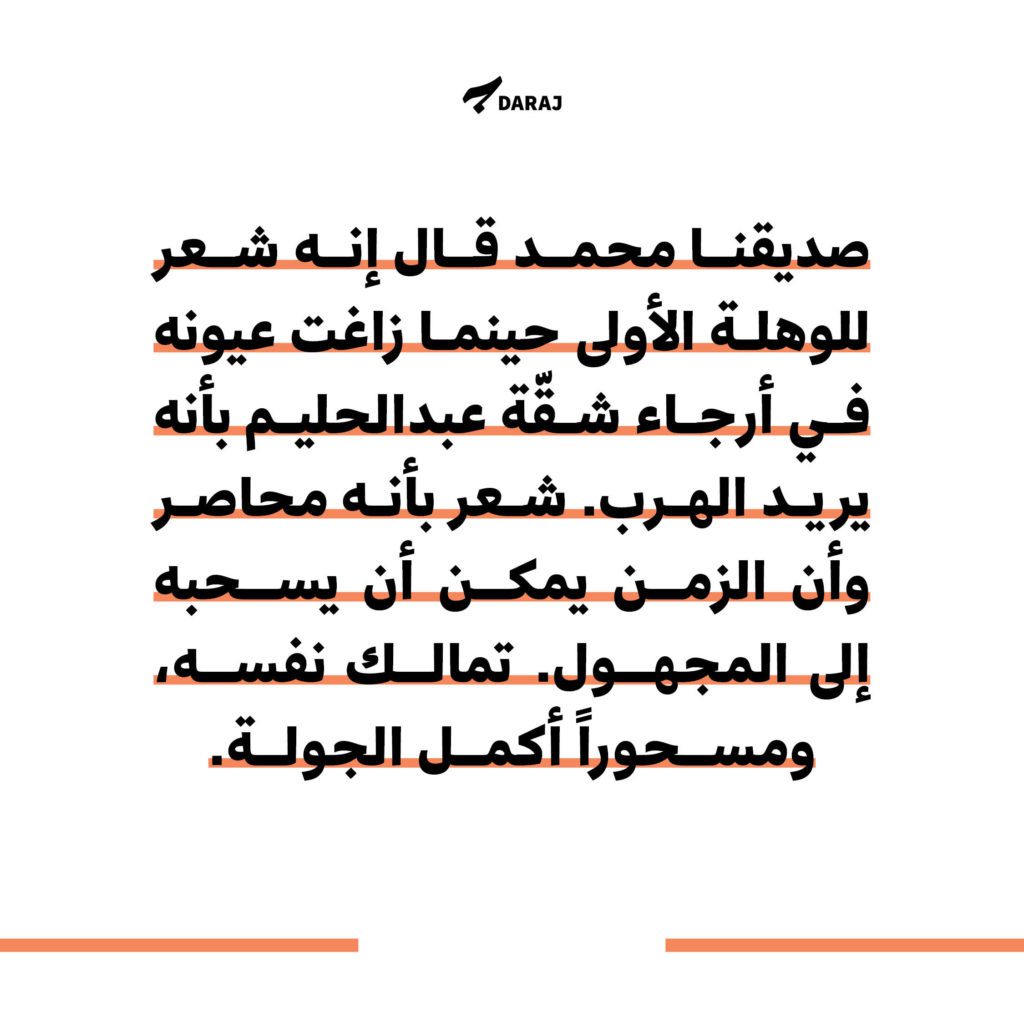
حنين لم تفكّر في كل ذلك، فقط تخيّلت نفسها سعاد حسني وكأنها في “البنات والصيف” الفيلم الوحيد الذي جمع العندليب بسندريلا الشاشة العربية، وتملّكتها رغبة في الرقص. يارا، صديقتنا الممثّلة، كانت تبحث عن الكواليس. لا بدّ أن لسينوغرافيا منظّمة كهذه كواليس ما، في الخلف، أو تحت الأرضية. كانت تبحث عن المخرج، وكان اسمه الزمن.
غادرنا خزنة الزمن المحكمة بالطريقة نفسها. مدبّرة المنزل ودّعتنا عند الباب المصفّح. ثم أقفلت بعدما ركبنا المصعد نزولاً. هبطنا سبع طبقات، لنعود خمسة عقود إلى الأمام. أيار/ مايو 2022، خرجنا من العمارة، كمخمورين أمضوا ليلة يتبادلون الأنخاب. أما أنا، فمنذ دخولنا الشقة، كانت تدور في رأسي مقدّمة “نبتدي منين الحكاية”، بإيقاعها الجنائزي الذي وضعه عبد الوهاب، وكأنه كان يعلم أنها الأغنية الأخيرة التي سيغنيها من ألحانه قبل ان يستسلم لنومه الأبدي. كان اللحن يرافقني وأنا أخرج من العمارة، حتى قاطعه العم صالح، الناطور، وسألنا إذا كنا نريد أن نرى سيارة حليم المتروكة في “جراج” العمارة.
سيارة شيفروليه رمادية “كوبيه” قديمة، يغطيها الغبار، وقد عرف عن حليم امتلاكه الكثير من السيارات، أقربها إلى قلبه كانت مرسيدس 280 مكشوفة حمراء، وفيات 130 فضية موديل 1969 رياضية، وتويوتا سيليكا موديل 1977 امتلكها قبل وفاته بشهور. إطارات الشيفروليه مثقوبة، لكن بابها مفتوح. تدارونا على الركوب في مكان السائق والتقاط الصور. خيّل إليّ عندما جلس محمد خلف المقود، أنه يضغط بأقسى قوته على دواسة البنزين. ربما كان يحاول أيضاً أن يهرب بأقصى سرعة من قسوة الزمن. لكن عبثاً. السيارة لم تتحرك. كان علينا نحن أن نترجّل ونتركها هناك للغبار. ونحن نغادر، استدرت إلى الخلف لألقي نظرة أخيرة على الشقة في الطبقة السابعة من “زهراء الجزيرة”.
كان حليم هناك، على الشرفة، يلوّح لنا بيده مودّعاً…
إقرأوا أيضاً:








