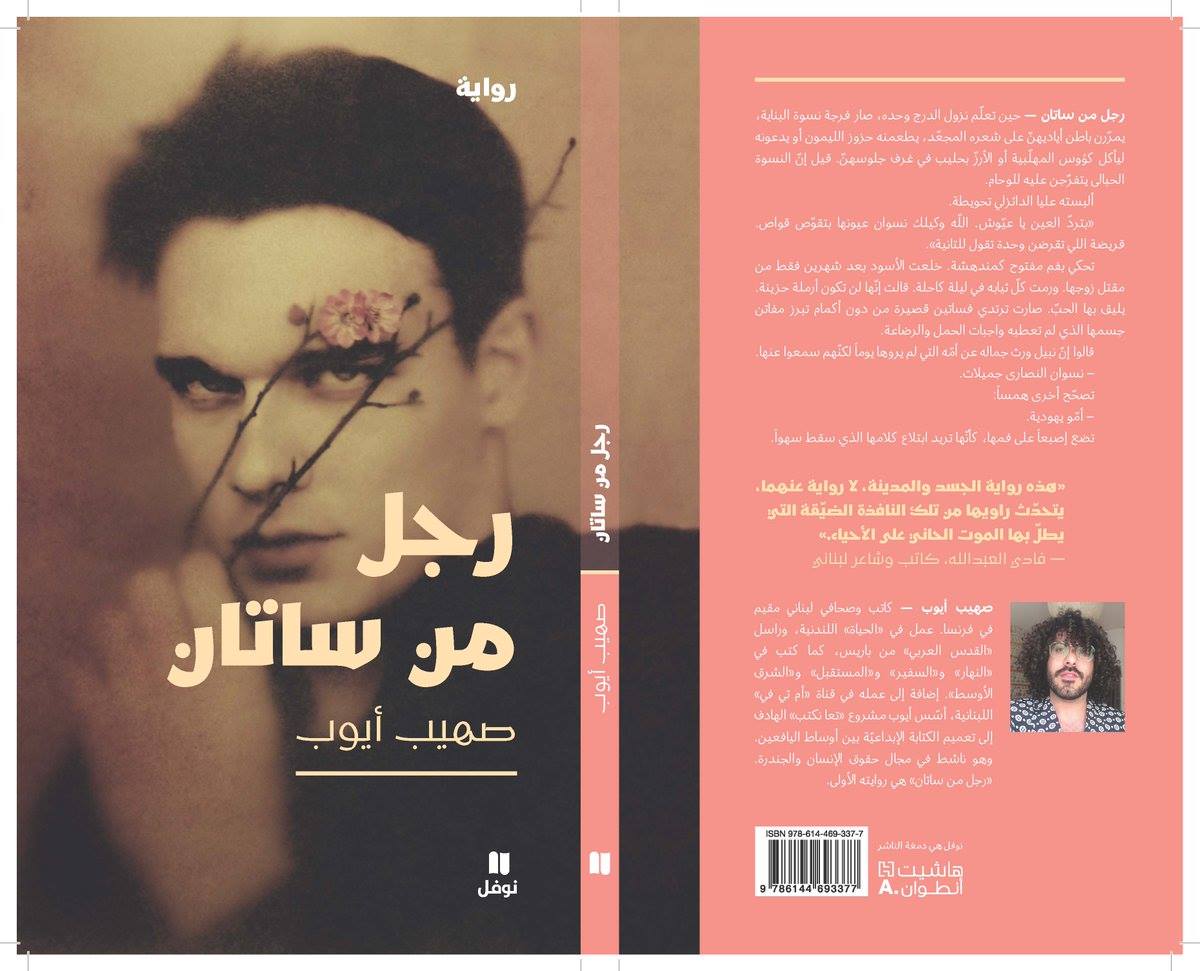
في “رجل من ساتان”، يسمي صهيب أيوب الأشياء بأسمائها ويتركها تتنفس بين صفحات الأحداث ووجوه الشخصيات، بطلاقة وحرية. إنها رواية الجسد والمدينة. لا رواية عنهما. لذا لا ينفصل إيقاع فصولها وجملها، إذا ما دقق القارئ، عن لهاث الشخصيات وتسارع زمن المدينة نفسها، ولا تنفصل تراكيب جملها عن تسلل التجاعيد إلى الوجوه، خصوصاً مع الفصل الأخير. ذلك أن الرواية حين تريد أن تصير البلد (على ما يسمي أهل طرابلس مدينتهم) تمسك خصيتيه، أي البلد، بقوة، تدمي جلود الشخصيات بقسوة وتتحدث من نافذة يطل بها الموت الحاني على الأحياء، نافذة نبيل، الشخصية المحورية في الرواية. فهنا، سوائل الجسد وحدها مداد يروي بهاء المدينة على ما كانته وذبول شهواتها.
لام البعض أيوب على إدماجه معلومات موسوعية عن المدينة وتاريخها، معلومات عن مصارف لم تعد موجودة، أو لوحات على مداخل المباني، أسماء عائلات شبه مندثرة أو مهاجرة. تبدو هذه المعلومات الموسوعية، في ثنايا جملة، أو في ختام مقطع عن لقاء بين شخصيتين مثلاً، وكأنها على تنازع مع سيل الحكاية عن الجدة عيوش والجارة عليا ورجالهما، أو مع الشاعرية القاسية التي تسم معظم الأحيان رواية نبيل، المثليّ القتيل الذي يروي من تلك الفسحة الحكاية بين قتله ودفنه.
راويان؟
لكن هذا التنازع بين البحث الموسوعي والشاعرية القاسية هو، في الحقيقة، تنازع بين الموت والحياة المنخورة به. ليس صحيحاً، في تقديري، ما ظنه البعض أن هنالك راويين في الرواية، الراوي العليم بتاريخ الحكايات التي تدور حول عائلة نبيل الريفية الأصل وحياتها في المدينة في خدمة آل المقدم منافسي آل كرامي على الزعامة والرجال القبضايات، ونبيل الذي يروي أيضاً حكاياته. هل حقاً هنالك اختلاف في الراوي؟ ما أدرانا إن كان الرواي فعلاً عليماً أم هو فقط يخترع أو يردد ما قيل له. ماذا لو كان اختلاف الخط، الذي يميز الانتقال بين الراويين، ليس في الحقيقة إلا خدعة من الكاتب ليوهمنا بأن الرواي تغير، فيما هو في الحقيقة راوٍ وحيد، نبيل الذي بين القتل ومفارقة الروح للجسد يتحدث، عن نفسه وعائلته ومدينته، بعدما شمل الموت كل ذلك شيئاً فشيئاً وصولاً إليه نفسه. فإذا تغاضينا عن أن تعدد الرواة ليس أصلاً عيباً في بناء الروايات الحديثة، يظل أن الرواية، في ظني، تكسب الكثير إذا ما تنبهنا إلى أن الراوي واحد في الحقيقة، وهو نبيل، الذي يروي أحياناً عن نفسه بصيغة الغائب. بهذا، الرواية مكتملة بغض النظر عن احتمال صدور أجزاء أخرى لها. يروي نبيل إذاً الحكايات التي سمعها أو تخيلها، والمدينة التي اختفت من أمام ناظريه إثر عودته من مهجره الفرنسي، والعائلة والجيران وكلهم أموات، أو يروي أحياناً بصيغة المتكلم حكاياته الأكثر خصوصية، مثليته، زواجه وأبوته، علاقته بالأم الغائبة، بالعشاق، بالموت وبمن يكفنه.
في كل رواية، كما في كل فيلم، قبول ضمني لنقطة بداية ما. كما أن لبعض الأبطال قدرات خارقة أو حكايات خاصة، لدينا في هذه الرواية رجل يروي إثر الموت وأثره. وما يدرينا كم تطول تلك البرهة التي يظل فيها الدماغ حياً بعد وفاة سائر الأعضاء، وما أدرانا ما الروح. الرواية تفترض إذاً قدرته على أن يروي. مثل هذا الراوي الذي يروي موته، وأيضاً موت المدينة التي عرفها (ومذهل حكاية كل ذلك في مئة صفحة ونيف فقط)، والتي انقلبت من طرابلس القديمة، بحيوية دفاقة، وصالات سينما ومصارف محلية وكباريهات ووافدين من الجبال والقرى ليندمجوا فيها، من طرابلس القبضايات والزعران إلى طرابلس الميليشيات التي قتلت تنوعها، وصولاً إلى طرابلس ما بعد الحرب المنهكة المتجمدة على فقرٍ وعجزٍ مديدين والتي لا مجال فيها للمختلفين ولا لرافضي إعلانها “قلعة المسلمين”. مدينة ميتة إلى حد عدم الدفاع عن عرض أجمل رواية هي فيها البطلة الحقيقية في معرضها والسماح بسحبها منه، بينما تظل روايات بورنوغرافية كثيرة معروضة من دون مانع. هل أجمل من وصف انتحار العلوي علي خضور حزناً حينما طردته الميليشيات: “فرش فساتين أمه الميتة على سرير والديه. انسلّ بينها كطفلٍ، وأجهش بالبكاء. أخرج بندقية صيد، وأطلق رصاصة في حلقه، ثم نام وسط رائحة أهله”.

تأريخ للموت
كيف يمكن إذاً لنبيل أن يروي ما كانته مدينته بعدما ماتت كينونتها تلك؟ عليه أن يرويها في وصفها تأريخاً لأموات، كأدب الرحلات الذي يذكر كم صنبوراً كان في سبيل مسجدها وكم فرسخاً تبعد قلعتها من الشاطئ، وكم كان فيها من صنوف المتع وأسواق البزازين والصاغة والدباغة. يروي الرحالة عائداً إلى بلده بعد عشرين عاماً، حين لم يعد ما تركه موجوداً، كأنها الصور في فهم رولان بارت: ننظر فنرى ما نعلم أنه ميّت. على نبيل إذاً أن يروي، كلما ذكر اسم شارع، ما كان وصفه وما كان فيه من محلات وتجار، وكم من مصرفٍ كان فيها وكم قاعة سينما، ومن كان منها وزيراً وكيف تزوجت حفيدة مدحت باشا العثماني، وكيف تحول كنيس اليهود فيها وأملاكهم إلى سوق أو مصنع للزجاج، وأسماء عائلاتها ووجهائها وخطاطيها. لذا يقول لنا موت المدينة (بل هو يعلنها صراحة أن طرابلس مقبرة واسعة)، وليس تاريخها في الحقيقة، فالتاريخ يسعى إلى نشر الماضي كأنه أمامنا (بل كأننا مع فرعون بين طعامه وشرابه كما قال أحمد شوقي)، بينما هنا نسعى إلى اللوائح، والتعداد، والذكر السريع لأسماء ومواضع كلها اندثر، لكنه ذكر لا حياة فيه، هو نصب الموت وشاهدة القبر.
كل ذلك ليقول لنا إنها كانت ذات يومٍ، وكانت حيةً. لكنها، كما كل حياة كانت أيضاً منخورة بالموت، لذا كان أيضاً على حضور نبيل أن يتخلل سائر فصول الرواية وليس فقط فصلها الأخير: تفتتح الرواية بمقتل نبيل، وتستمر بقتل أبيه لأحد خصومه، ما يدفعه إلى الفرار وترك المجال مفتوحاً أمام زوجته، عيوش، لتملأ الفراغ وتدافع عن ابنها وتصبح بدورها شخصية محورية في الرواية، ثم نشهد قتل الابن خالد، أي والد نبيل، ويظل نبيل متروكاً لجدته واخته مسعودة وجارته، وهما جانب الحياة مثلما الرجال هم جانب الموت في الرواية. في أثناء ذلك أيضاً، موت رفاق السلاح مطلع عهد الميليشيات بل وموت المدينة نفسها يتركنا أمام ضرورة تثبيت الماضي الذي كانته في لوائح تحاول حصر ما كانت عليه وتعداده. أما موت نبيل نفسه فيتركنا مباشرة في مواجهة الشعر، إذ أي لغة سواه تبقى وتنبع عندما يتيقن المرء من موته؟ لذا ينتقل، حين يتحدث عن نفسه، إلى شاعرية لا تطاق قسوتها، تعجن الحواس بعضها ببعض وتعجن الجملة والكلام ولا تتعفف أبداً. لم قد يتعفف الميت؟ من هنا تأتي التشابيه والاستعارات والشاعرية المختلفة والحادة.
الشعر هنا قاسٍ وجارح، ليس رومنطيقياً ولا ناعماً، على رغم أن الرواية في ذاتها مفعمة بالرومنطيقية والرقة. ولئن وصف حسن داود صاحب هذه الرواية بالجرأة، فما ظني أنه قصد الجرأة على تسمية الأعضاء الجنسية بأسمائها العامية، ولدينا كتب كثيرة قديمة وحديثة تقول ذلك وتصف مشاهد جنسية مطولة فيما لا تتعدى المشاهد الجنسية، وهي تعد على أصابع اليد الواحدة، في رواية صهيب أيوب خمسة أو ستة أسطر على أقصى تقدير في المشهد العذب لغلوريا التي تروض خالد اكومة. بالعكس، في رواية “رجل من ساتان” خفر ورقّة يتجليان حتى عندما يمازح الرجال العجائز بعضهم بعضاً بأقذع الشتائم، هو خفر الحساسية والانكسار في مواجهة الزوجة “كان لها مزاج عكر. تملك عينيّ ذئب. لم أرغب فيها يوماً. كنت أخافها وهي ترمي ثيابها قبل كل مجامعة”، أو الأخت “حين قلت لشقيقتي مسعودة في صغري إنني أريد الموت لم تعلّق. تركتني وحدي أمام كومة من الحجارة. عصفور واحد كان يطير فوق شجرة، ومن بعيد تطلّ مقبرة. حينها عرفت بما يشبه الهمس أنني لست شيئاً يذكر”، أو في مواجهة الذات “أوزع خرابي كبذور حقل لم تطأه قدم”. بل حتى في معابثة الموت “بعدما شرّحوا جثتي لم يجدوا أي شيء عالقاً فيها، لا ذكرياتي ولا طفولتي ولا أسماء من أعرفهم ومن يربكني الجلوس أمامهم. وجدوا فقط أعضاء متوقفة عن العمل”. هو يقول، “كنت أعرف أن الموت يخفي الألم أو يؤجله” لكنه مخاتل ومعابث لا يتورع أيضاً أن يسألنا “هل أكيد أن الجثث تروي الحقيقة؟”. هذا الخفر يحرس الرواية ويسمح لها في الآن عينه، خلافاً لكثير من الروايات المحتفى بها، بألا تتلطى وراء الرموز والأكواد واللغة التي تزدوج لكي تخبئ ما تريد قوله خلف غلالات مزدوجة.
الرغبة المكسورة
هي أيضاً ليست رواية اللذة والمتعة، على ما يستسهل كتاب وكاتبات كثر. بل النقيض، رواية الشهوة والرغبة المكسورة، غير المشبعة أو غير ممكنة الإشباع، إما بسبب الزمن أو المرض أو المسافة أو اختلاف الميول أو الكذب. كل ذلك يمنع الرغبة من الاكتمال، بقسوة عنيفة، لكنها بالضبط القسوة التي تسمح بالحياة وباستمرارها، على ما يرى دولوز معارضاً فوكو في خلافهما الشهير حول اللذة والرغبة. بل لعل في هذه النقطة بالذات ما هو سبب الخوف الأعمق من هذه الرواية، فروايات اللذة والجنس، بما في ذلك الجنس المثلي، سهلة، معروضة في المكتبات ومعارض الكتب بحرية تتفاوت قليلاً من بلد إلى آخر، لكن لا خوف منها على السلطات المحافظة، أما رواية الانكسار والشهوات مستحيلة الإرواء، فتزعزع تلك الثقة التي تقوم عليها مثل هذه السلطات بظنها أنها لا تنكسر ولا تصيبها عنّة ولا عجز.
حسن داود رأى في كتابة صهيب جرأة تاريخية، في تسمية العائلات الطرابلسية المتصارعة (كرامي والمقدم) بصراحة من دون التخفي وراء الأسماء المستعارة، وفي إعلان وجود المثلية في طرابلس تاريخياً (بل واشتهارها بذلك حتى وقت قريب) وفي تناول حياة المثليين لا في وصفها تتمحور حول جنسانيتهم، بل في تناولها وهي تحصل علناً في نسيج مدينتهم وحياتها. فضلاً عن الإشارات إلى حيواتهم المتناثرة وزيجاتهم بنساء وما يحصل في ذلك. لكن ربما أيضاً أراد داود، وهو من هو في حساسيته تجاه اللغة، الإشارة إلى جرأة صهيب على اللغة والتشابيه وعلى الشعر وادماجه في صلب الرواية. فمن “تراسل الحواس” ومن الحساسية الفائضة تجاه القسوة ومن تحدي اللغة، يستخرج الشعر وتولد جمل كمثل “أستمني على مضض كأنني أقضم ظهر سلحفاة أو أضع اسفنجة ناشفة في شرجي”، أو ” شعور تحرك بطيئاً وبتصميم كأفعى تمط جسمها الثقيل في أمعائه”. ومنه تتركب مقاطع مثل: “لم أكن أملك طوال عمري الجرأة كي أقول إنني بائس وإنني اختبرت حياة بشعة، حياة ممسوكة بلا أيد. منهوبة لهواء طليق، ولفراغ لم أستطع إنهاءه” أو “لم أستطع ذرف دمعة واحدة، أحسست بنقمة دفينة. تمنيت لو خرجت إليهم بفستاني ورقصت”.
ربما أراد صهيب أيوب أن يكتب رواية تحتل فيها طرابلس، المكان، مركز الصدارة والبطولة، غير أن الرواية إن ناجحةً تتجاوز مقاصد صاحبها. فالواقع أنها رواية المقتلعين من الأمكنة، الآتين من أمكنة أخرى (عكار، سوريا)، المهاجرين (إلى فرنسا)، المنفيين الهاربين أو المغادرين (سوريا أو فرنسا أو بيروت). هي لحظة التقاطع ما بين اقتلاعاتهم الكثيرة وعودتهم. ولأن المدينة هي، كما لهجاتهم الثقيلة وهوياتهم، لحظة تقاطع المسارات هذه كلها هم (العكارية الطرابلسية، أكومي المرافق للمقدم، غلوريا الحية والمتوفاة في ظن ابنها واليهودية الطرابلسية التي تحلم بالغناء في مصر… الخ)، فإننا لا نعرف تقريباً أي شيء عنهم خارجها. لا يقول نبيل الكثير عن إقامته الطويلة جداً في فرنسا (صفحة تختزل 15 عاماً وحباً وانتحاراً)، ولا نعرف شيئاً عن حياة علي أكومة السورية، والإشارة إلى حياة ليلية في بيروت لا تتجاوز سطراً يعود بعدها ابن نبيل إلى شقة والده في طرابلس… إلخ. مسارات الاقتلاع والتقاطع هذه، ترسم صورة غير مسبوقةٍ وبالغة الاختلاف عن المكان الذي يحضنها، أي طرابلس، صورة لا تستنفدها حكايات العائلات العريقة ولا الأمكنة الأصيلة في قلب المدينة، صورة لها من زاوية نظر عائلات نازحة إلى مناطق الهوامش الفقيرة على أطراف المدينة كباب الذهب (باب التبانة)، ومنها يمكن أن يرى المرء العمق التاريخي للمدينة كحاضنة للتغيرات الكثيرة، أي للنزوح والفرار والموت والحياة، والشعر والتاريخ والحب والشهوات الزائلة، لا في وصفها امتداداً لعراقةٍ متجمدة في الماضي قد يأمل أحدهم بنشرها في المستقبل ليتعفّن بدوره.
للغة مشدودة الإيقاع، للشعر، للجرأة على اللغة والشعر وتصورات المدينة، لطبقات المكان الذي تسبره، لتركيب بنيتها وشخصياتها العابثة حتى بسؤال الموت، لكل هذا هي رواية مخيفة حقاً كما هي حال الجمال الحقيقي.







