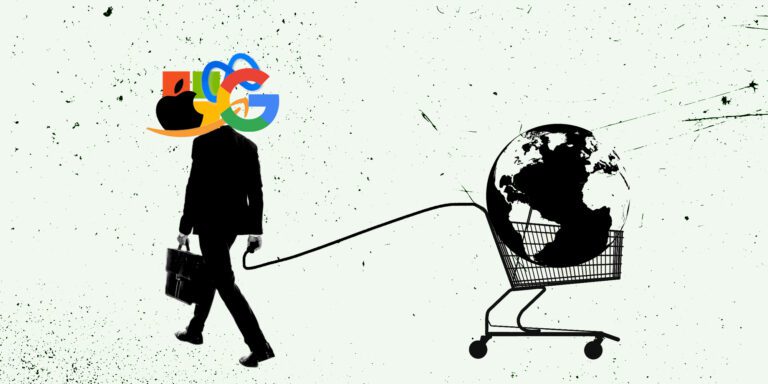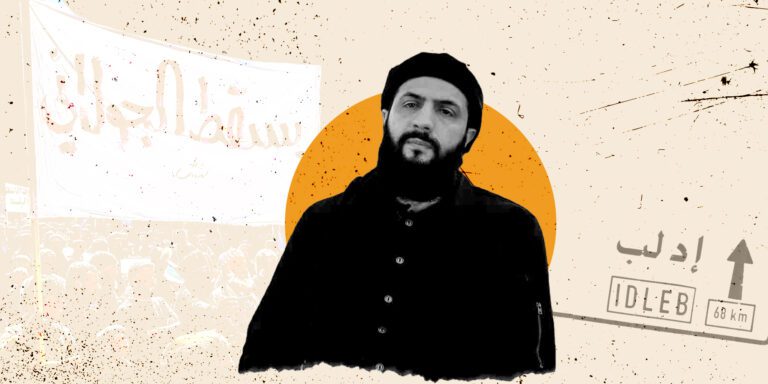ثمة قول شائع لشاعر ألمانيا غوته، ضبابيّ المصدر، اختاره الروائي السويدي جوستاين غاردر ليفتتح به روايته “حول تاريخ الفلسفة” التي طافت حول العالم، “عالم صوفي”. إذ نقرأ: “الذي لا يعرف أن يتعلّم دروس الثلاثة آلاف سنة الأخيرة” يبقى في العتمة”.
ينسحب قول غوته من زمنه ومن رواية غاردر إلى صالة سينما سيتي في دمشق أثناء عرض فيلم “أوبنهايمر” لكريستوفر نولان، ينسحب من كونه تقريراً ليصير سؤالاً: “هل تعلمنا الدروس؟”. لا دروس الثلاثة آلاف سنة الأخيرة، بالتأكيد، فذلك صعب ومستحيل تقريباً،. لكن، هل تعلّمنا على الأقل دروس الاثنتي عشرة سنة الفائتة في التجربة أو الكارثة السوريّة؟ فعلٌ واحد، جمعيٌّ تقريباً في صالة السينما، أثناء مشاهدة الفيلم، وبعد مشهدٍ مفصليٍّ ومرعب منه، يقول إننا لم نتعلّم. ما يعني أننا لن نتعلّم من فيلم “أوبنهايمر” نفسه، كتبرئة أخلاقية مُقدَّمة لإنسانٍ شائك، معقّد، تاريخياً وإنسانياً وضميرياً ومصيرياً.
في مشهد انفجار القنبلة من الفيلم (لنسمّيه كذلك)، يبدأ عدٌّ تنازلي من العشرة، حتّى يحدث الانفجار الذي يعرف المتفرّجون (المتلقّون) وصنّاع الفيلم الكارثة التي تبعته. يبدأ عدٌّ تنازلي يشبه الطقس الاحتفاليّ في رأس السنة، احتفالاً بعامٍ جديد.
بدأ الناس المجتمعون في صالة السينما الدمشقيّة بالعدِّ معه، بما يشبه الاحتفال أيضاً، وحين تنفجر القنبلة (التي، مرّة أخرى، يعرف المتفرّجون (المتلقّون) وصنّاع الفيلم الكارثة التي تبعتها)، يصفّق الناس. لم يصفّقوا كلهم، كي نتحرّى الدقة، لكنّ جزءاً كبيراً منهم، من الصالة التي تتّسع عدداً هائلاً، احتفلوا بالعدِّ التنازليّ وصفّقوا عند انفجار القنبلة. لا في يومٍ واحد من أيام عرض الفيلم، إنما على مدى الأيام كلّها، تقريباً. (سألت متفرّجين على مدى عرض أيّام الفيلم ما إذا حصل هذا الأمر أو تكرّر، مثلما حدث عند مشاهدته الفيلم، فأكدوا: نعم، احتفل الناس وصفّقوا).

لا يناقش هذا المقال الفيلم ولا يعقد مقارنة بينه وبين كتاب السيرة الذاتية المأخوذ عنه “برومثيوس الأميركي، انتصار ومأساة ج. روبرت أوبنهايمر” (حاز جائزة بوليتزر للسيرة الذاتية 2006) لكاتبيه كاي بيرد ومارتن ج. شيروين، إنما يناقش فعل التصفيق نفسه، في صالة سينما في دمشق، فعل التصفيق الذي يصدر بعد كارثة هائلة.
ليصوِّر نولان مشهد تجريب القنبلة، اعتمد على تفجير قنبلة صغيرة الحجم من قبل فريق العمل، وتمّ تصويرها بطريقة Forced perspective، التي تُضخِّم من حجم الأشياء الصغيرة على الشاشة. اعتماد تقنية التصوير هذه قد يوحي بالفعل بأنّ ما يودُّ صنّاع الفيلم طرحه هنا بعيدٌ من الكارثة التي تبعت الفعل نفسه، وبأنّ الرؤية (الرؤيا) للفعل الكارثيّ هي رؤيا ضيّقة، تركّز على صانع الفعل وتحاول تبرئته أمام الضمير الإنسانيّ، بإغماض العين عن النتيجة المهوّلة التي تبعت ذلك.
وُلد عصر جديد بعد تجريب القنبلة، أطلق عليه ويليام لورانس، مراسل “نيويورك تايمز” وقتها، “أولى صرخات عالم وليد”. واسترجع برومثيوس الأميركي أوبنهايمر وقتها، أيضاً، شطراً من نص “بهاجافادا جبتا” الهندوسي المقدس يقول: “علمنا أنّ العالم لم يعد كما كان سابقاً. بعض الناس ضحكوا، وآخرين بكوا، وبقيت الغالبية صامة”. ثمّ يضيف: “أنا أصبحتُ الموت/ مُدمِّر العالم”، ويتابع: “أعتقد أننا جميعاً فكرنا بذلك بطريقة أو بأخرى”.
في فيلم “هيروشيما عشقي” لآلان رينيه المأخوذ عن سيناريو الفرنسية مارغريت دوراس، ثمة لازمة تتكرّر في منتصف الفيلم، بين الممثلة الفرنسية وعشيقها الياباني، على هذا النحو. تقول الممثلة: “رأيت كل شيء في هيروشيما”. يردّ الياباني: “لا لم تري شيئاً في هيروشيما”. تقول: “رأيت المستشفى في هيروشيما”. ويعاود الشاب ردّه: “لا لم تري شيئاً في هيروشيما”. ذلك بعدما قالت قبل ذلك “رأيت الجرحى والناجين، رأيتهم يرمون الطعام في كل المدن، كل مولود جديد يأتي معوقاً. رأيت في هيروشيما الصبر والمعاناة، حتى المطر أصبح مخيفاً، مدن بأكملها حزينة ضد الفوارق بين الشعوب، يمكنني أن أنسى مثلك كل هذا الرعب، لماذا الإنكار أمام 200000 قتيل و80 ألف مصاب، مدينة بكاملها تنهار في ثانية واحدة”.
إقرأوا أيضاً:
على رغم هول الرؤية هذه، يُصرُّ الشاب الياباني (القح) المُجرِّب والعارف والمتضرّر من الكارثة: “لا لم تري شيئاً في هيروشيما”. يبدو أنّ نولان كذلك لم يرَ شيئاً في هيروشيما، بل لم يشأ أن يرى شيئاً في هيروشيما، إلى حدِّ أنّ فيلمه كلّه لم يتطرّق إلى اليابان إلّا عبر الحوار، حتّى اختيار المنطقة التي سيتمّ إلقاء القنبلة عليها هناك، يأخذ بعداً غروتسكياً، ما جعل الجمهور في صالة السينما في دمشق “يضحك” بعده.
يضحك الجمهور حول كيفيّة اختيار المنطقة التي سيتمّ نسفها. وكأنّ دروس الاثنتي عشرة سنة السوريّة الأخيرة لم تكن أبداً، وكأنّ اختيار منطقة ما، مثل الذي يحدث في فيلم نولان، لم يكن أبداً، كأنّ الكارثة لم تكن أبداً، ولم يكن ثمة شيء.
نظريّات التلقّي في السينما، ومن قبلها في الأدب، على اتّساعها وكثرتها واختلافاتها، يمكن القول إنها تركّز أو تعنى بالفهم كعمليّة وظيفيّة، حيث يصبح الفهم (لما نراه في الحالة هذه) عمليّة بناء المعنى وإنتاجه، من دون مراقبة سلبية.
المراقبة السلبية، أثناء التفرّج على أوبنهايمر، هي التي كانت سائدة، إلى حدِّ أنها لم تكتف بالوقوف على الحياد، إنما بالمشاركة في الفعل نفسه والتعليق عليه: العدّ من عشرة حتى واحد، التصفيق بعد القنبلة، الضحك عند اختيار منطقة مأهولة من اليابان لنسفها من الجغرافيا. إذاً، فالمراقبة السلبية تدخل في فيلم نولان نفسه، وتتّصل بما سلف ذكره في أنّ نولان أغمض عينيه عمّا حدث، وركّز على تبرئة الفاعل، في محاكمة ضميريّة (قد تكون مأخوذة من كتاب السيرة عن برومثيوس أو لا) ظلّت حاضرة طوال الفيلم. إغماضة العينين هذه، أو “عدم رؤية شيء من هيروشيما”، وناكازاغي كذلك، هي التي تجعل الفيلم يأكل مشاعر التعاطف لدى المتلقّين.
إقرأوا أيضاً:
ينفي روجر إيبرت الاعتقاد الشائع بأنه لا يمكن لغير المتخصصين التعليق على الأفلام أو مناقشتها، وهو ما عزّزته الميديا أيضاً في الآونة الأخيرة عبر إخماد أو إسكات أصوات “غير المتخصصين”. ويذهب إلى أنّ كل شخص يمكنه أن يقرأ الفيلم ويناقشه ويتبنّى وجهة نظر خاصة حوله، وسيجد الكثير لقوله إذا انتبه جيداً إلى الصورة المعروضة أمامه. لأنه لا وجود للمصادفات في تصوير الفيلم، إذ يعمل كل مخرج بدقة بالغة لكي تعبّر كل صورة وكل حركة وكل صوت عن شيءٍ ما يودّ قوله.
“الآن أصبحتُ الموت، مُدمِّر العوالم”، هو الاقتباس الملتصق بأوبنهايمر، لكنْ ثمة شيء آخر قاله من النص المقدس نفسه هو: “إذا ما انفجر في السماءِ شعاعُ ألف شمسٍ في آن، فمثل ذلك كمثل الربِّ في عظمته”. يقول سلافوي جيجك عن ذلك في مقالة نشرها أخيراً في مجلَّة “ذا نيو ستيتمان”: “هكذا نرى كيف يرتقي الانفجار النوويّ إلى مرتبة التجربة الإلهيَّة. لا عجب إذاً، بعد نجاح الانفجار النوويّ، أن يظهر “أوبنهايمر” بصورة المنتصر كما وصفها عالم الفيزياء “إزيدور رابي” بالقول: “لن أنسى مشيتَه ما حييت؛ لن أنسى كيف ترجَّل من السيَّارة… كيف تبختر مثل بطل فيلم هاي نون-High noon. لقد بلغ مُراده”.
أما التعليق الصادق تماماً عقب تجريب القنبلة كان لمدير الموقع كينيث برينبريدج الذي قال لأوبنهايمر: “أوبي، الآن صرنا جميعاً أبناء عاهرات”. وهو ما قاله الرئيس الأميركي ترومان بعد ذلك طارداً أوبنهايمر من مكتبه، إذ قال لمساعده: “لا أريد رؤية ابن العاهرة هذا في مكتبي ثانية”.
رمز مأساة العالم النووي الحديث، أوبنهايمر، وفقاً ليوكاوا هيديكي الياباني الحائز جائزة نوبل في الفيزياء، هو نفسه البطل الأخلاقيّ الذي يعاني من وخزٍ ضميريّ في فيلم نولان بعد تجربته النووية.
وهو نفسه الذي صفّق جمعٌ من الناس في دمشق لنجاح تجربته في تدمير جزءٍ من العالم والإنسان، وبعض أولئك الذين صفّقوا للتدمير هم أنفسهم الذين قالوا بعد المشهد الجنسيّ في الفيلم: “كش بدني”.
علماً أنّ سينما سيتي كانت قد غبّشت الأجساد البشرية في هذا المشهد الخادش للحياء العام والأخلاق، وجعلتها بتقنية cgi، حفاظاً على مشاعر المتلقّين.
يُحيل ما سبق إلى كمٍّ مرعب من التناقضات في هذه المدينة التي اسمها دمشق، والتي يبدو أنّ دروس اثنتي عشرة سنة فيها عصيّة على التعلّم، وأنّ الجملة في “هيروشيما عشقي” التي تقول “كي لا تتكرّر هيروشيما”، وهو عنوان الفيلم العالمي الداعي للسلام الذي تصوّره الممثلة الفرنسية في فيلم رينيه، تبدو ضرباً من عبث وجنون اليوم، مثلها مثل “كي لا يتكرّر ما حدث في دمشق”.