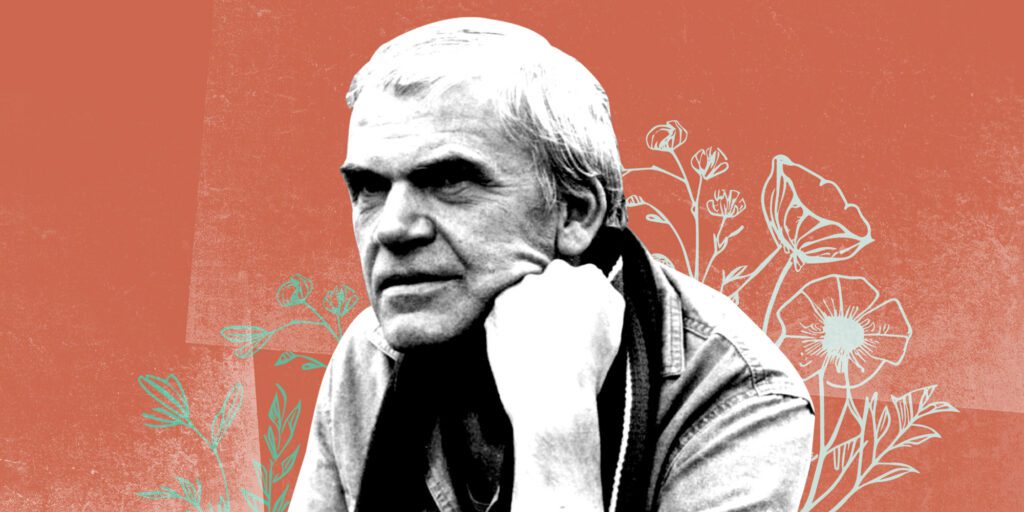انتشرت في إسرائيل عام 2009 فانلة “كوميديّة”، أثارت فضيحة أشعلتها صحيفة هآرتس، لا بسبب كمية الصورة النمطيّة التي تحويها، بل كونها تصوّر امرأة فلسطينية حاملاً مع علامة قنّاص على بطنها، تحتها جملة “طلقة واحدة وهدفان”. أدان الجيش الإسرائيلي ارتداء الخريجين من الدورات التدريبيّة هذه الفانلة، بوصفها “لا تمثل قِيمه”.
العلاقة بين الضحك وحياة الطفل وموته وطيدة، علماً ألا تاريخ مُحدد لبداية النوع الأدبي الشعبي المُسمى بـ”نكات الأطفال الموتى”، لكن يمكن تلمّس جذوره في الديانات الإبراهيميّة. مثلاً، اسحق بن يعقوب، اسمه مُشتق من “اضحك” أو “ذاك الذي ضحك “، والسبب أن سارة والدته ضحكتْ حين علمت بحملها به، إذ لم تصدق أنها قد تنجب بعد عُتيِّ العمر. الحكاية التوراتيّة ذُكرت في القرآن لاحقاً، “وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ”.
الضحك في سياق الطفل الميت يخلقُ نوعاً من الترويع، أي زوال العقل أو تهديد تماسكه الرمزيّ، إذ لا يمكن أن نصدق أن أحدهم قد يقتل طفلاً، أو يضعه في شرط لا يمكنه النجاة فيه، مع ذلك النكتة قائمة. وهذا بالضبط ما حصل في أحد اجتماعات الـZoom في فرنسا، إذ ألقى فيه المجتمعون من مؤيدي إسرائيل نكاتاً عن الأطفال الموتى في غزّة : “لماذا لا يوجد الكثير من المدارس في قطاع غزة؟ لأننا قتلنا كل الأطفال-ضحك-“. دعا المعلّقون السلطات الفرنسيّة الى التدخل، لكن لا يمكن إدانة نكتة، حتى لو كانت مُريعة، إلا في حالة معاداة الساميّة كما حصل مع الكوميديّ الفرنسي ديودونة.
نكات الأطفال الموتى تأخذ شكلاً جديداً في زمننا هذا، بل يمكن القول، إن الطفل السوري والآن الفلسطيني، لكثرة موته، بات فاتحةً لشكل جديد من النكات التي تهدد تماسكنا العقلي كأشخاص، نحمل داخلنا احتمالات ذُرية، مُهددة بأن تتلاشى تحت وطأة القصف، أو السلاح الكيماويّ أو التجويع. هنا بدقة يأتي التعريف الكلاسيكي للنكتة، هي تهديد لتكوين العالم الرمزي، وضربة قد تتسبب بانهياره. يمكن القول إن السنوات العشرين الماضية أغنت أرشيف صور الأطفال الموتى بأسلوب لم نشهده سابقاً، إلى حد إمكان استخدام الطفل الميت كوحدة قياس!
الطفل الميت علامة على عُمرٍ لم يمتدّ في الزمن، يختزن “كلّ” الاحتمالات، قتلهُ يضرب الحس الإنساني لا بوصفه فرداً، بل حياةً نمتلك “طبيعيّاً” الرغبة في الحفاظ على استمرارها، ناهيك بأنه لم يأخذ بعد دوراً سياسياً، إذ لا ذاكرة لطفل ميت، ولا “خبرة” لنتقاسمها معه، وموته يقتل جزءاً منّا.

براغماتيّة الأطفال الموتى
المفارقة أن قتل طفل على فداحته، تحوّل إلى معضلة أخلاقية، باسم “قتل هتلر الرضيع”، التي طرحتها للعلن عام 2015 مجلة “نيويورك تايمز”، والتي سألت قراءها في استطلاع رأي التالي، “إن عدت في الزمن فهل ستقتل هتلر الرضيع؟”. نسبة الإجابات في الرسم البياني أدناه، لكن المفارقة أن المعضلة ذاتها قائمة على أساس قتل طفل رضيع، الإشكاليّة الساخرة، أن بين شابيرو، اليميني الأميركي الذي يبرر قتل الأطفال في فلسطين الآن ، أجاب عنها بـ”لا”، يجب عدم قتل هتلر الرضيع.
الأسس الأخلاقية للمعضلة واضحة، قتل طفل عديم القدرة على الاستسلام أو الدفاع عن نفسه أو تحديد موقفه السياسي أو حتى التضحية بنفسه في سبيل “الخير”، شأن غير مقبول، حتى لو على حساب ملايين اليهود، إن فسرنا رأي شبيرو. لكن المريع، أن طفلاً هو محط المعضلة، الاختبار هنا يتجاوز السياسيّ إذاً نحو الإنساني، ومقدار البراغماتية التي يمكننا كبشر أن ننتهجها لأجل “الخير”، الذي قد يصل بنا إلى شرط نسائل فيه إمكان قتل طفل لا دور له حتى بولادته.
طبعاً، لا معنى لهذه المعضلة حالياً، لا فقط بسبب الجرائم في غزة وضحاياها من الأطفال، بل قبلها في سوريا، واليمن، والعراق، أي قتل الأطفال الموثّق، فارتفاع عدد الأطفال الضحايا ليس محطّ “معضلة أخلاقيّة”، إذ لم يعد الأمر سوى استنزاف للمشاعر، وعلامة على نوع شديد الغرابة من العدميّة، كأن يقول أحد “الممانعين” في لبنان، أن موت الأطفال في غزة ليس مشكلة كبيرة، إذ سيتم تعويضهم، فهناك 50 ألف امرأة حامل! هي نكتة مريعة بالفعل، لكن لسنا هنا لنسأل عن العنف، أو من يقتل من، نحن نبحث عن النكتة.
“الأطفال يُقتلون… للأسف”
يصيبنا الجسد الميت بالعدوى بسبب ضعفه المُفرط، منظره المُدمى وجروحه التي تنشأ عن انتهاكه، تكشف هشاشة الجسد الإنساني بشكل عام، كونه يحمل الطراوة ذاتها التي تتمتع بها أبداننا لكن بصورة أوضح، صورة الطفل الميت هي علامة على عجزنا أمام الحديد والإسمنت. كما تشير إلى احتمالات موتنا حين نتفتت ونتفكك إلى أشلاء ونكشف دواخلنا.
المفارقة أن الأساطير تقول إن دم الأطفال هو إكسير الحياة والشباب الدائم، أي هزيمة الزمن البيولوجي الذي يفنينا من دون إرادة، بل إن نظريات مؤامرة حاليّة تقول إن المشاهير يشربون دم الأطفال. وهنا النكتة المرعبة، فعلى رغم كل ما يحيط بحياة الأطفال من تحذيرات وتهديد للقيم الإنسانيّة، قتل الأطفال “تقليد” مُستمر لترسيخ السلطة، واستمرارها في الزمن، إذ تقال الآن بوضوح أثناء الحرب على غزة: “الحرب مُريعة، وهناك دوماً ضحايا، وللأسف جزء منهم أطفال”.
السلطة بصورة ما إذاً، أي سلطة كانت، لا تستمر إلا بعد قتل عدد معين من الأطفال!، ولن نخوض في نظام الأضاحي وعلاقته مع السياسي (رينية جيرارد) ، لكن ماكينة الحرب حولت أشهر المعضلات الأخلاقيّة إلى نكتة، إذ لم يعد المعيار بين “الخير” و”الشر” احتمال قتل طفل واحد، بل الكثير منهم “للأسف!”.
تاريخ شديد الاختصار للحداثة… قطارات وأطفال
أحد تنويعات معضلة هتلر، ما يسمى “معضلة القطار” التي ظهرت سابقاً في الستينات، ضمن الجدل الأخلاقي حول الإجهاض، في واحدة من النسخ، نقرأ أن قطاراً يسير نحو مفترق طرق، الأول يحوي طفلاً في عربة، والثاني 40 شخصاً، ونحن نمتلك الخيار، هل نوجه القطار نحو الطفل لإنقاذ الأربعين أو الطفل، كون موت أحدهما محتّماً؟
لا يهمنا حقيقة إجابة المعضلة وأبعادها المتعددة، بل الوضع الذي يجد فيه أحدهم نفسه مضطراً للاختيار بين طفل وأربعين شخصاً، مع ذلك نحن لا نبحث عن الأخلاق، بل القهقهة، وسلسلة الأحداث التي وجد فيها أحدهم نفسه أمام ماكينة من حديد تسير بسرعة 230 كم في الساعة.
معضلة كهذه هي نتاج الحداثة بمعناها العام المجرد، انتصار الآلة وغياب قيمة الإنسان، فالقطار، علامة على الهيمنة فوق التراب والانتقال بسرعة. هو جزء من ماكينة القتل الحداثويّة التي وصلت أوجها مع الهولوكوست، حيث حُمّل اليهود في القطارات نحو مصيرهم. لكن صورة القطار ترتبط بشدة مع تاريخ السينما، وهنا يمكن قراءة المعضلة الأخلاقية بصورة مختلفة، “الشر” و”الخير” معادلة قائمة على موت طفل لإنقاذ الدولة الحديثة وماكيناتها، أمام عدسة الكاميرا.
هي مصادفة شديدة الغرابة التي قادت إلى المعادلة السابقة، إذ ظهر القطار(حسب أسطورة تاريخ السينما) في أوّل صورة متحركة التقطها الأخوان لوميير، اللذان أيضاً سجّلا فيديو لأطفال في عربة عام 1896، أي يمكن القول إن مكونات العالم الحديث ضمن تاريخ الصورة المتحركة، هي القطار، وأطفال في عربة، والكاميرا التي توثق “الخير” و”الشرّ”.
إقرأوا أيضاً:
مفارقة الحجم والطراوة: كيف تلتقط صورة طفل ميت؟
صور الموتى أو ما يُسمى Memento mori، ترافقت بشكلها الحديث مع ظهور الفوتوغرافيا، هذا النوع الفنيّ يثير القشعريرة، خصوصاً أنه يحوي الكثير من الأطفال والرُضع الذين فارقوا الحياة ثم زُينوا لالتقاط صورة. هذا الفنّ المُريع أخذ أشكالاً أشد إخبارية الآن، لكنه ما زال يحوي عناصر فنيّة تتضح حين ندقق في الـ Mise en scene للأطفال الموتى أو من هم على وشك الموت، إذ يُصفون كرتل أو كبساط أمام الصورة، أو يرتبون داخل الحضّانة في مستشفى الشفاء في غّزة تحت تهديد القصف.
هناك سحر من نوع ما في وضعية الطفل الميت أمام عدسة الكاميرا، الطفل السوري إيلان خضع للأمر ذاته، الجسد الهش والغضَ غير مكتمل التكوين والذي لا يمتلك فرصة لمواجهة الغرق أو الدبابة أو القصف، مُروع، والتي تعني هنا، الثبات والشلل، وربما العجز عن الفعل لإنقاذ طفل على وشك الموت.
الخطاب السياسي يكسب الطفل خصائص جديدة، هو احتمال “إرهابيّ” ودرع بشريّ حسب البروباغندا الإسرائيليّة، وهنا مفارقة، قدرة هذا الدرع على الصدّ ليست في صلابته أو غضاضته، بل في عين من يستهدفه، والذي من المفترض أن يرى نفسه أمام سؤال، أيمكن قتل طفل؟
التجربة تركتنا أمام إجابة واضحة، نعم يُمكن قتل طفل، لكن النكتة ألقيت في أحد شوارع لندن حين سأل مؤثر في تظاهرة في لندن طفلاً يحمل علم فلسطين “منذ متى وأنت درع بشريّ لحماس؟”، يجيب والده “5 سنوات”، وهو عمر الطفل.
“إخراج” صورة الطفل الميت واستعراض الجسد الخديج ، يكشفان عن عناصر تثير الفزع، حجم الرضيع نفسه هو ما يأسر عين الناظر ويهزّ كيانه، كادر اللقطة التقليديّة يتسع لأطفال أكثر مما يتسع للبالغين، سواء تحدثنا عن طفل ميت واحد أو هرم من أطفال. ناهيك بالتناقض في صلابة الكتل، جسد الرضيع الغضّ بين الركام مثلاً يتناقض في طراوته مع سطوة الحجارة والحديد.
أخذ التناقض السابق بالاعتبار يحول النصائح التي تقدمها شركة “كانون” لالتقاط صور الأطفال إلى شأن يخلق في الجلد قشعريرة ،كأن نقرأ “صوّر على مستوى العين” أو “استخدم الضوء الطبيعيّ”، “صور فيديو لعدم قدرة الطفل على الثبات”، واللافت أن هذه النصائح لا تنطبق على فن صور الأطفال الموتى في القرن التاسع عشر، والسبب أو النكتة: “من السهل التقاط صورة طفل ميت، كون الحيّ كثير الحركة والتلويح بيديه”.
الطفل الميت كوحدة قياس
الغريب، وهنا النكتة شديدة الشناعة، أن الطفل الميت يُستخدم كواحدة قياس منفصلة، طفل في معضلة أخلاقية، طفل مقابل ماكينة حرق أشخاص، 4 آلاف طفل للقضاء على حماس، استخدام الطفل كوحدة قياس لا فقط مقابل البشر، بل أيضاً المفاهيم الأخلاقيّة والسياسيّة.
الشأن “المُضحك” الى حد الخوف هو أن نحاول تقدير قيمة الأشياء بعدد الأطفال الموتى، أي يمكن القول إن الفلسفة مثلاً تساوي 36 طفلاً، ومعادلة آينشتاين الشهيرة تساوي 340 طفلاً، والأهم، وهذه حجج معارضي الإجهاض، طفل واحد مقابل الحياة المهنية والاستقلالية للمرأة، هكذا تبنى المقارنة، والمعايرة بين المكاسب والأطفال الموتى.
تكرر سؤال، كم طفلاً يجب أن تقتل إسرائيل حتى تعلن “انتصارها”؟، والإجابة كانت “ما يكفي للقضاء على حماس”، وهذه إجابة بين شابيرو. هناك سوداويّة مضاعفة في هذا المنطق من المحاججة، خصوصاً أنه لا يعطي أي عدد ثابت، بل يحيل إلى استمرار القتل، أي لن يتوقف الأطفال عن الموت، سواء الأحياء الآن، أو من هم على وشك الولادة. ولا يمكن التسليم بفرضيّة “الأطفال دوماً يقتلون”، لكن الاكتفاء بمعادلة بسيطة قد يكون حلاً.
كم رضيعاً يجب أن تقتل عمداً كي تُعتطبَ إنسانيتك؟ واحدٌ فقط.