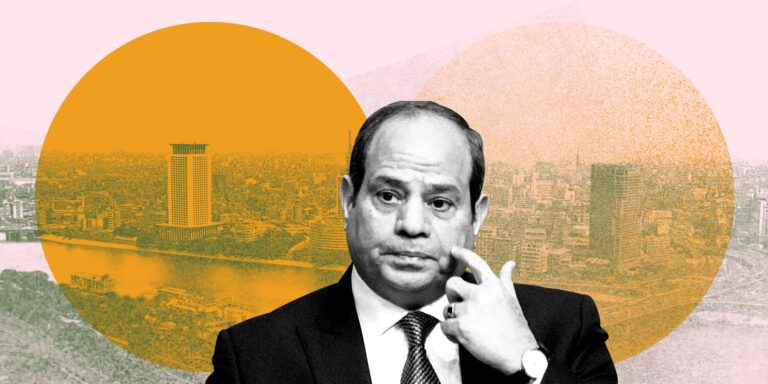في مطبخي، الفارغ عادةً، أكثر من علامة من تلك اللاصقة بالمغناطيس تصف حالي. واحدة تقتبس كلمات إيراسمس، الفيلسوف الهولندي، أحد آباء العلوم الإنسانية الحديثة (ت 1536م): “كلما توافر مالٌ اشتريت كتباً، وما يتبقى أنفقه على الطعام والملابس”. وأخرى مكتوب عليها: “أنا لا أكتنز الكتب، بل أجمعها”. وثالثة عليها جملة لـفران ليبوفيتز، الكاتبة الأميركية (ولدت 1950م): “قبل الكلام فَكر، وقبل التفكير إقرأ”. اكتناز الكتب تهمة مثبتةٌ علي، وبينما أجهد دوماً لأقرأ قبل التفكير، ربما فاتني أوان الكلام (أو الكتابة) وأنا ألتهم الصفحة تلو الأخرى بينما أعاني حالة إفلاس مزمنة لم تمنعني يوماً من شراء المزيد من الكتب.
حسب علمي، ليس من اتفاقٍ على ميلاد الكتاب في هيئته الحالية. ففي العصور القديمة، استخدمت وسائط مختلفة للكتابة، مثلاً في سومر القديمة وُظفت لهذا الغرض ألواح الفخار، وفي مصر القديمة ورق البردي لكن في لفائف. ظهور ما يسمى اصطلاحاً بالـ codex، سلف الكتاب المعاصر، يبدو أن أول دلائله كان في الإمبراطورية الرومانية القديمة، إذ جُمعت ألواح من شمع للكتابة بخيطٍ يربطها كصفحات.
الدين وانتشار الكتاب
عرفت مصر البطلمية (من القرن الرابع قبل الميلاد حتى الثلث الأخير من الأول قبل الميلاد) صوراً من الورق المجموع بشكلٍ يقاربُ ما نعرفه اليوم كتاباً. بعض من أرخ للمسيحية يدعي أن المؤمنين الأوائل حينما سجلوا سيرة السيد المسيح فضلوا صيغة الورق في مجلد، التي كانت حديثة نسبياً وغير منتشرة، للتمايز عن غيرهم (إلى اليوم، كما يقتضي التقليد السائد، يحوي كل كنيس يهودي لفيفة ضخمة مكتوب عليها التلمود بخط اليد)، ومن ثم اقترن انتشار المسيحية، حسب هؤلاء المؤرخين، بسيطرة الكتاب الذي نعرف اليوم.
تطور الكتاب وانتشاره لا ينفصل عن خامة الكتابة، إلى مرحلة ليست بالقصيرة كانت المادة المفضلة جلد الحيوانات، بخاصة البقر، المُعالج لهذا الغرض، بديلاً عن ورق البردي أو غيره. لكن الجلد على متانته كان مُكلفاً، فعاد الورق ليسود الصورة كما نعرف من تراث المسلمين وما ورثنا من مخطوطاتٍ من الصين وغيرها. وقبل الطباعة، كانت وسيلة “النشر” هي خط اليد، من ثم كان النسخ حرفة لها أهلها. لهذا عرف العالم الإسلامي الوراقون، وعرفت الأديرة المسيحية، بخاصة الكاثوليكية في أوروبا الغربية، رهباناً متخصصون بالنسخ، بل والرسم لتوضيح الكتب المخطوطة وتزيينها.
في التراث الإسلامي، عُرف عن بعض أشهر الأسماء من فقهاء وكتاب اشتغالهم “ورَّاقين” طلباً للرزق، مثلاً مؤسس المذهب المنسوب له، الغمام أحمد ابن حنبل (ت 780م)، وابن أبي طيفور في بغداد (ت 893م) وبعده بثلاثة قرون الإمام أبو حامد الغزالي (ت 1111م)، وعرف عن أحد أهم الأسماء في تاريخ الأدب العربي، الجاحظ (ت 868م) اعتياده استئجار دكاكين الوراقين للمبيت فيها ليمضي لياليه في القراءة، فقد كان ذلك أقل كُلفةً من شراء الكتب على الجاحظ الذي نشأ فقيراً (علماً أنه مات في التسعين من عمره جراء سقوط كتبٍ عليه).
أما في السياق المسيحي الأوروبي، فقد تخصصت الأديرة بحفظ التراث المكتوب، ومن ثَم تحكمت فيه. يروي الأكاديمي والروائي الإيطالي أومبرتو إيكو (ت 2016م) في رائعته “اسم الوردة”، المبنية حسب ما يروي، على مخطوطة تاريخية، كيف شهد أحد الأديرة سلسلة من جرائم القتل لمنع الرهبان من قراءة أو نسخ كتاب لأرسطو عن الفكاهة، اذ رأى بعض الرهبان أن المسيحية الحقة والضحك نقيضان. ولأن اللاتينية كانت لغتها (أي الكنيسة الكاثوليكية) بقيت هي لغة التعليم والثقافة في غرب أوروبا حتى مطلع العصور الحديثة. حتى أن مكتبة جامعة أكسفورد الإنكليزية العريقة رفضت شراء أول نسخٍ مطبوعة من مسرحيات شكسبير في القرن السابع عشر، لأنها بـ”اللسان العامي” (أي الإنكليزية) لا بلغة العلم: اللاتينية (في القرن التاسع عشر اشترت الجامعة النسخة نفسها بثمنٍ باهظ).
اختراع المطبعة وعبقرية غوتينبرغ
الثورة، لا في تاريخ الكتاب والكتابة فحسب، بل في تاريخنا جمعياً، كانت اختراع المطبعة الحديثة التي تستخدم الحروف المعدنية المتحركة على يد يوهانز غوتينبرغ في ماينز (ألمانيا المعاصرة) في النصف الأول من القرن الخامس عشر. كفكرة، الكتابة بالضغط باستخدام قوالب لم تكن جديدة. الأختام، وهي في جوهرها فكرة المطبعة نفسها لاحقاً، قديمة قدم الكتابة. الصين اخترعت قبل قرون، الطباعة بالقطع الخشبية، و بالطريقة نفسها أتقن اليابانيون طباعة الرسومات منتجين بعض أشهر أعمالهم الفنية (مثلاً لوحات الرسام الأسطوري هوكوساي الذي عاش في القرن الثامن عشر الميلادي).
عبقرية غوتينبرغ كانت في اختراع تقنية تعتمد الحروف المعدنية سهلة الاستعمال وطويلة العمر، علماً أنه أيضاً طوّر الأحبار لتعتمد في تركيبها على الزيت بديلاً عن الماء لتكون أكثر ثباتاً. اختراع غوتنبرغ أنتج كتباً أقل تكلفة بكثير مما سبق، وبين عشية وضحاها أمسى الكتاب أرخص ومن ثم في متناول أعداد هائلة من القراء بشكل لم يعرفه التاريخ من قبل.
أول نصّ طبعه غوتينبرغ كان الكتاب المقدس باللاتينية، كما جمعه وصاغه القديس جيروم في القرن الرابع الميلادي، وكانت هذه هي النسخة المُستخدَمة في الشعائر والطقوس كما أقرها باباوات روما، وبقيت أساساً لكل ما تلاها من تعديلات. لكن التقنية الجديدة التي وفرت الوسيط القديم للمعرفة والفكر في صيغة أوسع انتشاراً، أحدثت ثورةً كانت سلطة الكنيسة الرومانية أهم ضحاياها.
ففي أوروبا الغربية، حيث ساد حبر روما الأعظم (أي البابا)، سبقت ظهور الطباعة محاولات لترجمة الكتاب المقدس، بعهديه القديم والجديد، إلى غير اللاتينية. إحدى هذه المحاولات كانت بإيعازٍ من جون وايكليف، أحد مدرسي جامعة أكسفورد في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي. تأثير وايكليف لم يتوقف عند توفير نصّ بالإنكليزية بإمكان أي شخص غير متعلم (وهذه آنذاك عنت حكماً جاهل باللاتينية) أن يفهمه، بل أنتجت حركة “المتمتمين”، لترديدهم نصوص الإنجيل.
آراء وايكليف تحدت سلطة الكنيسة الكاثوليكية ومعتقداتها، فطُرد من عمله في الجامعة لكنه واصل الكتابة والبحث واستمر تأثيره إلى الحد الذي عزى مؤرخون لأفكاره “ثورة الفلاحين” (The Peasants’ Revolt) التي هزت عرش إنكلترا في 1381م. مات الرجل في فراشه، لكن بعد وفاته اتهمته الكنيسة بالهرطقة وأخرجت جثته وأحرقتها. يعد وايكليف وتراثه إرهاصاً للبروتستانتية، وقد نال كل هذا الأثر قبل اختراع المطبعة الحديثة، فما بالك بعد ميلادها؟
ضرورة توافر الكتب للجميع
مع القرن السادس عشر، ومع تنامي الاهتمام بتراث اليونان ولغته القديمة من جهة، وتوافر الطباعة من جهة أخرى، تسارعت التغيرات حدةً ووتيرةً. أبو البروتستانتية، مارتن لوثر، أصدر بمساعدة آخرين، ترجمة ألمانية للكتاب المقدس طُبعت عام 1522. في الوقت نفسه تقريباً، في إنكلترا، أصدر ويليام تيندال ترجمته للكتاب نفسه من أصوله في العبرية (للعهد القديم) واليونانية (العهد الجديد) إلى الإنكليزية.
دفع تيندال حياته ثمناً لهذا التعدي على سلطة الكنيسة (بترجمة الإنجيل)، إذ حوكم وأدين بالهرطقة وشنق ثم أُحرقت جثته، لكن ترجمته كانت أساس ما يُعرف اصطلاحاً بـ”إنجيل الملك جيمس” (King James Bible)، الذي، وبعد تحول الجزر البريطانية إلى البروتستانتية وخروجها من تحت سلطة روما، أضحى النص الأساس للعقيدة المسيحية في هذه البلاد وإمبراطوريتها الناشئة.
والملك جيمس المقصود هنا، هو جيمس ستيورات الذي حكم اسكتلندا أولاً، ثم ورث عرش إنكلترا ومعها ويلز وأيرلندا، فكان أول من حكم الجزر البريطانية مجتمعةً (من 1603 حتى وفاته في 1625). تربّى جيمس تربية بروتستانتية صارمة، وإشرافه على إنتاج نسخة جديدة من الكتاب المقدس اقترن بالاعتقاد البروتستانتي بضرورة توافره للجميع. أبعد من ذلك، تميزت هذه النسخة بلغةٍ رائعة (بعضها موروث من ترجمة تيندال) أثرت الإنكليزية وشكلتها في آن معاً (ترجمة مارتن لوثر الكتاب المقدس كان لها أثر مشابه على اللغة والهوية الألمانيتين).
عنت سيادة البروتستانتية علاقةً أكثر مباشرة بالنص المقدس، ومن ثم اهتماماً بالتعليم في هذه المجتمعات التي كانت شديدة التدين آنذاك. لذلك، قبل جارتها الجنوبية، انخفضت الأمية في اسكتلندا الفقيرة قبل جارتها الجنوبية الأغنى، إنكلترا، لالتزام الأولى بالبروتستانتية مبكراً. أيضاً أدى توافر النص المقدس للجميع، فقهاء فيه وغير متخصصين، الى حالة من التشظي المستمر ميزت المسيحية البروتستانتية، إذ نشأت مئات الكنائس على أساس قراءات متباينة للنص الأساسي للمسيحية، لا يكاد يجمعها شيء سوى الابتعاد عن سلطة روما.
فمن جهة، مثلاً، ظهرت حركة تسائل كل ما هو موجود عن تاريخ المسيحية، بخاصة مع وعي متزايد بدور الترجمة من أصول يونانية وعبرية، شفهية الأصل، في تشكيل ما بين أيدينا، ومن جهة أخرى، على النقيض، ولدت كنائس تصر على التعامل الحرفي مع الكتاب المقدس إلى حد الإيمان بأن عمر الكون بضعة آلاف من الأعوام فقط (حسب العهد القديم). “حروب الدين” كما سميت الصراعات التي ولدتها حركة الإصلاح الديني في أوروبا بدئاً من القرن السادس عشر حتى الثامن عشر، شكلت خريطة هذه القارة فرسمت حدوداً وخلقت عداوات مريرة، وساهمت أيضاً في خلق نزعة قوية للبحث عن عالم أقل عنفاً يُبعد فيه المقدس عن المجال العام والسياسة.
لم يكن بإمكان أي من هذه التحولات أن يقلب مجتمعاتٍ كاملة رأساً على عقب من دون الكتاب المطبوع، وما جرى في أوروبا التي شكلت عالمنا الحديث ذهبت تبعاته أبعد بكثير من هذه القارة الصغيرة مساحةً الكبيرة أثراً.
من الطريف أن المطبعة التي استهلّت عملها بإخراج نسخة من الكتاب المقدس باللاتينية طبقاً للتعاليم الكاثوليكية، كانت الأداة الأهم لنجاح الثورة البروتستانتية بكل تبعاتها، ثم بعد ذلك لأفكار ما يسمى بعصر الأنوار وصولاً الى الثورة الفرنسية بعلمانيتها المعروفة. بل إن إسكتلندا الفقيرة البعيدة نسبياً التي ذكرنا اهتمامها بالتعليم حرصاً على قراءة الكتاب المقدس كانت موطن “التنوير الاسكتلندي” الخاص بها، حتى عُرفت أدنبرة عاصمتها بـ”أثينا الشمال” حيث، في القرن الثامن عشر، عاش الفيلسوف ديفيد هيوم، ولجأ جان جاك روسو، أحد آباء الثورة الفرنسية.
لم تستقر المطبعة في بلادنا إلا بعد ميلادها بأربعة قرون، في القرن التاسع عشر، وبينما يرينا تاريخ الكتاب المطبوع ألا الرقابة ولا القمع يقتلان فكراً (انظر كيف انتصر ويليام تينديل بعد قتله وحرقه) لا يبدو أننا وعينا سخافة الرقابة كفكرةٍ بعد، هذا علماً أننا لم نناقش عصر الإنترنت الذي نعيش والحرية الهائلة التي خلقها. لا سلاح ضد الأفكار الرديئة أمضى من التعليم الجيد الذي يوطد التفكير النقدي، لكن ما من سلطة باطشة تشجع النقد، أي نقد، وقلائل هم من يتعلمون من دروس التاريخ. حري بنا أن نتذكر ذلك كلّمنا لمسنا كتاباً.