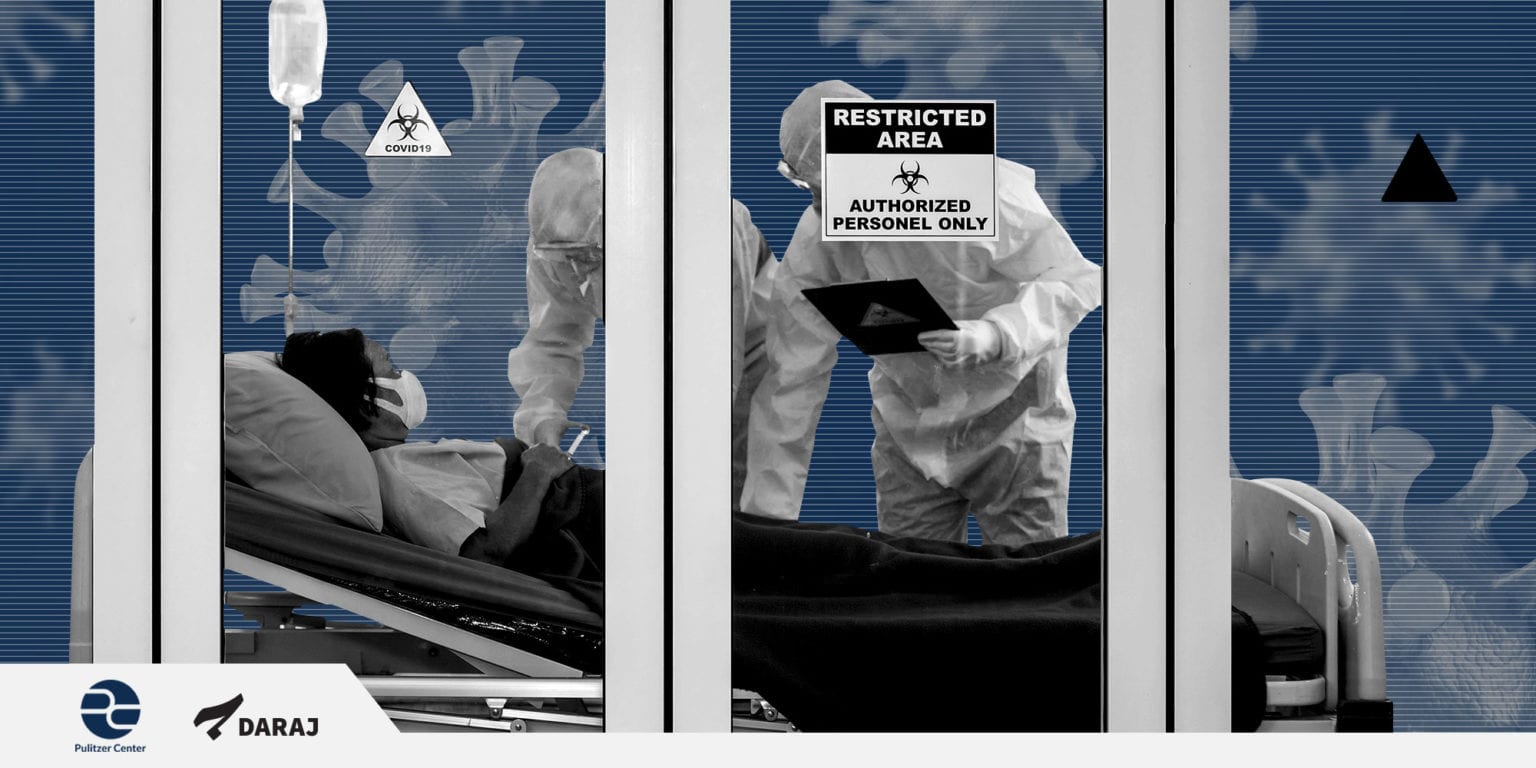- هذا الموضوع تم اعداده بالتعاون مع Pulitzer Center
يجمع المقال معطيات لمصلحة إمكان استعمال لقاح السل في وقاية الطواقم الصحية كلها والفئات العمرية فوق الخامسة والخمسين، من “كورونا”، بانتظار لقاح محدد له. ويُلاحِظ أن ضربات “كورونا” تركزت على الحواضر الميتروبوليتانية الكبرى (نيويورك نموذجاً)، بل لُقِّب بـ”فايروس الأغنياء”.

لا شيء بدهياً في الطب أكثر من القول إن اللقاح هو الحل الفعلي للوباء. وبقدر ما يبدو ذلك بدهياً، فجّرت جائحة “كورونا” نقاشاً بدا خافتاً وإشكالياً قبلها عن تلك البداهة تحديداً! ويمكن اعتبار الكاتبة الأميركية لوري غاريت نموذجاً عن ذلك. إذ أطلقت جائحة “كورونا” شهرتها عالمياً بوصفها “كاسندرا” مُعاصرة، استناداً إلى كتابها الشهير “الطاعون المقبل” الذي قدمت فيه وصفاً يكاد يكون رؤيوياً عن انتشار جائحة لا مرد لها بسبب فايروس غير متوقع. وكانت نواة الكتاب مقالها في مجلة “فورين أفيرز” (سبتمبر/ أكتوبر 2015) عنوانها “كيف أساءت “منظمة الصحة العالمية التعامل مع وباء إيبولا”؟. وتناول المقال موجة مقيتة من انتشار “إيبولا” في دول غرب أفريقيا استمرت بين عامي 2013 و2015، وتسببت في قرابة 12 ألف وفاة، و30 ألف إصابة مؤكدة، إضافة الى تهديد حياة ملايين البشر. وآنذاك، كاد “إيبولا” أن يتحوّل جائحة عالمية مع ظهور إصابات محدودة في أوروبا وأميركا. وقد اعتُبِرَ نقد غاريت لأداء “م. ص.ع” المنشور في مجلة يشرف عليها “مجلس العلاقات الخارجية” الأميركية، كأنه تنديد ضمني من وزارة الخارجية الأميركية بفشل تلك المنظمة الأممية في صد زحف ذلك الفيروس في أفريقيا وخارجها. وآنذاك أيضاً، خلصت غاريت إلى “إن الرد الدولي على عنصر وبائي جديد، يستمر في كونه محدوداً، غير متناسق وغير مجد”. ألا ينطبق ذلك على سلسلة من الأوبئة تشمل مسمياتها الطيور والخنازير والدجاج والإبل والقردة وغيرها؟ ماذا لو فكرنا فيه أيضاً كوصف للاستجابة الدولية حيال كورونا حاضراً؟
وعلى غرار غاريت، ارتفعت صورة بيل غيتس بوصفه صاحب رؤية منذرة بشأن الأوبئة في القرن 21. وفي 2015، واستفادة من دروس موجة “إيبولا” أيضاً، نشر غيتس، المؤسّس الأسطوري لشركة “مايكروسوفت”، بياناً تحذيراً استند فيه إلى خبرة “صندوق ميليندا وبيل غيتس” في مكافحة الأوبئة ومشاركته في التصدي لوباء “إيبولا”، ليؤكّد أن العالم يفتقد إلى قدرات استراتيجيّة منتظمة للتصدي للأوبئة، خصوصاً الفايروسيّة منها. وفي خضم جائحة “كورونا”، تكرّر الظهور الإعلامي لغيتس ليذكر بمقولته عن ضرورة استعداد الدول الكبرى والصغرى للأوبئة، بطرائق تشبه استعدادها للحروب. وعلى غرار تكديس الأسلحة والذخائر والمعدات والمؤن والأدوات اللوجسيتية والتكنولوجية، وكذلك تدريب مئات آلاف من أصناف الجنود والمتخصصين، يجب الاستعداد للأوبئة، وفق رؤية غيتس. ألا تبدو كلماته كأنها رؤيا يوسفية في ظل المنظر المخزي لتقاتل دول متقدمة بالأموال الطائلة والعمليات الاستخباراتية، على تناتش وسائل طبية “متخلفة” تقنيّاً كالكمامات و”معدات الوقاية الشخصية” ذائعة الصيت التي لا تزيد عن كونها بزات وقفازات وأغطية رأس من قماش أو ورق أو نايلون؟

لا لقاح بالأمس… والآن؟
ثمة ثقب أسود يصعب إنكاره في الطب المعاصر بشأن الأوبئة واللقاحات. لقد ظهر “إيبولا” للمرّة الأولى في 1976، وتكرر في ستة موجات وصولاً إلى 2015. لم يصنع لقاح ضد فايروس “إيبولا”. وعلى رغم أنه فتك بمليارات البشر عبر التاريخ، لا لقاح ضد الملاريا الذي استُعمِلت أدويته، للمفارقة، علاجاً “إشكالياً” ضد “كورونا”، وتسبّب في ذيوع صيت البروفسور الفرنسي راؤول ديديه!
وتستمر البشرية في تحريك عناصر نشر الأوبئة كاختراقها المتواصل للموائل الطبيعية للحيوانات وعناصر العدوى، إضافة إلى أشكال اخرى من الإضرار بالنظم الإيكولوجية عالمياً، لكنها لا توظف تقدمها العلمي الهائل في صنع لقاحات للأوبئة. وحتى لو ذهبنا في التفكير المؤامراتي- العنصري (المرفوض بالطبع) إلى أقصاه، بالقول إن الحضارة لا تهتم بصنع حلول لما يفتك بأرواح الفقراء والشعوب المتخلفة، فيما تبذل الأموال مدرارة على أدوية تصيب الشرائح المدينية المتقدمة أساساً، كالضغط والسكري والدهون وأمراض القلب والأوعية الدموية و”باركنسون” و”آلزهايمر” و”التصلب اللويحي المتعدد”، فلنتذكر توّاً أن لا لقاح ضد الإيدز مثلاً الذي ظهر في ثمانينات القرن العشرين، على رغم تركزه على شرائح مدينية متروبوليتانية أساساً، بل ظهرت حالاته الموثقة الأولى في مدينة نيويورك! ولا لقاح ضد مرض “ليجوانير” أميركي المنشأ، ولا الأمراض المنقولة بالجنس المنتشرة في أميركا، والقائمة طويلة.
لنعد إلى… الآن. ومع انتشاره، وُصِف “كورونا” بتهكم مرير بأنه “فايروس الأغنياء”، خصوصاً عندما انتقل من مهده المفترض في “ووهان” الصينية إلى أوروبا ثم الولايات المتحدة. استدراكاً، إنّ “ووهان” مدينة متروبولية كوزموبوليتية متقدمة. وعندما سرى اتهام بأن الفايروس تسرب من مختبر علمي فيها، تبيّن سريعاً أن “معاهد الصحة الوطنية” في أميركا تتعاون بشكل وثيق مع ذلك المختبر، نظراً إلى تقدمه علمياً.
وباستثناء إيران، انتشر “كورونا” سريعاً وكثيفاً في بلدان أوروبا المتقدمة. وأعطت إيطاليا مثلاً عن ذلك، إذ انتشر أولاً في شمالها الثري (مقاطعة لومبارديا) ومدنها فائقة الشهرة كالبندقية. وفي كل تلك الدول، ولاحقاً في دول اخرى، تم التركيز على “محاصرة” الوباء في المدن الكبرى. وعندما ضرب قلب “المدينة التفاحة”، بدت نيويورك كأنها فاجعة العالم بأسره. وفي المقابل، قدم ذلك المثل النيويوركي مشهداً “مألوفاً” في الأوبئة، بمعنى انتشار الوباء في الشرائح الأقل ثراءً وتمكناً، خصوصاً محدودة الدخل ومجتمعات الإثنيات والأقليات. الأرجح أنها صورة فوّارة ومتفاعلة، يصعب اختصارها عبر اختزالات واجتزاءات.

هل يحمي الطواقم الطبية والمسنين؟
في سياق تلك الصورة المتفاعلة، برز خيط جدير بالالتقاط. وبخفوت وجرأة، تم الالتفات إلى لقاح السل منذ أواخر آذار/ مارس 2020، عبر مسارات مقالات ودراسات علمية موثقة، تقاطعت على الدعوة إلى الاتكاء على لقاح السل القديم الذي اكتشفه “معهد باستور” عام 1921. (تذكيراً، ذلك المعهد أول من عزل فايروس الإيدز في ثمانينات القرن العشرين أيضاً). تبرز بسرعة تلك الدراسة التي قدمتها مجلة “فورين بوليسي” الأميركية بعنوان “يستطيع هذا اللقاح أن ينقذ أوراح الطواقم الصحية“. وتولى المدير العام لـ”منظمة الصحة العالمية” د. تادروس غبريسوس الإعلان عن دراسة أسترالية واسعة يديرها “معهد بحوث مردوخ لطب الأطفال” وتشمل أربعة آلاف طبيب وممرض لتحديد مدى ونوع الاستجابة المناعية التي يولدها لقاح السل (يسمّى أيضاً “بي سي جي”)، حيال “كورونا”، وتحديداً قدرته على وقاية الطواقم الصحية العاملة على الخطوط الأمامية في مواجهة الجائحة. وثمة قسم خاص على موقع “م. ص.ع.” عن العلاقة بين لقاح “بي سي جي” والوقاية من “كورونا“. وقد أشار في 12 نيسان/ أبريل 2020، إلى أن المنظمة الدولية لا تزال في انتظار نتائج دراستين واسعتين عن العلاقة بين لقاح السل والوقاية من “كورونا”، ما يعني أنها لن تصدر توصيات بذلك المعنى إلا عند انتهاء الدراستين. ولعل الأكثر بروزاً هو الدراسة المنشورة على الموقع الإلكتروني لـ”تحالف اللقاح” الدولي (يعرف بإسم “غافي”) عن أهمية لقاح “بي سي جي” وفرصة أن يعطي وقاية من المرض الذي يسببه “كورونا“. واستطراداً، يشرف “غافي” على جهود تموّل بمليارات الدولارات من دول كبرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، بهدف صنع لقاح ضد “كورونا”.
ويشير “غافي” إلى أن ذلك اللقاح استُعمِل مراراً في غير الوقاية من السل، بمعنى أنه أُعطيَ لتدعيم المناعة حيال التهابات رئوية وتنفسية متنوعة، ما يفتح مجالاً للتفكير في قدرته على الوقاية من الالتهاب الرئوي الحاد الذي يسببه “كورونا”، خصوصاً لدى كبار السن. وهناك دراسة ما زالت جارية ينهض بها ألف طبيب وممرض وعامل صحة في 8 مستشفيات في هولندا. وتتميّز الدراسة بأنها تتبع أسلوب علمي يعرف بـ”التعمية المزدوجة”، بمعنى أن من تشملهم لا يعرفون إذا كانوا يحقنون بلقاح “بي سي جي” أو لقاح وهمي. وثمة دراسة أسترالية مشابهة، لكنها أكثر اتساعاً بأربعة أضعاف.
والأرجح أن الدراسة الأكثر بروزاً تنهض بها ألمانيا، وقد انطلقت في 23 آذار بسبب عنصرين علميين. أولهما أنها جاءت بعد دراسة في المختبر أظهرت قدرة لقاح “بي سي جي” على تحريك رد فعل مناعي ضد “كورونا” للوقاية من المرض الذي يسببه. ويتمثل الثاني في أنها تشمل أشخاصاً متقدمين في السن، إضافة إلى أطباء وممرضين وعاملين صحيين. وقد نالت اهتماماً من مجلة “ساينس” العلمية الناطقة بلسان “الجمعية الأميركية لتقدم العلوم”، ونشرت تغطية عن تفاصيلها.
جغرافيا الانتشار واللقاح
في نفسٍ مُشابِه، تم التدقيق في المقارنة بين خريطتي انتشار “كورونا” وجغرافيا لقاح السل [أنظر bcgatlas.org]. وبرزت دراسة عن ارتباط إحصائي بين المعطيين في الجغرافيا الطبية، إذا جاز التعبير، نهضت بها مجموعة علماء تعمل ضمن حقل تعاون بين “المجلة الطبية البريطانية” و”جامعة يال” الأميركية، و”مختبر كولد سبرينغ” الأميركي. وقد أثارت تلك الدراسة التحليلية جدالاً علمياً واسعاً، ما زال مستمراً، وينتظر الانتهاء من المراجعة التدقيقية من قبل نظراء من المتخصصين. وشملت الدراسة 19 دولة، وتوصلت إلى وجود فارق في إصابات “كورونا” ومعدل ظهور المرض الرئوي الحاد الذي يسببه، وكذلك الوفيات المتصلة به، بين الدول التي تنفذ برنامج لقاح “بي سي جي” وتلك التي لا تفعل ذلك أو توقفت عنه.
وتندرج إيران ضمن الدول التي أوقفت برنامج لقاح “بي سي جي” في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وعام 1984، أعيد العمل ببرنامج لقاح السل الذي يبدأ تقليدياً منذ الأيام الأولى بعد الولادة، ويكرر في مراحل مختلفة من العمر. وترجح الدراسة أن يكون ذلك سبباً في ارتفاع معدل الوفيات بين من فاتهم اللقاح أيام الشاه، وهم يشكلون معظم كبار السن في إيران اليوم.
وثمة مصادر تشير إلى أن من يقصدون إيران للدراسة الدينية أو التدريب العسكري، يُعطوَن لقاح السل أيضاً. هل يفسر ذلك عدم حدوث تلك الموجة التي توجس منها كثيرون، عندما سرى “كورونا” في إيران؟
في لبنان، علت الصرخة أولاً بشأن وصول “كورونا” من إيران، وكاد الأمر يتسبب بشقاق وطني. وسرعان ما تبدّلت الصورة، وعادت صورة التقدم المديني المتروبولي للتقدم، ثم توزّعت بؤر الانتشار.
وثمة “خريطة لبنانية” غير معلنة بشأن لقاح السل. إذ أوقف لبنان منذ عقود برنامج لقاح السل، فلا يعطى إلا إذا طُلِبْ، خصوصاً لحديثي الولادة. في مقلب مغاير، تنفذ وكالة الأونروا برنامجاً صارماً في لقاح “بي سي جي”، يشمل حديثي الولادة، ويكرر أثناء الدراسة الابتدائية. ولوحظ أن المخيمات الفلسطينية في لبنان لم تشهد وضعاً انفجارياً، ربما توقعه كثيرون، في وباء “كورونا”. ولعل السلطات الصحية في لبنان مدعوة للتدقيق في ذلك الأمر. وثمة من يشير إلى مدن كصيدا (وكذلك طرابلس)، لم تكن درجة الالتزام بإجراءات الوقاية من انتشار “كورونا” فيها على درجة كبيرة من الصرامة، لكنها لم تشهد انتشاراً ذريعاً لذلك الوباء!
هل ثمة شيء ما يجدر التدقيق به لبنانياً في شأن لقاح السل وعلاقته بـ”كورونا”؟ سؤال برسم الهيئة الوطنية لمكافحة “كورونا”!