لم أكن قد تجاوزت الثانية عشرة حين حلت علينا الحرب.
اشتعلت الجبهات حتى قبل أن أفهم معنى القتال ولماذا استحالت حياتنا ناراً وموتاً. لم نفاجأ بذهاب عمي الضابط في الجيش العراقي إلى المعركة، فهو كان عسكرياً منجذباً بالكامل إلى خيارات الجيش العراقي حينها.
شعرت آنذاك بقيمة أبي الذي اختار مجال الثقافة والمسرح دوناً عن أعمامي الخمسة الذين سلكوا جميعاً درب الخدمة العسكرية. صحيح أن والدي كان مجبراً كأي عراقي، على الذهاب إلى الجبهة مع كل حرب، إلا أن حرب 2003، كانت “ديموقراطية” للغاية، إذ منحته فرصة البقاء معنا.
كان الوضع غريباً، فنحن في جانب الكرخ حيث جميع الوزارات المهمة، فكان القصف الأميركي عليها كالرذاذ ومثل مطر آذار/ مارس، بحيث غرقت شوارع مدينتي بطوفان من الضحايا.
عند السادسة من مساء كل ليلة يبدأ العد التنازلي لصوت الغارة. تسألني أختي، ما معنى صوت الغارة؟ إنه الموت حين يطاردنا.
لم يكن والدي ينوي إخراجنا من المنزل، على رغم القصف، لكنه حين شاهد بأم عينه رأساً يتدحرج، ثم يتوقف بثبات قرب قدمه قرب منزلنا قرر حينها أن نتجه إلى شرق المدينة حيث بيت جدي، في مدينة الثورة.
طوال الطريق كانت والدتي تبكي وتذكر أبي بطلبها الأزلي للهجرة : “أخبرتك مراراً وتكراراً وحتى قبل أن ننجب هؤلاء المساكين أن نهرب، كنت أرى بغداد مدينة مدمرة قبل عشرين سنة ولم تسمعني”، لكن أبي كان يتعمد ألا يجيبها.
كان يكتفي بقول “الله كريم” وهو يضحك مع السائق.

هناك عشنا على السطح لأيام بسبب كثرة الموجودين في بيت جدي. كان النوم في العراء تحت ضوء المعارك في السماء وأصوات الرصاص والقصف، مرعباً.
كان للاتصال الذي حمل خبر “استشهاد” عمي الضابط، وإحضار جثته المتفحمة والتي تكاد تكون بحجم الكف الصغيرة، سبباً لعودتنا إلى منزلنا من أجل “الموت بكرامة” تحت أنقاض بيتنا لا فوق السطوح، كما اعتقد والداي.
تركنا الحي خالياً إلا من الممرضة أم عطور، جارتنا الحنونة، التي فضلت البقاء لرعاية المصابين. كانت تزورنا بعد كل غارة صباحاً وتسرد لنا حكايات الحرب وتضحك: “ليلة أمس أحضروا لي شخصاً قُسم رأسه نصفين، روحه وصلت إلى السماء السابعة ويريدون مني أن أسعفه، لقد جن البشر هنا”.
أم عطور شعرت بالخيبة الشديدة، حين رأت حقائبنا فيما نهم بالهروب من الحي: “حتى أنتم؟”، تشير والدتي إلينا وتجيبها “من أجلهم”.
في طريق العودة، اتخمت الشوارع بالمواد المنزلية، ثلاجات وغسالات وملابس متناثرة في الشوارع، أصبحت بغداد مثل محل كبير مسروق بفوضى، يتشاجر الجميع داخله.
كل شيء معروض للتفريط، اعتمد والدي وعمي الذي أقلنا، على الإمساك بملابس داخلية بيض لتبدو كأعلام استسلام، يومها لم تتحدث والدتي أبداً، كانت تبكي وحسب، وكأنها تعيد الجملة ذاتها، “أخبرتك أن نخرج من هذه البقعة، قبل أن تلتهمنا”.
بقعة ميتة
توالت علينا أيام ثقيلة، لا كهرباء، أو ماء. نقف عند عتبة الباب كنوع من الفسحة، فيما تمر أمامنا أكتاف العابرين محملة بأكياس ثياب وطعام مسروق. أحد جيراننا استطاع أن يظفر بسيارة كانت رائعة، صرخ بصوت عالٍ: هذه حصتي من النفط كمواطن عراقي، لن أطلب المزيد. أما في الليل، فعلينا نسيان ما قد شاهدناه صباحاً، والتوجه إلى الدعاء والبكاء والتوسل إلى الرب لإنقاذنا من صوت القصف، كم كانت الأيام متشابهة، تردد والدتي بشكل يومي مع الافطار بمرارة، “سيكون كل شيء بخير. اشكروا والدكم الذي أراد لكم البقاء في هذه البقعة الميتة”.
قبل الحرب كان والدي غالباً ما يحدثنا عما تعرض له كمواطن في عراق صدام حسين، لكنه يطلب منا أن نقسم، أن الحديث هذا يكون بيننا فقط، لان للجدران أذاناً.
روى لنا ظروف سجنه لفترة قصيرة وتعذيبه بسبب رسالة من المهجر، دوّن فيها صديقه، عبارات مبطنة عن “حامي البوابة الشرقية”، الصفة التي كانت تطلق على صدام حسين. أخبرنا كيف وبحزن، باع مكتبته، كتاباً بعد كتاب، ليشتري الحليب لنا، وكيف أن عمله في المدرسة والمسرح لا يوفر لنا وجبة غداء، وكيف أن عربة الغاز كانت خير أرجوحة لنا. “عليكم ألا تنسوا هذه الذكريات، وأن تعلموا أن الحرية في القلب ولو جاء بعد صدام، ألف” كان يقول.
على رغم كل شيء كان والدي متفائلاً للغاية، وحالماً بوطن، وبحرية لم يعرفها جيله. أما أمي فقد أرضعتني كره صدام وذكرت لي قصص جرائمه مع كل كتاب باعه والدي بسبب الجوع. كانت فكرة الحرب بالنسبة إلينا، التخلص من صدام بكبسة زر ثم العيش الرغيد.
الصدمة الأولى لي كانت بعراق ما بعد 2003، وتحديداً بعد سنتين فقط من سقوط نظام البعث والغزو الأميركي ونشوء تنظيمات مختلفة. حينها أجبرتني على ارتداء الحجاب عنوة، الجماعة المسلحة والمسيطرة على منطقتنا.
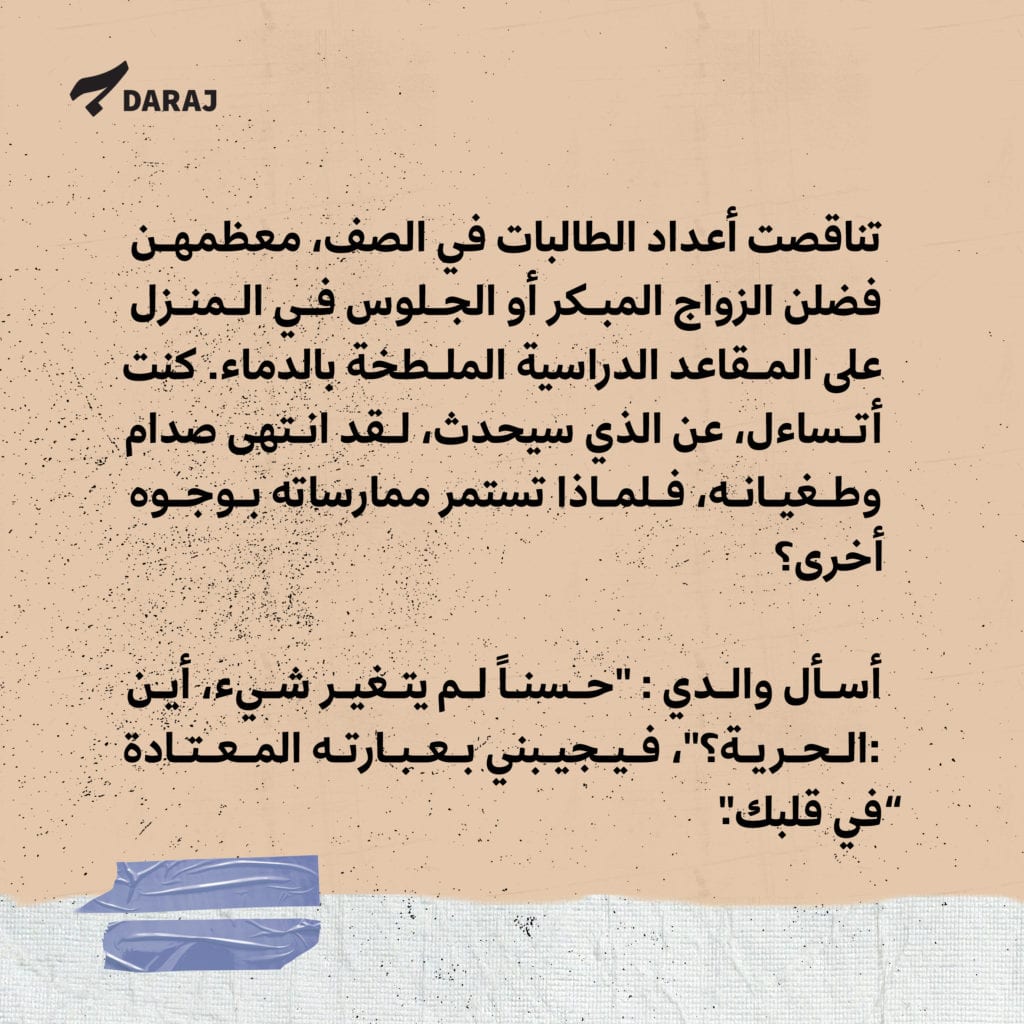
كنت ما زلت مراهقة في مرحلة المتوسطة ولم تكن طموحاتي وأحلامي تتعدى فوز المنتخب الوطني في كرة القدم، ومشاهدة “ستار أكاديمي”، والظفر بدرجات جيدة في الدراسة.
عاندت في بادئ الأمر، ولم أقبل ارتداء الحجاب بطريقة الإكراه هذه، حتى صار الأمر حقيقياً وموجعاً، في المنطقة كلها، ومن لا ترتدي الحجاب، مصيرها القتل، كما قتلوا جارتنا وابنتها، في يوم رمضاني.
تناقصت أعداد الطالبات في الصف، معظمهن فضلن الزواج المبكر أو الجلوس في المنزل على المقاعد الدراسية الملطخة بالدماء. كنت أتساءل، عن الذي سيحدث، لقد انتهى صدام وطغيانه، فلماذا تستمر ممارساته بوجوه أخرى؟
أسأل والدي : “حسناً لم يتغير شيء، أين الحرية؟”، فيجيبني بعبارته المعتادة: “في قلبك”. لكن قلبي ليس حراً، وها أنا أرتدي حجاباً بالقوة.
يدخن بهدوء، وينتظر الفرج. لكن الفرج تضاءل، حتى صار نقطة في عمق محيط الظلم، وبدأ النهار يتلاشي في مدينتي وصار الليل والخوف مظهرها الوحيد.
في وقت سريع، هُجر كثيرون من أبناء منطقتنا، وقتل بعضهم برصاص بارد وساذج، وسقط من تبقى في انفجارات لا حصر لها. ازداد النواح والنحيب، وتعالت أصوات الصرخات. كنا نستفيق على صرخة، وننام على تنهيدة قاتلة. أتجه إلى المدرسة وأتلفت حولي، مسدس هنا، وضحية هناك، دماء في كل مكان، وطريقي إلى هناك، سمّته الطالبات “مثلث برمودا”، حتى إننا في يوم من الأيام وجدنا حارس المدرسة، يتوسط الساحة بدمائه، فيما تخترق سارية العلم، أحشاءه، وعائلته موزعة على الصفوف.
نكمل تدريسنا، يحدث انفجار، أو يأتي خبر مقتل أب طالبة، فنعود إلى منازلنا غير الآمنة. في بعض الأحيان، لا نستطيع حتى الخروج من المنزل لأيام طويلة، نفقد فيها الطعام وحاجتنا إلى الحياة، بسبب مواجهات بين الأميركيين والجهة المسيطرة على المنطقة.
هذا الرعب استمر لفترة غير قليلة، على مدى سنوات، إذ كنا كل يوم، في مواجهة جديدة مع الموت، وكانت أمي الأكثر تأثراً بيننا. تودعنا بشكل رسمي كل صباح، فيما نتجه إلى المدرسة، ويذهب والدي الى العمل، مستقلاً دراجته الهوائية باتجاه المدرسة التي يعمل فيها أستاذاً للفنون، إلى أن نعود وتستقبلنا، تعانقنا وتبكي لساعات. تقول إنها شاهدت خبراً عن انفجار قريب وما من وسيلة اتصال بنا.
إقرأوا أيضاً:
كان هذا الحوار مع أمي يتكرر يومياً. كانت تستمع إلى ما نأتي به في نهاية النهارات، أي أخبار عما رأيناه، وليس عما درسناه. كانت الدراسة أمراً ثانوياً، حتى إنها فكرت كثيراً في أن نترك الدراسة حفاظاً على أرواحنا، أو الهجرة، ووضعت هذين الحلين أمام والدي وهي ترى أفواجاً من الأصدقاء والمعارف، يحملون ذكرياتهم الحزينة على ظهورهم، ويهربون.
بالطبع والدي المتشبث بالعراق لم يقتنع بالفكرة، بل أصر على أن نكمل دراستنا حتى لو كلفنا ذلك، الموت في سبيل العلم.
بالنسبة إلي، فأنا كثيراً ما حلمت بالهجرة والابتعاد، تخيلت نفسي في إحدى الدول الأوروبية، أعيش مراهقتي وأختبر مشاعر الحب، أرتدي ما يحلو لي، أغني وأرقص. لكنني كنت أعرف أنني إن هاجرت لن أعيش كما كنت أحلم، بل سأبقى غالباً مسكونة بصور الضحايا. سيبقى مشهد قتل صديقتي ونحن نخرج من المدرسة، راسخاً في مخيلتي، سيبقى خبر اختطاف خالي وفقدانه، قتل أقاربي، وتصفية جيراني، كلها، كدماء تمشي في جسدي. وجوههم صارت جزءاً مني.
أخرج صباحا ببلادة، حتى إن صوت الرصاص القريب جداً، لم يحرك في جسدي شيئاً، أصادف كل يوم، القاتل الذي أجبرني على ارتداء الحجاب وهو يسير برشاشة أطول مني، ويفرض الرهبة على السكان.
أردت بعد نجاحي في الصف المتوسط الثالث، أن أكمل الثانوية، لكن حدث ما لم أتخيله يوماً، أجبرني والدي على دخول معهد إعداد المعلمات، بدل الثانوية، لقربه من منزلنا، وحسب. إنها تفاصيل معقدة ومتشابكة.
أتذكر بكائي المستمر وتدخل مديرة المدرسة. “أن تنال شهادة دراسية أفضل من أن تنال شهادة بحب الوطن”، هكذا كانت تقول أمي. أما أنا فكنت أحلم بكلمة press منقوشة على ثيابي، حتى إن السنوات الثلاث الأولى لي في المعهد، كانت مجرد أسئلة للطالبات من نوع، هل حقاً هذا ما تريدين دراسته؟
كانت الحرب الطائفية حفرة كبيرة لأحلامي التي أرادتها أن تكون المنقذ من الواقع، كما ردمت أحلام الملايين مثلي. كنت كل يوم أحاول إيجاد منفذ صغير جداً، أستطيع اللجوء إليه، طالما أن الهجرة صعبة، وتغيير وضع العراق أصعب. كان الاستسلام جزءاً من النجاة هنا، أن تستسلم وتسير وحسب، أو حتى، تقف، في مكانك، هي الطريقة الوحيدة التي قد تمدد فرص أيامك، سنوات تمر سريعاً من دون هوادة، ووحدها الحرب، من يملك الوقت وحياتنا. أصبحت فكرة أن عائلتي بخير وسلام، أكبر إنجاز قد أحققه، هذا الرنين في الهاتف، يشلع قلبي من مكانه لشدة الخوف من أن يحمل خبراً سيئاً. خسرت أمنيات كثيرة وأدركت أن صدام لم يذهب، بقي حاضراً في وجوه كثيرة، تعيدنا الى ارحام امهاتنا خائفين.
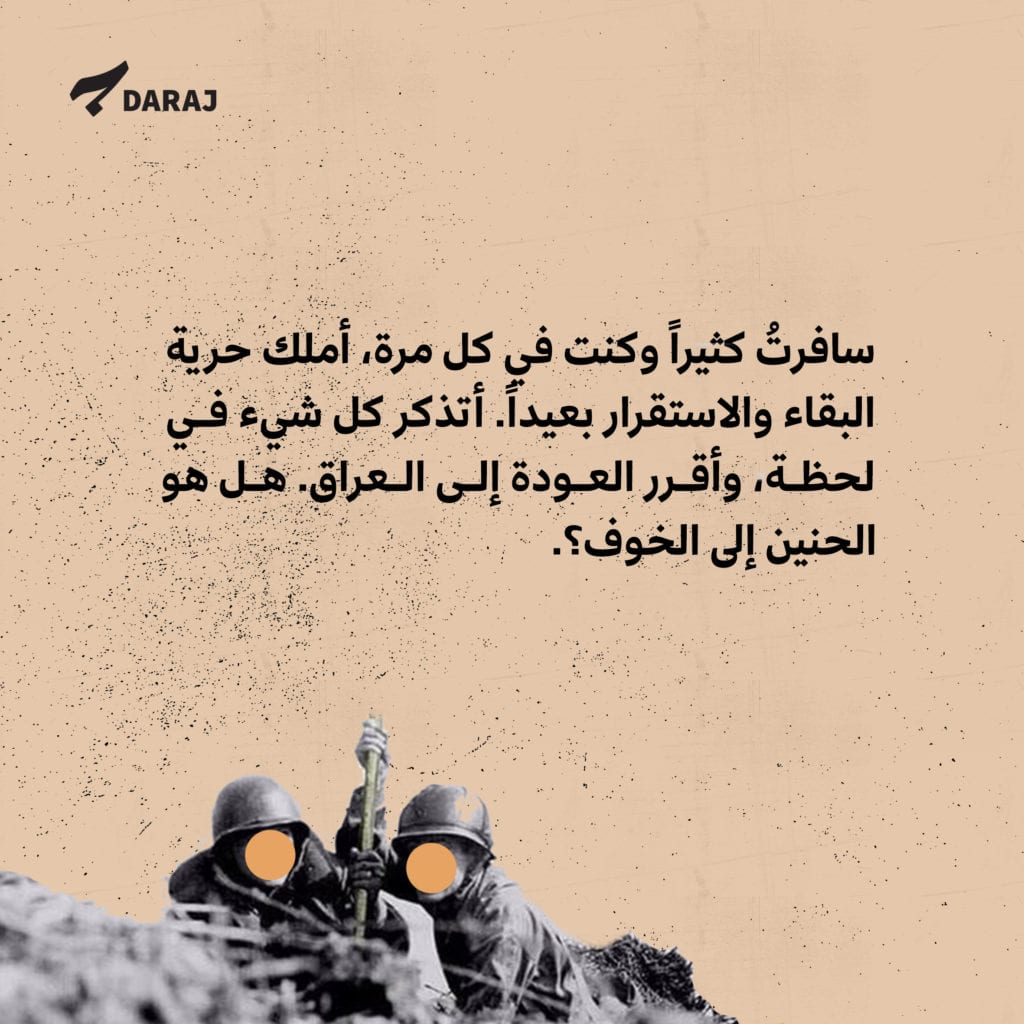
لم تقدم الحرب أي حرية، أو مستقبل، بل مجرد وجوه قمعية، تكرر الأساليب ذاتها، وتتناوب على الانتقام والقتل. أصبحت أتخيل الوجوه كلها ملطخة بالدماء.
من الجيد ان والدي أعاد شراء بعض الكتب ولم يضطر بعدها لبيعها حتى نأكل، كانت الحرية كما قال، في قلوبنا. مع كل معركة وقصف كان يذوي الأمل وينمو الموت. أما الأمل فصرت أبحث عنه مثل مجنونة بعد تخرجي، حتى مع دخول “داعش”، بقي البحث عن الأمل شاغلي. كان كل حدث يذكرني بشريط طويل من الأسى، يعيد نفسه تلقائياً بعد كل حادثة وخبر مفجع. لم تكن هذه الحياة التي حلمت بها. أريد بلداً يحبني، ثم أتذكر أنه مجرد أرض. والخطأ لا يصدر من جماد ساكن، لعله خطؤنا، خطأ التمسك بالحياة بالحرب والقتل، خطأ السلاح الذي صار متوفراً باياد لا تريد سوى النجاة على حساب الآخرين، لقد مزق العراقيون بعضهم بعضاً من دون أن ينتبهوا، نهشوا لحم ناسهم، بأسنان عقدهم الخائفة من صدام ومن لحقه، حتى وجدوا أنفسهم، يأكلون حياتهم، ولا يعرفون كيفية التوقف.
سافرتُ كثيراً وكنت في كل مرة، أملك حرية البقاء والاستقرار بعيداً. أتذكر كل شيء في لحظة، وأقرر العودة إلى العراق. هل هو الحنين إلى الخوف؟
لا أعلم، لكن الحرب أخذت مساحتها الكافية في روحي حتى جعلتني جزءاً من هذا المكان، جزءاً لا يستطيع الابتعاد، أو النسيان، او حتى التغاضي.
وضع مربك، وحبال ممتدة للحياة، تسحبني منها، حبال أخرى صنعت في بلد الحروب، أجاهد لأعيش، وأتذكر كل يوم، الذين خسرتهم، ولا أملك سوى أن أكتب عنهم.
إقرأوا أيضاً:










