لطالما تم الاحتفاء بالشيخ إمام والشاعر أحمد فؤاد نجم، يساريّاً باعتبارهما نموذجاً مثاليّاً للثقافة الشعبية المُقاوِمة، وهي ثقافة كانت، ولا تزال، تُوصف بأنها إيجابية، إلا أن أسلاف اليسار، الذي سميَّ الآن بالأرثوذكسي، من اليسار الثقافي المهووس إلى درجة المرض بتطهير اللغة من الشوائب غير اللائقة، وُضِع الثنائي على كرسي الاعتراف بجرائم تتعلق بالذكورية والتحريض على انتهاك أجساد النساء.
وحصلت أغنية “على المحطة” على النصيب الأكبر من الهجوم، وتم تحديد حيثيات الاتهام في كلمات الأغنية التي وصفت بأنها تحرض الطبقات الشعبية على العنف الجنسي ضد نساء البرجوازية، فيما يتمثل في كلمات الأغنية: “هو يعني الكون هايخرب لو الفقير يلهط له لهطة”.
وبخفة يد تحليلية تم تأطير الأغنية كاستراتيجية طبقية إجرامية وضعها الشيخ إمام ونجم للطبقات الشعبية، أو منحاها الشرعية على الأقل، للانتقام الطبقي من الأغنياء عبر انتهاك أجساد نسائهم.
ولأن أغنية واحدة خارجة على قاموس الصواب السياسي لن تكون كافية لإدانة نجم وإمام بالذكورية والتحريض على النساء، فقد تم تأويل أغنية “هما مين واحنا مين” وخصوصاً جملة “النسوان المتنقية” بأنها تصف النساء الجميلات كبضاعة استهلاكية تحظى بها الطبقات الحاكمة وحدها.
هذا النقد يعد انقلاباً حقيقياً على معجم اليسار لمصلحة منطق التفوق الليبرالي على المجتمع، فالليبرالية المصرية، في نسختها الأخيرة، تختصر مجمل المشكلات الاجتماعية في تخلف المجتمع وسعيه إلى تشييء المرأة واعتبارها جسداً لا أكثر، ولأن نجم وإمام ممثلان للثقافة الشعبية فقد تم إدراجهما بسهولة ضمن هذا المنطق الذكوري.
من الأمور الأكثر إثارة في هذا السياق أن أولئك الرجال (والنساء أيضاً) الرازحين تحت نير القهر الطبقي يدركون، من دون أن يحصلوا على تأهيل نظري عالٍ، أن الجمال سلعة تباع وتشترى وبالتالي يحوزها الأغنى، أو صناعة تخدم من يدفع، كما يقول الباحث المصري مجدي عبد الهادي لـ”درج”.
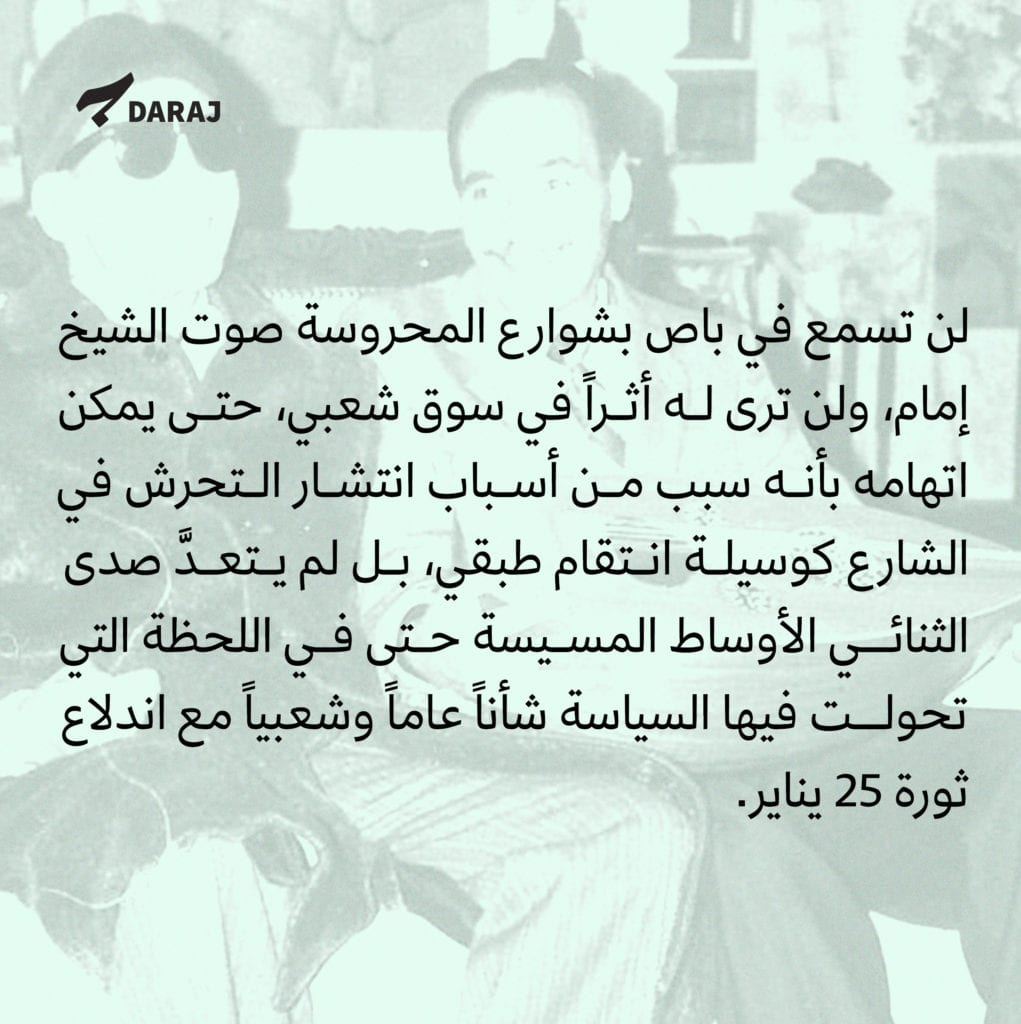
يتمثل جزءٌ من أذى القراءة الثقافية للظواهر، في العمى الإيديولوجي، فالشيخ إمام ونجم شعبيان بالانتماء الاجتماعي لكنهما نخبوييان في الإنتاج الفني، وأبسط قراءة لتراثنا الفني تؤكد أن ظاهرة “حوش آدم” لم يتم الاحتفاء بها خارج الأوساط اليسارية التي اعتبرت التثقيف مهمة مقدسة.
وبالتالي لن تسمع في “باص” بشوارع المحروسة صوت الشيخ إمام، ولن ترى له أثراً في سوق شعبي، حتى يمكن اتهامه بأنه سبب من أسباب انتشار التحرش في الشارع كوسيلة انتقام طبقي، بل لم يتعدَّ صدى الثنائي الأوساط المسيسة حتى في اللحظة التي تحولت فيها السياسة شأناً عاماً وشعبياً مع اندلاع ثورة 25 يناير.
لكن حتى يتم تدعيم الحكم الصادر على الشيخ إمام ونجم بالذكورية، وُضعت أغنية “شيد قصورك” على لائحة الاتهام، فالأغنية تستنكر وجود “الخمارات جنب المصانع”، وبغرابة تم استنباط رجعيتهما الاجتماعية بوصفهما يرون في الخمرة حراماً، ورمزاً للهو الأثرياء.
هذه الاتهامات تؤكد فصاماً لا شفاء منه بين اليسار الثقافي والواقع، ففي الثقافة الشعبية هناك دائماً تمييز بين الخمر باعتبارها “مشروب خواجاتي” وبين الحشيش باعتباره “دخاناً شعبياً”، والأمر لا يتعلق بحرمة أو حِلْ الخمرة، بل بالتفضيلات، وبالتالي التمايزات، الطبقية فيما يخص الكيف، وليس هناك أمر في الحياة الثقافية المصرية أشهر من الولع العظيم للشيخ إمام ونجم بالحشيش.
ويبدو أن هناك ضرورة للفت انتباه القائمين على تطهير التراث، إلى فيلم الـ”كيت كات“ففيه يقول “الهرم” (نجاح الموجي) لـ”الست فتحية” (جليلة محمود) وهو يعطيها سيجارة حشيش: “بيني وبينك يا ست فتحية قعدة البيرة دي قعدة خواجاتي قوي، مافيش أحلى من القعدة البلدي الحلوة (العامرة بالحشيش طبعاً)”.
سيجد هنا المغرمون بالصوابية السياسية ضالتهم بفتح قوس الاتهام لضم المخرج داوود عبد السيد إلى جلسات المحاكمة، ومع مد الأمر على استقامته تمكن محاكمة سيد درويش الذي غنى للحشيش ولم يغنِ للبيرة، فالأمر لا يسلم من رجعية بصدده أيضاً.
خيط الخطاب الأبيض وخيط الواقع الأسود
محاكمة من هذا النوع تنكر أي تمايز بين الخطاب والواقع، بين ممارسة التحرش والكلام عنه، فهي لعبة تستبدل الواقع المادي باللغة لتصل إلى نتيجة مفادها أن لا شيء أهم من الكلام، وبالتالي تظهر حساسية مبالغ فيها من هذا القبيل في ما يتعلق باللائق وغير اللائق.
وليس أفضل من الصوابية السياسية وتطهير اللغة واعتبار العالم عبارة عن خطاب، لتؤكد أنه حين تجنح تجربة سياسية، كاليسار في مصر، إلى السقوط، تضطر إلى عملية استبدال واسعة النطاق لمعنى وشكل السياسة، من السياسة الصلبة إلى شكل سريالي من السياسة على رأس أولوياته “تحطيم الأوثان” وإعادة فرض شكل من البداهة الأخلاقية (ميتافيزيقية ومثالية تماماً ولا يمكن النفاذ إلى منطقها ولا نقده) كمسطرة يتم محاكمة كل شيء وفقاً لها: الفن، العلم، الدين، الحياة الخاصة حتى.
تفتيت السياسة لمصلحة القضايا الجزئية (والإثارية طبعاً) يوفر لليسار الذي تخلى عن مقتضيات يساريته شيئاً من العزاء، ففي مرحلة لا يبدو هناك أفق للنضال السياسي ولا القيام بفعل طويل الأمد كبناء نظرية وتأسيس تنظيم، يغدو النضال ضد “الأعداء الصغار” (بما فيهم الأموات) عملاً مريحاً ومرضياً.
مؤكد أن أنصار الصوابية السياسية في مصر لم يطالبوا بإلغاء تراث الشيخ إمام كلياً، ليس لعقلانية مفترضة لديهم، بل لأنهم لا يملكون سلطة مثل جماعات الهوية الأميركيين، لذا تطغى النبرة الأخلاقية على أحكامهم، إلا أنه في واقع الأمر بعد أن تم”فضح الشيخ إمام من منظور نسوي”صار أي شخص يعتبره رمزاً مُعرّضاً للاتهام بالذكورية.

إنه لمن المزري أن يتم تسقيط مقاوم شعبي كالشيخ إمام، أخلاقياً، عبر مسطرة “قيم الصواب” التي يتم تصويرها كقيم ميتافيزيقية: عابرة للتاريخ وللسياق الاجتماعي وكونية وفوق كل شيء، وبصياغات ملتبسة من قبيل “فصلت من الشيخ” وأخرى تنكر على النساء التي تستمع لأغاني الشيخ من دون أن “تقفل منه مزاجيّاً وعاطفيّاً”.
في هذا الجو المفعم بالالتباس وعدم التحديد و”الحكم بالإحساس والإيحاء”،سينعقد النصر، دون شك، للقوى الملائكية المحصنة التي تناضل ضد “النجاسة الأخلاقية” في الخطاب على أنقاض الطاقات السياسية المُبددّة في الشوارع، في مجتمع هامد ومهزوم وفي قمة انحلاله السياسي.
أنطونيو غرامشي كان أكثر خبرة منّا في لحظات هزيمة كهذه، إذ اعتبر في “كراسات السجن” (الكراس 17 تحديداً) أن البلاد التي يحكمها نظام استبدادي يصادر الحياة السياسية يصبح الحكم فيها غير سياسي بل مجرد وظائف تقنية تتعلق بالبروباغندا والنظام العام والتأثير الأخلاقي والثقافي، وعلى الناحية الأخرى تُخاض الصراعات في المجتمع كما في لعبة “الغميضة” فتصبح الغلبة للوظائف الثقافية وتمسي اللغة السياسية لغواً، أو بعبارةٍ أخرى، تتقنَّع الأسئلة السياسية بقناع الأسئلة الثقافية، وعلى هذا النحو تصبح متعذرة الحل.
تطهير التراث
ظلت العلاقة بين السينما الأميركية والرقابة الأخلاقية متوترة، تخضع السينما أحياناً وتتمرد أحياناً، في البداية استثنت المحكمة الأميركية العليا عام 1914 السينما من بند حرية التعبير المنصوص عليه في الدستور، حيث تم اعتبارها نمطاً من “العرض الترفيهي” الذي تمتد إليه يد الرقابة بحكم امتلاكها تأثيراً هائلاً في المشاهدين.
قاومت السينما حصار قوانين الرقابة بالتحايل وباستغلال عدم كفاءة تطبيق القوانين، لكن كان هناك تدخل أخلاقي من المنظمات الدينية التي تبنت استراتيجية الرقابة الخفية على الإنتاج السينمائي ووضع أكواد أخلاقية محافظة للمخرجين كيلا يخرجوا عنها، إضافة إلى تكتيك الدعوة إلى مقاطعة الأفلام التي لا تلتزم بالأخلاق المسيحية.
لكن بفضل الأفلام الأوروبية المتحررة من الرقابة قطعت السينما الأميركية شوطاً طويلاً في التحرر من الرقابة القانونية والتزمت الأخلاقي، إلى أن ضربتها موجة المكارثية في أواخر الأربعينات وحتى تظاهرات أيار/ مايو 1968، في هذا الوقت حصلت أكبر حملة تطهير عرفتها هوليوود ضد الفنانين الشيوعيين والأفلام ذات النزعة التقدمية عموماً، وفرضت “القيم الأميركية” (الكنسية، الأمة، العائلة) على الإنتاج السينمائي برمته.
يقول الكاتب سامي الكيال لـ”درج”، “منحت روح مايو 68 والثقافات المضادة: (النسوية، الحقوق المدنية، المثليين، الأقليات) السينما الأميركية جرأة لافتة في تحدي الأكواد الأخلاقية المحافظة، إلا أن هذه الثقافات نفسها بعدما صارت جزءاً من ثقافة السلطة، عملت على وضع أكواد أخلاقية “تقدمية” للسينما والفن عموماً”.
هذه “الأكواد التقدمية” تم مزجها مع الكود المسيحي القديم لإنتاج أعمال فنية مهادنة اجتماعيّاً ومحافظة أخلاقيّاً ودينيّاً، وملتزمة في الآن ذاته بقاموس النسوية وتدافع عن حقوق المثليين وغيرها من مفردات “سياسات الهوية”، بحسب الكيال.
حصاد الصوابية السياسية في أمريكا لم يكن مبشراً بأي معنى كان، ففضلاً عن مهازل الأوسكار ومعاييرها، بات مجمل التراث الفني في أميركا مستهدفاً في حملات التطهير و”القوائم السود” للأفلام غير اللائقة سياسياً، والتي من شأنها تغيير هوية السينما نفسها لتصبح وسيلة معقمة ومضمونة للتوجيه الإيديولوجي والإرشاد الأخلاقي.
الأمر لا يتعلق بالسينما فقط، فقد شهدت مدارس أميركية استبعاداً لروايات معينة، على رأسها رواية “أن تقتل طائراً بريئاً“، للروائية الأميركية هاربر لي، من مناهجها الدراسية، تحت ذريعة طابعها/موضوعها العنصري وما قد يترتب على هذا من ضرر على قسم من طلبتها.
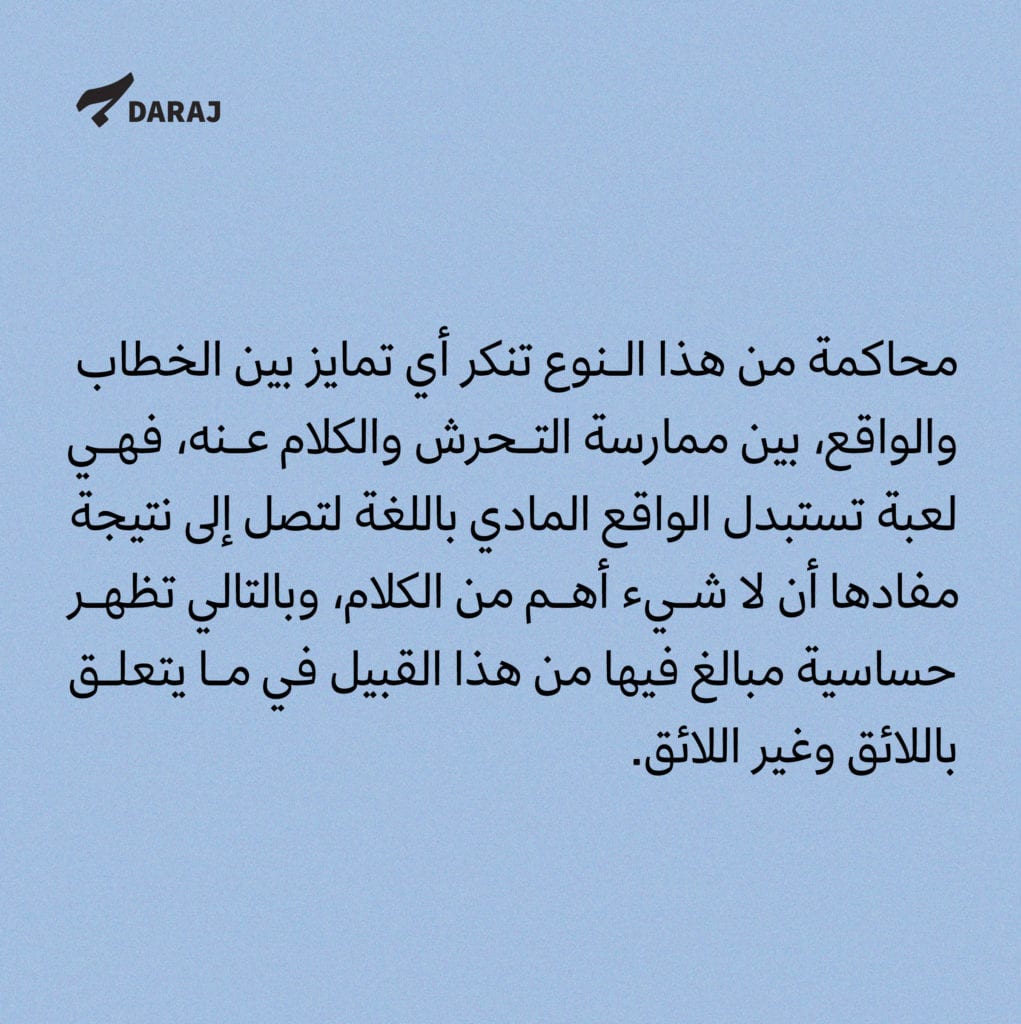
مع ذلك، أعادت بعض المدارس لاحقاً إدخال هذه الروايات إلى حرمها، بعد اتخاذ ما يلزم، أي تحويلها لمواد اختيارية، مع استبعاد الفقرات العنصرية أثناء تدريسها.
وفي نيسان/ أبريل الماضي حلت جامعة هوارد قسم الكلاسيكيات فيها، وتم توزيع أعضاء هيئة التدريس المؤيدين على أقسام أخرى، بحجة أن هذه الأعمال تُنمي النزعات اليمينية فضلاً عن أنها متحيزة إثنياً وحافلة بالتعبيرات العنصرية.
أصبحت الكلاسيكيات متهمة عموماً، ومجرورة إلى ساحة محاكم “الصواب السياسي”، فعام 2018 رأى مدير نشر “وايلدر” وهو بصدد إعادة نشر أعمال إيمانويل كانط، أنه من المناسب تضمين إخلاء مسؤوليته عن آراء كانط العنصرية في أسفل صفحة العنوان، كاتباً: “هذا الكتاب هو نتاج عصره ولا يعكس القيم ذاتها التي نتبناها. لكن قد يرغب الآباء في مناقشة أطفالهم كيف تغيرت الآراء حول العرق والجنس والعلاقات الشخصية منذ كتابة هذا الكتاب قبل السماح لهم بقراءة هذا العمل الكلاسيكي”.
بالوصول إلى هنا وبالعودة إلى ذكر ماركس، الذي أصبح كلاسيكياً، سنكتشف أن ماركس نفسه أصبح متهماً بمعاداة السامية وبإساءة تصوير الأقليات بسبب حديثه عن اليهودي “المُرابي” في دراساته حول تطور الرأسمالية في أوروبا، وشكسبير الذي كان مولعاً به، على رغم تناقضهما الفكري ومتهماً بالتهمة نفسها بسبب مسرحيته “تاجر البندقية“.
في المحصلة، الشيء الوحيد المنسي في النقاشات التي دارت وتدور حول ذكورية الثنائي: الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم، أن هذا الاتهام، منزوع السياق، وليس مرتبطاً بضررٍ ترتب على أغانيهما، بل يتعلق وبالأساس بطبيعة “البارادايم” النسوي في مصر، وهو مترجم بالكامل (كما حدث في حملات مي تو).
في مجتمع ما زال التحيز الجنسي حاضراً فيه، لن يكون الحل بترجمة مفاهيم واستراتيجيات “التطهير” وتوطينها محلياً (على طريقة موقع إيجي بيست لقرصنة الأفلام وترجمتها) وبالتدريج، ومدها لتشمل التراث الفني، بل بالاشتباك أكثر مع الواقع الصلب لحاضر الانتهاكات، ففي الواقع يكمن أساس النظرة إلى الماضي، سواء باستنساخه وتقمصه وحمل إرثه المُّر، أو بمعرفة كيف ساهم في تطورنا الروحي والأخلاقي، هو المطلوب دوماً في أي حركة تحرر.
وحين لا يكون هناك تغيير راديكالي قيد الاشتعال، لا يكون هناك طلب على المعرفة الدقيقة الصارمة للاقتصاد السياسي والتركيب الاجتماعي للطبقات، وحين يكون النظام السياسي عاقراً وجامداً وصلباً، سيكون من الطبيعي أن يحفل المجال العام بأشكال متباينة من الطهرانية الزائفة والطوباوي وادعاءات التفوق الأخلاقي، سيكون هناك ببساطة بديل مثير (وفضائحي أحياناً) للعمل السياسي كما عرفه البشر منذ بداية التاريخ المدوّن.
إقرأوا أيضاً:








