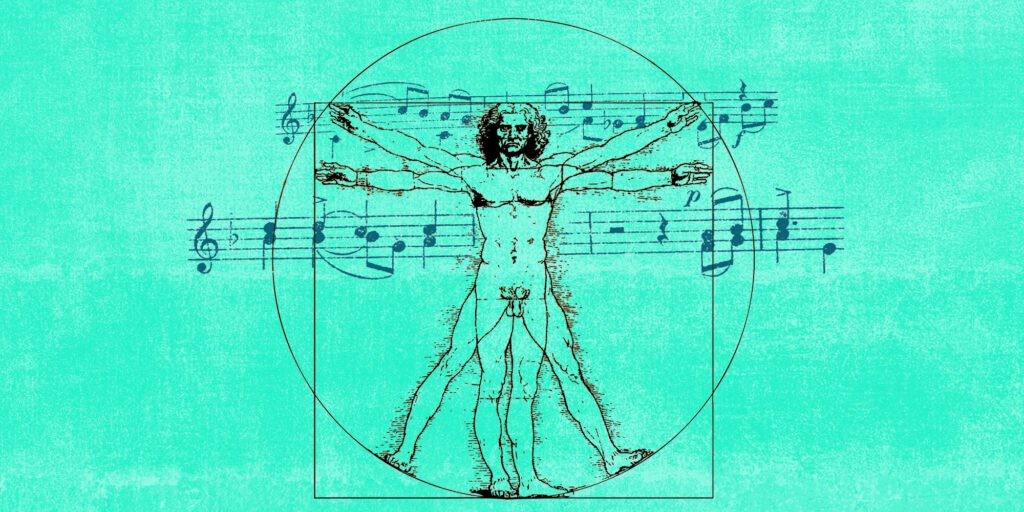تُبَشِّرُنا أغنية وطنية لبنانية معروفة بأنّ لبنان راجع، في لازمةٍ كلامية تتكرر من أولها إلى آخرها: “راجع راجع يتعمّر/ راجع لبنان/ راجع مِتحلّي وأخضر/ اكتر ما كان”. هي الأغنية الأكثر شهرة للفنان الراحل زكي ناصيف، وقد لحّنها وغنّاها بصوته بُعيْد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
بيد أنّ كلاماً في هذه الاغنية لا يُفصِحُ عن أمور قد تكون أكثر أهمية من بُشرى الرجوع. أمور تبقى أسئلة مُعلّقة من دون إجابات، مثلاً: متى يرجع لبنان؟ مِن أين يرجع؟ مَن يُرجعه؟ ولمن يرجع؟ أمّا السؤال الأهم، أيّ لبنان تحديداً سيرجع؟
لا يبدو أنّ كاتب كلمات الأغنية كان بصدد التصدّي لمثل تلك الأسئلة. هو فقط يُصِّر على كوْن الرجوع أمراً حاصلاً لا مُحال، واثقاً من أنّه “راجع مِتْحلّي وأخضر أكثر ما كان”. وقد فاته والمغني، وربما المستمعين أيضاً، أن الرجوع هو فِعل ينطوي على نكوصٍ في الزمن والسيْر به إلى الوراء. سيْرٌ مُثقلٌ بحنينٍ إلى ماضٍ مُشتهى، يُراد به وعداً يُشبِهُ كذا من الوعود بِرجْعةِ أنبياءٍ ورُسُلٍ وأئِمّة.
رُبَّ قارئٍ يقول إنّي أُحمِّل كلام أغنية أكثر مما يجب. وهو قولٌ منطقيّ. فمن ناحية، هي كلماتُ أغنيةٍ من نوع وطنيّ، جُلّ ما تصبو إليه هو بثّ الروح الوطنية بين أفراد الشعب الواحد، وحثّهم على الشعور بالفخر والانتماء إلى وطنهم.
إقرأوا أيضاً:
ولكن مهلاً! ليس المقصود هنا هذه الاغنية حصراً، كما ليس هدف المقال معالجة أغاني المُلحن زكي ناصيف، الذي أعتبره الأب الأول للأغنية اللبنانية الصرفة. فالمقال يدعو الى مُساءلة مفتوحة لمجمل النص الخطابي للأغنية اللبنانية المسماة وطنيّة.
وفي معرض هذه المُساءلة، يجدر بنا التفكّر في معنى ومضمون كلمات هذه الأغاني مثل؛ الشعب، الأرض، حُب الوطن، والشعور بالانتماء إليه والفخر به. كما يحقّ لنا السؤال إلى أيِّ لبنان نريد الرجوع، فهناك أكثر من صورة واحدة عنه تتنازعها المُخيّلة الجَماعية لمُكوّناته. ومِنَ الواجب أيضاً التدقيق في وجهة السير التي نحثّ الهِمَم سعياً إلى رجْعةِ لبنان، والسؤال إلى مَن سيرجع هذا البلد؟ أإلى مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات أم إلى رعايا الطوائف والمذاهب؟
من زاوية هذه الأسئلة المشروعة، أزعم أنّ الأغنية الوطنية، التي من أهدافها حثّ الناس على التحلّي بشعور المواطنة والانتماء، هي أغنية عانت وتُعاني من أزمة مستعصية في خطابها الكلامي. أزمةٌ تتكشّف عن عوارض انفصامٍ حادٍ بين ما تُجْهِر به الكلمات وتدعو إليه، وبين الواقع المُعاش على صعيد الفرد والجماعات والدولة. لا يتحمّل صُنّاع هذه الأغنية وحدهم المسؤولية عن هذا الانفصام.
“راجع راجع يتعمّر/ راجع لبنان/ راجع مِتحلّي وأخضر/ اكتر ما كان”. هي الأغنية الأكثر شهرة للفنان الراحل زكي ناصيف، وقد لحّنها وغنّاها بصوته بُعيْد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
لم يكن تاريخ هذا النوع من الأغاني كله مأزوماً. فعلى الأقل كانت البدايات طبيعية في الأربعينات من القرن المنصرم مع نيْل الجمهورية اللبنانية استقلالها التام. في ذاك الزمن، تَرافَقت كلمات الأغاني الوطنية مع نضال كل مكونات شعبه الجديد في سبيل انتزاع الاستقلال من الانتداب الفرنسي. فجاءت الأغاني والأناشيد الوطنية من الأخوين فليفل وغيرهم منسجمة في الخطاب مع الحركة الاستقلالية الشعبية، وصادقة مع تطلعات مُكوناته إلى وطن ينصهر فيه الجميع داخل دولة جديدة وعصرية.
لأسباب كثيرة، ليس المقال مخصص لاستعراضها، فشلت الطبقة السياسية الحاكمة بُعيْد الاستقلال وإلى منتصف السبعينات من القرن الماضي في جعل ولاء المجموعات والأفراد للدولة وحدها. ولم تنجح في خلق شعور وطنيٍ موحّد لديهم. إنكارُ صُناع الأغاني الوطنية لهذا الفشل، حوّل خطاب هذه الأغاني إلى كلاماً زجلياً فولكلوريًا وأبياتاً شِعرية في وطنية مُصطنعة، اجتهد الموسيقيون في ابتكار الألحان المناسبة.
ازدهر هذا النوع من الأغاني الوطنية، فأنتج حيناً كلاماً يتغنّى بالطبيعة جبلاً وساحلاً، أرزاً وصنوبراً، مُضْفِياً عليها رمزية دهرية سرمدية. وحيناً آخر توسّل أحداثاً وشخصيات تاريخية في سبيل نسج أساطير وادعاء بطولات وطنية. وفي أحيان أخرى، سلك الكلام سكة سياحية في أسماء العلم من الذكور، وأسماء القرى والمدن كنوع من التأكيد على وحدة وطنية سياسية واجتماعية لا تتحقق إلّا بين طوائفه ومذاهبه الدينية.
هذا الازدهار شقّ طريقه تحت مظلة أفكار ميشال شيحا (1891 – 1954)، الذي كان أول من وضع الأسس النظرية للأُمة اللبنانية، ووصَّف شخصية اللبنانيّ “المُتميّزة”، وحدد دور لبنان الحضاري كرسالة تعايش بين الأديان، وجِسر عبور بين الشرق والغرب.
لم يعشْ شيحا إلى سنة 1958 ليشعر بأول زلزال عنيف هزَّ الكيان اللبناني. أمّا فيما لو قُدِّر له أن يعاين المقتلة الطائفية التي حدثت بين الأهلين في السنتين الأوائل من الحرب اللبنانية (1975) وبعدها، لكان اكتشف فداحة الخطأ في دفاعه المُستميت عن حكم الأقليات الدينية، وتمكينها من السيطرة على البرلمان اللبناني.
ومع تهاوي الصيغة اللبنانية أثناء الحرب الأهلية، اصطدمت الأغنية الوطنية اللبنانية بحائط مسدود الأفق، وارْتدّت شظاياها في كل الاتجاهات الأيديولوجية يميناً ويساراً، مُعلنة خواء معناها وانتفاء جدواها بفعل الانقسام والاحتراب الحاصل بين مكونات المجتمع اللبناني.
في تسعينات القرن العشرين ومع توقف الحرب الأهلية، ورُسوِّها على غالب ومغلوب، ازداد الطلب من جديد على الأغاني الوطنية. بدا أنّ لبنان يعيش حالة انتقالية، وفيها استعادت الدولة حضورها إنما منقوصة السيادة بفعل الوصاية السورية على كل مفاصل الدولة.
الاستقرار النسبي المفروض على اللبنانيين بقوة سلطة الوصاية، معطوفة على سياسة إعادة الإعمار في البلاد التي تولتها الحريرية السياسية آنذاك، ظهّر الحاجة مجدداً لدى السلطة الى أغنية وطنية تُعيد جمع شمل الطوائف المُتنابذة، في إيحاء بأنّ صفحة الحرب الأهلية السوداء قد طويت الى غير رجعة.
إنتاج الأغنية الوطنية في تلك المرحلة عاد في كلامٍ يُفيد بأنّ سيادة الوطن مُصانة، ولبنان راجع والحق لن يموت، واللبنانيون هم بالحقيقة أُخوة وعائلة واحدة ولو اختلفت انتماءاتهم الدينية وتقاتلوا ذبحاً على الهوية، وأنّ بَلِيّة الحروب في بلادهم الجميلة والتي ليس لها مثيل في العالم، أتوا بها إليهم من الخارج بهدف زرع الفتنة بينهم والتآمر على مستقبل وطنهم “الرائع”. فهُمْ، اللبنانيون، أتقياء أنقياء، اختاروا وطنهم حُباً وطواعية. أمّا رسالتهم في العيش المشترك فهي “مثالاً” يُحتذى بها.
أُعيدت الحياة الى الأغنية المُسماة وطنية بعد انحسار للأغاني التي راجت أثناء الحرب تحت شعار الأغنية السياسية المُلتزمة. فبالإضافة إلى كمية الأغاني المُنتَجة سابقاً لمغنين مُكرّسين تألقوا قبيل اشتعال فتيل الحرب وأثناءها، دأبت شركات الإنتاج الفنية بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية التابعة للسلطة في صناعة “نجوم” جدد في ميدان هذا النوع من الغناء. وترددت في الأثير أغانٍ وطنية جديدة ترطن بالصور الشعرية المُستهلكة ذاتها.
إقرأوا أيضاً:
جهود الموجة الجديدة من تلك الأغاني الوطنية في التسعينات وبداية الألفية الجديدة، لم تُنتج إلّا كلاماً فولكلورياً هزلياً، يقفز فوق واقع الشعب اللبناني الذي أمسى أقليات دينية مُتكارهة.
كلام يصطنع بطولات وهمية للشخصية اللبنانية حيناً، أو ينسب فضائل وصفات شبه إلهية الى الزعماء من السياسيين حيناً آخر.
بَيْدَ أن حاجة الجميع إلى هذا النوع من الأغاني كانت تتجدد كلّما طرأ حدث جلل هزّ البلاد والعباد. ففي حدثيْنِ كبيرين، الأول كان اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، والثاني تمثّل في انتفاضة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، استعادت الأغاني “الوطنية” تألقها في ساحتي رياض الصلح والشهداء، حيث تجمّعت حشود غير مسبوقة لِمُعظم المُكوّنات اللبنانية، للتعبير عن أملها بِوطنٍ سيد حر مستقل، ودولة القانون والمؤسسات.
إلا أنّ مجريات هذين الحدثين والخلاصات التي انتهيا إليها، من إحباط وخيبة، كشفت مجدداً الهزال والوهن الموجود في خطاب هذا النوع من الأغاني المُسمّاة حيناً أغنية وطنية وحيناً آخر أغنية سياسية ملتزمة.
أسارع الى القول بأني لا أحمِّل هذه الأغنية من حيث هي خطاب في وطنية وهمية، مآلات الفشل التي انتهيا إليهما هذان الحدثان، فأسباب الفشل تكمن في محاور كثيرة ليست للمقال علاقة به الآن. ولكن ما تجدر الإشارة إليه بقوة، وعلى وجه الخصوص، في أثناء انتفاضة 17 تشرين، هو وجود قدْر كبير من التناقض بين حاجتيْنِ متنازعتيْنِ في وعي المُنتفضين:
الأولى هي الحاجة الشديدة إلى تغيير النظام لفساده وسوء حوْكمته، والسير به إلى مستقبل متقدّم، وما تكشفه من تراكم في منسوب الوعي السياسي والاجتماعي عند معظم المُنتفضين.
في حين أنّ حاجتهم الثانية تشدّهم الى زمن مضى يعتبرونه “زمناً جميلاً”، وتتمثل في تعلُّقهم الشديد بأغانٍ تقول كلاماً مُستهلكاً وخشبياً في الوطنية. وهي حاجة تُجسّد، وعياً أدنى مستوى من حاجة التغيير، وفيها يُستعاد وبحنين منقطع النظير لصُورٍ كلامية ماضويّة عن لبنان الوطن، والشعب والدولة.
صوت الطبل مترافقاً مع الهتاف الأكثر شهرة للمنتفضين في ساحات 17 تشرين من بيروت وجل الديب الى طرابلس ومن صيدا وصور الى النبطية، “بدنا نغيّرالنظام” عبَّر عن توق للتغيير لمستقبل أفضل مجهول المعالم، في حين أنّ أصوات “نجوم” الغناء اللبناني وعلى تنوع مشاربهم، فرضت نفسها على فضاء الساحات، فعبّرت عن حنين للرجوع الى ماضٍ معلوم بكل ما فيه من تهافت.
أغاني الحنين إلى الماضي التي بُثّت في ساحات الانتفاضة لأشهَر نجوم الغناء في الوطنية، أتت نافرة ومتناقضة مع صرخات حناجر المُنتفضين الداعية الى تغيير النظام، فكان من شأنها أن حوّلت الانتفاضة الشعبية إلى ما يُشبِهُ الكرنفال الفولكلوري بطابع ترفيهي عام.
بالتأكيد لم يُشكّل هذا التناقض بين الحاجتيْن سبباً مباشراً لِما آلت إليه الانتفاضة من فشل ذريع، إنما كانت علامة فارقة تدعو الى الحيرة والتعجب، ومؤشراً سهل القراءة الى النتيجة المُحبِطة التي انتهت إليها هذه الانتفاضة.
إني إذْ أُسائل هذا النوع من الأغاني منتقداً خطابها الوطني السطحي والخشبيّ، إنما في الوقت نفسك مُدرِك تماماً إلى أنّ خلق الشعور الوطني الواحد والموحِّد لدى اللبنانيين واللبنانيات وزرع الانتماء الى الوطن في نفوسهم، لا ولن يتحقق عبْر الأغاني الوطنية وكلامها التعبوي والحماسي. إنما هو بالضرورة يبدأ من نقطة أساس، ألا وهي قيام الدولة المدنية – العلمانية التي تعتمد الفصل التام بين الدين والدولة، ويكون لهذه الاخيرة وحدها حق احتكار السلاح وقرار الحرب والسلم من دون منازع أو منافس.
إنها دولة القانون والمؤسسات، حيث يتساوى الجميع في الحقوق والواجبات كأفراد ومواطنين وليس كرعايا للطوائف الدينية.
هي دولة واقعية وليست يوتوپيا، حيث نماذجها الناجحة منتشرة في معظم بقاع العالم، ويحمل جزء من اللبنانيين جنسيات دولها في حين يستميت الجزء الباقي للحصول عليها.
أكادُ – وربما مع غيري من الأفراد اللبنانيين – أنْ أفقد الأمل في تحقيق مثل تلك الدولة على الأقل في الزمن المتاح لنا. على أي حال، والى ذلك الحين، يبقى السؤال؛ ماذا سنفعل بكل هذا الركام من كلام الأغاني في “الوطنية اللبنانية”؟!
من جهتي، سأسعى إلى فرز هذا الركام الى قسمين. فرزٌ يُشبِهُ الطريقة المُتبعة في النفايات المنزلية. سأحتاج إلى مستوعبين فقط؛ الأول أسميه كراكيب الحاضر القابلة للتدوير. أضعُ فيه بعضاً من الأغاني الوطنية المُنتقاة بعناية فائقة، والتي لُحِّنت في القرن الماضي، بعد أن أكون قد أزلْتُ عنها غبار كلماتها المُتخشِّب، مُبقياً على اللحن فقط. ثُمّ أُغلق المستوعب جيداً بعد ترتيب الألحان بعناية واضعاً في جنَباتِها قليلاً من حبوب النفتالين تجنباً لمخاطر التلف. أمّا المستوعب الثاني فسأضع فيه كل ما تبقى من أغانٍ وطنية كلاماً ولحناً. وبعد إغلاقه بإحكام كي لا يتسرب منه أيٍّ من محتوياته، أختمه بالشمع الأحمر، ومن ثُمّ أُدوِّن عليه العنوان التالي:
ركام الحاضر من الأغاني الوطنية اللبنانية: ركام لا يصلح لأي شيء. منتهي الصلاحية ولا يُمكن تدويره.
إقرأوا أيضاً: