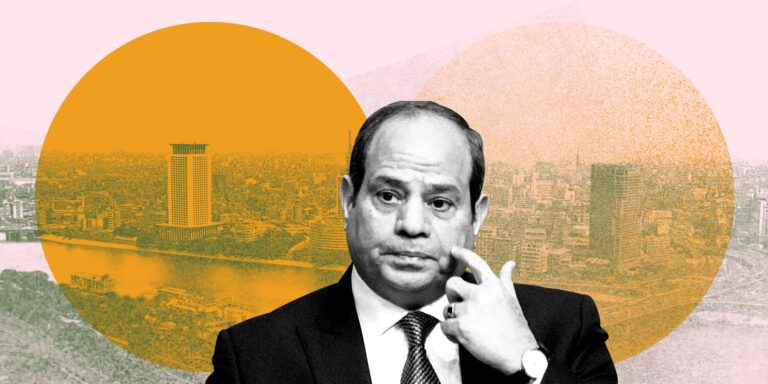خلال المؤتمر الاقتصادي المصري الذي عُقد في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عرض رئيس الوزراء المصري مُشكلات الاقتصاد التي كوّنتها السياسات والأحداث الماضية، ليتدخّل رئيس الدولة داعياً الجمهور إلى التفكير في هذه الأمور. وعلى شاشة العرض، ظهر اقتباس من كتاب “شخصية مصر” لجمال حمدان، يُشير إلى أن الاقتصاد المصري يفتقرُ إلى تبنّي حلول راديكالية جذرية، ويتمسّك فقط بالحلول الوسطية والمُسكّنة التي تؤجل الأزمات بدلاً من العمل على حلّها.
الاقتباس المذكور كان إسقاطاً على سياسات الاقتصاد المصري في الستينات، والذي لم يكن محلّ النقد وحده بين مُختلف المراحل السياسية في مصر، إذ اعتدنا سماع رئيس الجمهورية يوضّح للناس مدى كارثية سياسات سابقة بدءاً من الستينات وحتى أولى فتراته وما واجه النظام آنذاك – وما زال يواجه- من مصاعِب وتحديّات.
خلال عشر سنوات تفصلنا عن الأزمة الاقتصادية الحالية في مصر، بدأنا مع بشائر وخطاب ترويجي كبير، أهم ما كان فيه إعادة هيكلة منظومة الدعم الاجتماعي في مصر، على مُستوى بنية عملها وتحويلها إلى بنية رقمية ومُمكننة، وعلى مستوى تماسكها وتوفيرها مساحة أكبر من الدعم للمُستحقين. لكننا نقفُ الآن أمام منظومة دعم اجتماعي شديدة التهالك، والدولة بدورها لا تنتبه إليها أصلاً، لأنها معنيّة ببيع مزيد من الأصول لتعويض العجز عن سداد الديون.
الحديث عن الآثار الاقتصادية للسياسات السابقة ما زال قائماً، وتمثّلت ذُروته في تصريح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يُحمّل فيه السياسات الاقتصادية الماضية أزمة جيل الشباب الحالي وعجزه عن تحقيق أحلامه في ظل هذه الظروف، ويضيف أن الاقتصاد المصري حالياً يُصارع لتجاوز آثار هذه الأزمات، بخاصة على مُستوى السياسات الاجتماعية.
السياسات الاجتماعية هي الدعم الموجّه إلى المواطنين، عبر توفير سلع استهلاكية وحاجات أساسية للعيش، إمّا بالمجّان أو بأسعار رمزية في مُتناول الطبقات الفقيرة، مثل دعم مجالات الصحة والإسكان والمواصلات…
فضلًا عن عدم توفير شيء بالمجان، خاضت السياسات الاجتماعية وآليات الدعم، على امتداد الاقتصاد المصري الحديث، تحوّلات عدة، مراحل صعود وتطلعات كبيرة، هبوط وتداعٍ مُهلك، لذا فإنها لا يُمكن أن تُختصر في تصريحات الحكومة حالياً، التي تُحوّل الأمر إلى مسألة قُطبية وأن ما سبقنا كان فاسداً ونحنُ نتحمّل نتائج سياساته.
مُشكلات جماعيّة بالضرورة
في مقدمة أكسفورد عن دولة الرفاه، يُشير ديفيد غارلاند إلى ما أحدثته الهجرة الجماعية في المُدن، من تغيير في أسلوب عيش الناس، وإبعادهم عن مُجتمعاتهم الصغيرة والمحلّية. نمت المدن الحديثة وخلقت أنماطاً كثيفة وجديدة من الاعتمادية، فانعكست مُشكلات الناس الأفقر على من يعيشون بشكلٍ أفضل، ولم يعد هناك مفر من أن تصبح الحياة فعلاً جماعياً. ونتيجة لذلك، فإن المشكلات وما بها من حلول مُحتملة، باتت بالضرورة مسألة جماعية أيضاً.
ظهرت النوايا الأولى لوجود سياسات اجتماعية في مصر، منذ مشروع محمد علي وتأسيس رأسمالية مصرية مستقلة عن الخلافة العثمانية. مع هذا المشروع التحديثي، ظهرت التأمينات الاجتماعية لقطاع العاملين لدى الدولة. ظلّت سياسات الدعم مُتأرجحة بعد محمد علي، ولم تكُن في أولوية أي حاكم، كانت تظهر من وقتٍ الى آخر فقط على شكل منح وعطايا، محصورة في المُدن ولا تصل إلى القُرى والنجوع.
يُشير كتاب “مجانية أم خصخصة؟” إلى بدايات صعود الدعم الاجتماعي في صيغة روح التكاتف والشراكة الاجتماعية بين الشعب والمؤسسة. في الحرب العالمية الثانية، بدأت سياسة ترشيد الاستهلاك تُتداول بكثرة، لتوفير موارد تُرسل إلى الجيش.
دخلت مصر في ركبِ الدعم الاجتماعي، ووُضعت تسعيرات جبرية لمنتجات أساسية، وتم بدء العمل على تطبيق سياسة “التموين”، ثم تحولت هذه الخطوات إلى قرار مُقنن في 1945. تحولت الدولة إلى شريك تكافُلي يقوم بدورٍ اجتماعي لتخفيف أعباء المعيشة، كحالة استثناء، نظراً الى مُعاناة المجتمع المصري من تكاليف الحياة. آنذاك، كانت موارد مصر المختلفة تُستنزَف من الاحتلال الإنكليزي بسبب الحرب.
الرفاه الاجتماعي والدولة الناصريّة
اعتمدت اشتراكية الدولة الناصرية على الدعم الاجتماعي كأساس للحكومة، بمعنى أنها تكون الحاكمة في مسار الإنتاج بشكلٍ كليّ، وتُتيح لنفسها سُلطة عُليا ذات بُعد اجتماعي. لم تختلق المرحلة الناصرية الدعم، بل طوّرت أرضيته الناشئة سابقاً، وبدأت التوسّع في تأميم شركات والدخول في تسعيرة مُختلف المواد الاستهلاكية التي يعتمد عليها الجمهور، من مواصلات ومواد غذائية وأجهزة، وحتى الصناعات الثقيلة.
كان الدعم الاجتماعي الناصري قائماً على توظيف القطاع الخاص لخدمة السياسات الاجتماعية، إذ وضعت الدولة نفسها رقيباً يفرضُ تسعيرة جبرية على أصحاب المطاعم، والحد الذي بإمكان الفرد أن يأكله. نتجت هذه التصورات أولًا، من رغبة شمولية في هندسة مُجتمع جديد، استقلالي ومستقر، ومن جهةِ أخرى، كانت التخوفات النابعة من تبعات الحرب العالمية الثانية ما زالت قائمة.
مع مطلع الستينات، تُرجمت أهداف قيام الدولة على أساس الدعم وتوسيعه، من خلال حملة تأميمات واسعة، نتج من ذلك تضخّم دور الدولة الاقتصادي، من خلال ظهور شركات عامة، تضم تحتها حزمة من الشركات الصغيرة، يخدم أداؤها الجماعي مساراً اقتصادياً كُليّاً تُحدده الدولة. كان لهذه الشركات نشاطها الخاص، واستقلالها العملي عن الدولة في قوائم الربح والخسارة، لكنها تخضع لقيود بشأن التدخّل في خفض الأسعار، وتحويل فوائض القيمة الى خزانة الدولة العامة. وفي المقابل، لهذه الشركات حق طلب الدعم من الدولة في حالة احتياجها ذلك.
حوّل أساس اقتصاد الدعم الناصري عملية الإنتاج الى قيمة لها ميزة مبدئية، وهي أن المادة التي تُقدّم في السوق، أو يتم تداولها، هي مادة ذات قيمة استعمالية، تحضُر الدولة كوسيط أعلى بينها وبين الجمهور ليحصل عليها بسعرٍ رمزي أو مجاناً. أحد أبرز أمثلة هذا المسار، كان التحوّل في قطاع توفير الكهرباء للمواطنين، بخاصة في المناطق الريفية البعيدة والنجوع.
بسبب اعتماد مصر على الوقود البترولي، كانت تكلفته مُرتفعة، ولا يُغطي سوى 68 في المئة من إجمالي مُتطلبات الكهرباء داخل البلاد، مثلما يُشير محمد جاد في بحث “الرفاه.. من التعميم والمجانية إلى الخصخصة”. لذلك، قرر عبد الناصر تأميم قناة السويس، والاستفادة من مواردها لتمويل السد العالي وإنتاج كهرباء رخيصة من مورد دائم.
توافرت الكهرباء للضواحي والمناطق غير الحضرية، وفتحت وسائل معرفية وترفيهية مُهمة، مثل الراديو والتلفزيون لاحقاً، لكن هذه الآليات وُجّهت لدعاية سياسية، وعلى رغم أن طُموح التوسّع في الدعم كان جيّداً بالفعل، لكنه افتقر إلى منطق التعاطي مع إمكانات الدولة، فمع حل مُشكلة الكهرباء، كانت مُشكلات أخرى تتشكّل، مثل تجاهُل القطاع التعليمي ووفرة رؤوس أموال استثمارية راعية، وتهيئة سوق استيرادي يُنشّط السوق المحلّي.
من جهةٍ أخرى، لم تكُن خطوة التأميم مُنحصرة في طابع ثوري فقط، لأن التأميم ألزم الدولة إعطاء أصحاب الشركات تعويضاً عبر سندات بقيمة أصول الشركة المؤممة، وقد شكّلت هذه السندات كُتلة ديون على الدولة، ظلّت تتضخم أمام العجز عن السداد. جاءت فكرة التأميم مُرتبطة بتوسّع في منظومة الدعم وتوفير الرفاه للطبقة الوسطى الناشئة في الدولة الناصرية، لكن حصرية الإنفاق على سياسات الرفاه، جعلت الدولة محصورة في دائرة الاستهلاك فقط، ولم يكُن هناك بديل إنتاجي لتحقيق ربح.
تمسّكت الدولة الناصرية بمركزية الدعم لضمان استمرار عقدٍ ضمني مهم، يُشير إليه كتاب “مصر ناصر والسادات: الاقتصاد السياسي للنظامين” بأنه مُقايضة الحق الاجتماعي بالحق السياسي، أي الرفاه والحق في الدعم، مُقابل نزع الحق السياسي في المُعارضة.
إقرأوا أيضاً:
تحت عباءة الاقتصاد الجديد
فشل نموذج مركزية الدعم لأنه تعرض لضغط مالي مُستمر، والجهاز الضريبي بدوره كان عاجزاً بحُكم بدائيته عن الوصول إلى ثروات مُستترة، إضافة إلى وجود تعاملات اقتصادية وعمّالية غير مُنتظمة لي بإمكان لدولة تتبّعها، وبالتالي فقدت جُزءاً من الضريبة على الأجور لتمويل سياسات الدعم.
سارع السادات في التراجع عن هذه الهيكلة في 1974، وكانت هذه استمرارية لتراجع الدولة الناصرية قبل وفاة عبد الناصر، فتحوّل التأميم إلى عبء مالي لا تستطيع الدولة مُواكبة متطلبّاته. وفي مطلع الثمانينات، بدأت التطلعات الاستهلاكية تُواكب النظام الاقتصادي الجديد، الذي يدعو إلى التقشف في الإنفاق الاجتماعي. أمّن العالم على الصوت الأوروبي الداعي إلى تخلّي الدولة عن دورها الأبوي، هذا الصوت استقطع ضرورة “الدعم” من سياق مسؤوليات الدولة، وحصر المُحتاجين والفُقراء في إطار مجموعة كسالى يبحثون عن أموالٍ وخدمات مجانية.
بحُكم هشاشة أساسها الاقتصادي ونزع الاستقلالية، كانت الدُول النامية عاجزة محلياً، ولجأت بالضرورة إلى الدين الخارجي، وبالتالي كان الانفتاح على الاقتصاد العالمي ضرورة، وهُنا دخلت مؤسسات الإدانة وصناديق الدعم تحت إطار وضع “خطط إصلاحية جديدة”.
في كتاب “النظام القوي والدولة الضعيفة“، يعرض الباحث سامر سليمان تطورات تخفيض الدعم المُوجّه إلى فئات المُجتمع. بعد تراجع الدولة عن إجراءات 1977 بسبب انتفاضة الطلاب، تدفقت أموال خليجية كثيرة في 1980، وُظِّف جُزء منها في سياسات الدعم، كان الإنفاق عليها في تلك السنة 20.1 في المئة من مُجمل ميزانية الدولة، لكنه تراجع خلال حُكم مبارك، حتى وصل إلى 4 في المئة في 2001.
الاقتصاد “المُبارك”
ثمّة تداول شعبوي دائر حالياً، بأن أحوال الشعب قبل ثورة كانون الثاني/ يناير، كانت على الأقل أهون من ذلك بكثير، إذ كان الناس يجدون قوتهم اليومي، فالتموين والسلع الأساسية متوافران في السوق والأيام كانت تمر بأمان. تعود هذه الحالة إلى الجهل العام بالسياسات الاقتصادية، بخاصة في ملف الدعم خلال حُكم مُبارك، كما أن صُعوبة الأيام الحالية في الشارع المصري، تجعل الناس مُصابين بالحنين إلى أي مرحلة سابقة تبدو أنها أهون من ذلك، إضافة إلى التحميل السياسي من النظام الحالي على ثورة يناير، باعتبارها إحدى ركائز تراجُع الاقتصاد المصري حتى الآن.
حقق مُبارك القطيعة مع اقتصاد الدعم الاجتماعي تماماً، وخلال السنوات 1987- 1996 أبرم أربعة اتفاقات تمويلية مع صندوق النقد الدولي، بدأت الدولة الترويج لمدى صُعوبة الرفاه، وكون الدعم عبئاً كبيراً لا حاجة له، لأن مُستحقيه ليسوا أكثر من كسالى لم يتعلموا الاسترشاد وتحديد النسل والبحث عن فُرص عمل كبيرة توفرها الشركات الاستثمارية.
أدار نظام مبارك مسار الدعم الاجتماعي بشكل مُربح عبر التخفّي والتدريج، وتولّدت سُلطة حاكمة تقلّل من أهمية أي مُحاولة اعتراض، من خلال توجيه الدعم إلى العاملين في قطاع الدولة، وبذلك يتم تكوين بيروقراطية تُشكّل كُتلة دعم للحكومة، على الأقل إن لم تُصح بالمُباركة، فلن تعترض خوفاً على “أكل عيشها”.
أُطلق على مُستحقي الدعم من أجهزة الدولة اسم “محدودي الدخل”، وتحت هذا الإطار دخلت فئات كثيرة جداً، لم تتلقَّ سوى فُتات قليل يتناقص سنة وراء الأخرى، وطالما هُناك كتلة مُستقرة شعبياً، تأخذُ مساحة واسعة من الدعم الضئيل، وتمثّل إدارة المؤسسات الحكومية، فلن تكون هُناك معارضة فاعلة مهما ساءت الأمور.
يُطلق سامر سليمان تعريفاً جوهرياً لمرحلة مُبارك وهي “الجمود المؤسسي” القائم على ترتيب مشاريع، إعلانها للجمهور، ووضع مسميات كبيرة على الورق، لكن التغيرات الحقيقية تحدثُ بشكلٍ داخلي، تُفرغ هذه القرارات من مُحتواها وتجعلها بلا معنى فعلي ومؤثر.
دولة العوز الدائم
لم يتخلّص الاقتصاد المصري، مُنذ الدولة الناصرية، عن منطق الدولة “الرعوية” التي تقوم على استقبال عطايا من دُول أخرى بغرض الاحتواء والتدجين، إذ يعتمدُ اقتصاد الدولة على الدعم والمساعدات الخارجية. خلال حُكم عبد الناصر كانت مصر المتلقي الأول عالمياً من مساعدات الاتحاد السوفياتي، وخلال حكمَي السادات ومُبارك، كانت مصر الثانية عالمياً في تلقّي المساعدات الأميركية.
يتمثّل التوجه الاقتصادي المصري الحالي، من جهة الدعم، في خطابات رئيس الجمهورية المُتكررة للجمهور في كُل مناسبة، لا بديل دائم عن ضرورة أن ننضج، نُحرم لبناء دولة قوية، وعلينا أن نتحمل و “نجوع” حتى يكون لنا مكان على خريطة المنطقة. يتمثّل هذا النشاط الخطابي في دور سلوكي ورقابي، يُقيّم أداء المُواطن على أساس مدى قدرته على تحمّل الأعباء، والتي للمفارقة، تنتج من قرارت الحكومة.
من جهة الدعم، رُبما يحتارُ الشعبُ أي شيء يجب أن يتحمّله. ففي قطاع التموين، الذي يمثّل عصب تغذية المواطنين، تغيرت هذه المنظومة في 2014 تحت ظل رواج إعادة هيكلتها رقمياً للسيطرة على فاتورة الدعم والحد من تسرب السلع للسوق وتحسين مُستوى خدمة المواطنين.
نتجت من نظام التموين الجديد ذبذبة في أسعار السلع التموينية. وبعد تعويم الجنيه في 2016، بدأت الدولة في التراجع أمام انتشار السلع في السوق الحر، ليصل سعر لتر زيت الطعام في 2019 إلى 19 جنيهاً، هي قيمة تسعيرته ذاتها في السوق الحُر.
انخفضت نسبة كفاءة التموين في 2022 من حيث قدرته على تغطية مساحة أكبر، ليتراجع من 92 في المئة إلى 69 في المئة، بينما تراجعت تكاليف دعم الطاقة من 21.9 في المئة في 2012، لتصل إلى 1.03 في المئة في 2022، مع ضرورة اعتبار أن زيادة في مواد الطاقة والمحروقات ترفع من قيمة كُل المواد الاستهلاكية المُتداولة في السوق المحلّي.
في تقرير “من الدعم إلى السوق؟ خصخصة المنظومة التموينية وتحولات الدولة اليومية”، تُشير ماري فانيتزيل إلى خضوع منظومة التموين حالياً لتقليص المنتفعين منها، إذ إن الجمهور وقع تحت إطار حُرية شكلية، حيثُ القوائم المعروضة والاختيارات لا ترضي الحاجة الاستهلاكية. وفي المقابل، تحول القطاع الخاص، الذي يجب أن يحجّم دوره في هذا السياق باعتباره سوقاً موازياً، إلى منظومة لديها مساحة واسعة من الوصول إلى جمهور مُجبر على استهلاك هذه المواد، وبالتالي يُتاح فتح هامش تحقيق مزيد من الأرباح، من سيتوقف عن شراء زيت وسُكّر مهما ضاقت به الأحوال؟
في إطار المسارات الاقتصادية الجديدة في 2024 عقب إنقاذ الاقتصاد المصري، شكلياً، من خلال بيع منطقة رأس الحكمة، تعاد هيكلة دعم قطاع المستشفيات. إذ رُفعت قيمة التذكرة في العيادات الصباحية من جنيه واحد إلى 10 جنيهات، بينما تراجعت نسبة العلاج المجاني من 60 في المئة إلى 25 في المئة فقط. ونتيجة لخطوة التعويم الأخيرة، على الأرجح سيتم التخلّي عن قرار عدم رفع أسعار المحروقات مرة أخرى، بخاصة السولار، بسبب تأثيره الكبير على التضخم، بينما من المتوقع زيادة السلع التموينية –على رغم عدم وفرتها لا في منافذ توزيع التموين ولا في السوق الحُر- عقب نفاد مخزون الحكومة من المواد المتوافرة، إذ إنها ستعتمد شراء دُفعة السنة المقبلة بالقيمة الجديدة للجنيه.
يأتي تخلّي دور الدولة وتجاهلها مسؤوليتها في الدعم وتنمية ملف السياسات الاجتماعية، ليُتيح فُرصاً أكبر للقطاعات الاستثمارية الخاصة التي تشتري أصول وشركات من الدولة، وتجعل المواد الاستهلاكية الأساسية مادة قائمة تماماً على الربح وتنمية رأس المال، ليتحقق مزيد من التحلل لما تبقى من الطبقة الوسطى في هذا المجتمع. هُناك فئة تُحاول الارتقاء، تُخلّص الدولة من عبئها بالاعتماد على تعليم خاص، ومواد استهلاكية مُتاحة للجميع في السوق، وتقوم علاقتها بالدولة على المعيشة فقط، بينما الجهة الأخرى، تتشبّع بحقدٍ مُستحق من وفرة الشعور بالحاجة وسعة الفارق بين قيمة مواد المعيشة والقدرة الاقتصادية المحدودة، ليفتت عُنصر “الحل الجماعي” الذي ذُكر في مطلع المقال، إذ لم تعد المُشكلات جماعية، ولم يعُد هُناك شكلٌ إلزامي في العلاقة بين المجتمع ومسؤولية الدولة تجاهه.
بطبيعة الحال، لم تكن سياسات الدعم في الاقتصاد المصري سابقاً، أياً كانت المرحلة، في أفضل حالاتها، ورُبما تركت مرحلة مُبارك تحديداً آثاراً اقتصادية كثيفة السلبية، إلا أننا على الأقل، في ظل التوجهات الحالية، نشهدُ مُستوى غير مسبوق من تجاهل الدعم المحلّي، ويزداد من خلال استمرار تجهيل ضرورات الاقتصاد المحلّي كلياً، لصالح توجهّات ومشروعات إنشائية لا حاجة لها على الأقل حالياً.
نهايةً، ما نُعاصره حالياً من وصاية على جوع الناس، ليس بجديد، إذ كان الرئيس مُبارك في ذكرى عيد العمّال في الأول من شهر أيار/ مايو، يُلقي خطاباً ينهُيه بعلاوة شحيحة لموظفي الدولة. وعند كل أزمة اقتصادية جديدة، تُحشد أصوات صحافية وإعلامية مؤيدة، تُرسّخ لمفهوم ضرورة الزهد وعدم الإسراف في الطعام. وفي أحد مواسم المولد النبوي، أشار مبارك إلى وصايا الرسول بالعمل الجاد وتجنّب الإسراف الذي سيساهم في حل المشكلة الاقتصادية.
هذا لا يختلف كثيراً عن وصيّة رئاسية جديدة تقول “أوصيكم بنفسي وبالاستقامة والزُهد !”.