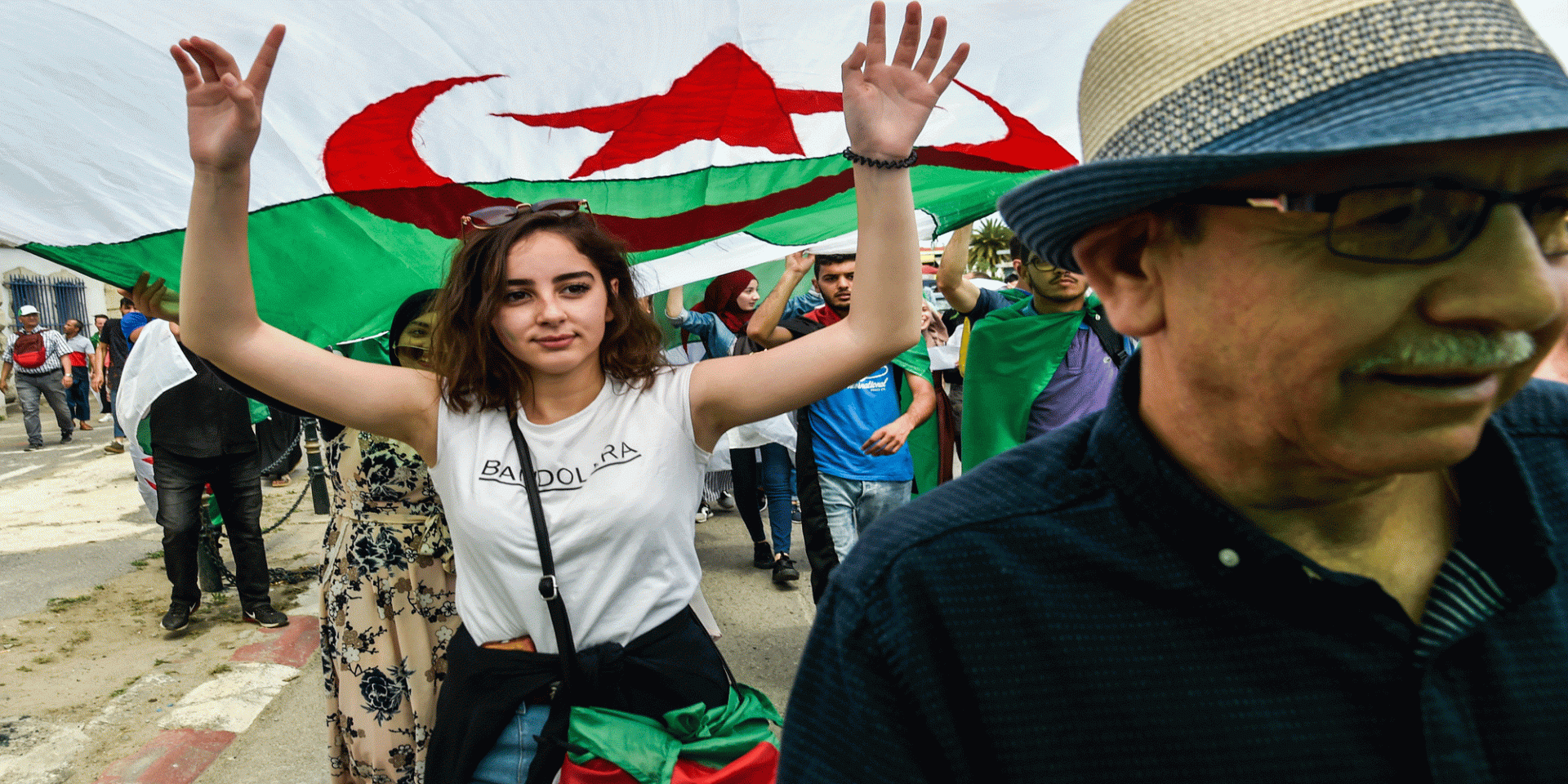من يقرأ كتاب توما سير الذي يتناول بشكل رئيسي العُهدات الثلاث اﻷولى لعبد العزيز بوتفليقة، يدرك أن سؤال “من هو حاكم الجزائر الفعلي؟”، لا معنى له. فمن خلال دراسة شاملة ومعمّقة لهذا البلد، دولةً ومجتمعاً، سعى الباحث الفرنسي والمُدرّس في جامعة كاليفورنيا- سانتا كروز إلى تبيان الطابع المُنْبَثّ للسلطة وإلى تميُّز الحقل السياسي الجزائري بالحيرة وبالتفكّك. وفي وسط اﻷحداث النوعية والمُتسارعة التي يمرّ بها البلد منذ أواخر شهر شباط/ فبراير الماضي، يأتي نشر هذا العمل في الوقت المثالي، إذ يمدّ القارئ بالخلفيّة الضروريّة لتلافي إطلاق اﻷحكام والاستنتاجات المتسرّعة
قد يلفت نظر الكثير من اﻷكاديميين العاملين في مجال العلوم الاجتماعية عدم تضمّن عنوان الكتاب – بشقّيه الرئيسي والفرعي- موضوعاً ملموساً. فـ”الجزائر أمام الكارثة المعلّقة. إدارة اﻷزمة وتأنيب الشعب أيّام بوتفليقة (1999-2014 )”، عنوانٌ يبدو، على رغم فرادته، شديد العمومية. إلاّ أنّ توما سير استبق هذا النقد بشرح منهجية عمله في مقدّمة الكتاب. فَعِوَض أن يحصر مُحاوريه الجزائريين في فئة اجتماعية أو مهنية أو سياسية حددّها هو لهم مسبقاً، فضّل باحثنا أنّ يَدَع لهم المجال لكي يفرضوا أنفسهم عليه من خلال شهاداتهم وتجاربهم. وبتنظيمه تلك الشهادات والتجارب التي بدت بمنزلة “شذرات حقيقة مُبعثَرة”، قدّم توما سير طرحاً نظرياً مهماً، ولم يخْفِ طموحه أن يحذو، في هذا المجال، حذو المفكّر اﻷلماني فالتر بنيامين.
بقدْرٍ من الخيبة، يشير الباحث إلى أنّ التناوُل اﻷكاديمي للبُعد السياسي في الجزائر منذ تولّي بوتفليقة الحُكم، غالباً ما يتمّ ضمن الإطار الدراسي “الضيّق” لـ”المجالات الثقافية أو الحضارية”، ومن خلال منهجية “دراسة الحالة”، ما يجعل هذا البلد “هامشياً”، ويحرمه من القدرة على “الصعود نحو العمومية”. فمسائل مثل ديمومة النظام السلطوي أو أشكال المقاومة أو الزبائنية والفساد أو العنف أو موقع المرأة والشباب أو عملية الانتقال الاقتصادي… كلّها مسائل مهمة طبعاً في نظر توما سير، الذي لا يمكنه أن يتجنّب تناولها. غير أنّه يسعى إلى ولوج مسارات جديدة كان سبقه إلى شقّها كلّ من فرناندو
كورونيل وآشيل إمبمبي وبياتريس إيبو، وتكمن في “فهم صناعة المُتَخَيَّل السياسي في سياق ما بعد استعماري”.
إنّ هذا الطموح على الصعيد النظري لا يلبث أن تقابله واقعية على المستوى المنهجي، إذ يقرّ باحثنا بأن “الصعود نحو العمومية”، ينبغي ألا يفلت من حساب الواقع الملموس، حتى ولو كان بعض هذا الإفلات شرطاً من شروط كلّ طرح نظري طموح. فبعد الكلام العام مثلاً على حتميّة لجوء كلّ سلطة إلى فئة التكنوقراط، وذلك استناداً إلى دراسة للباحث اﻷميركي تشارلز تِللي حول ازدياد تخصّص مختلف أجهزة الدولة منذ منتصف القرن التاسع عشر، يسمح توما سير لنفسه بتطبيق هذا الطرح، الصالح للغرب الرأسمالي في المبدأ، على الحالة الجزائرية. فيُقدّم عدداً كافياً من الوقائع المتعلّقة بـالدور شبه المحوري، الذي يلعبه في أروقة الدولة الجزائرية بعض خرّيجي المعهد الوطني للإدارة والمعهد المُتخصّص في شؤون النف وكليّة العلوم التقنيّة.
خروج اﻷزمة من طَوْر الذروة لا يعني أبداً انتهاءها ككلّ. فهي قد تستمرّ لعقود تظلّ فيها أسبابها ونتائجها محسوسة.
في وعيه الحادّ لضرورة التوفيق بين البُعد التحليلي المرتبط بالنظريّات والبُعد التقريري المرتبط بالواقع، يذكّرنا الباحث بمقال مرجعي لعالم اﻹناسة الفرنسي جان بيار أوليفييه دو ساردان حول العنف الرمزي الذي تتعرّض له المعطيات الملموسة حينما يأتي تأويلها على نحوٍ مغالٍ.

إلاّ أنّ توما سير، من خلال تكراره لعددٍ من المفاهيم وتفصيله لها طوال صفحات الكتاب، يعطي اﻷولوية، في نهاية التحليل، للتنظير على حساب التأريخ. فكتابة تاريخ سياسي للجزائر في حقبتها المعاصرة أمرٌ مهمٌّ طبعاً والباحث لم يبخل قط بالتفاصيل المتعلّقة بصراعات أهل الحكم في دوائر السلطة كافة، من أضيقها إلى أوسعها، كما أنّه لم يحرم القارئ من المعلومات الكفيلة في تقديم صورة واضحة عن قوى المعارضة السياسية والاجتماعية وتنوّع الهوامش المتاحة لها، ناهيك بالانشقاقات التي تتعرّض لها بين حينٍ وآخر. غير أنّ كلّ تلك المعطيات لا يُحْسَن فهمها على أتمّ وجه، في نظر توما سير، إلاّ إذا أُضيئت بواسطة مفاهيم لا تُحيل إلى خصوصيّة جزائرية ما، إنّما تُساهم في إسباغ معنى كوني للديناميات السياسية في هذا البلد وتُغَذّي بالتالي مجال الدراسات المقارَنة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر وعند تحليله طبيعة دور الجيش في الحكم، يستعين الباحث بالتمييز الذي يُجريه المُتخصّص في العلوم السياسية ويليام هايل بين مفهومي “الحَرَسيّة” (بريتوريانزم) و”النظام الحَرَسي” (بريتوريان سيستم)، لِيُظهِر باحثنا الفرق بين وضعية الجيش في بورما ووضعيّته في الجزائر. فلئن كانت القيادة العسكرية هي الآمرة الناهية من دون منازِع أو منافس في بورما حيث يصحّ الكلام بالتالي عن “نظام حَرَسي”، فإنّها في الجزائر، وعلى رغم الارتباط الوثيق بين وظيفتَيها المناعيّة والوصائيّة إبّان احتدام اﻷزمات السياسية، لا تعدو كونها ذات نيات وتطلّعات احتكارية يحول دون تحقيقها وجود لاعبين آخرين ينافسون تلك القيادة العسكرية في السلطة وعليها. لذا، فمفهوم “الحَرَسيّة” هو اﻷنسب في تلك الحالة.
قبل أن يلِج توما سير في تفاصيل العُهدات الثلاث اﻷولى لبوتفليقة، يقوم بوضعها في سياق نظري ويصف تلك المرحلة بـ”طَوْر الكُمون” من الأزمة السياسية التي لاحت بواكيرها في ثمانينات القرن المنصرم قبل أن تستفحل وتبلغ ذروتها في العقد التالي. وفي دعوته إلى إبداء اهتمام أكبر بـِطَوْر الكُمون وإلى عدم الاكتفاء بدراسة طَوْرَي البواكير والذروة، يطمح الباحث ضمنيّاً إلى تخطّي أعمال ميشال دوبري، عالم الاجتماع الفرنسي الذي لا يزال كتابه حول سوسيولوجيا اﻷزمات السياسية، وبعد أكثر من 30 عاماً على صدوره، يشكّل مرجعاً نظرياً رئيسيّاً لعددٍ كبيرٍ من الباحثين في مجال رصد “لحظة السيولة”، إبّان استفحال اﻷزمات السياسية، إذ تتخطّى الحركات الاعتراضية الطابع الفئوي أو القِطاعي لمطالبها.
إنّ خروج اﻷزمة من طَوْر الذروة لا يعني أبداً انتهاءها ككلّ. فهي قد تستمرّ لعقود تظلّ فيها أسبابها ونتائجها محسوسة. بذلك، يُدخِل مفهوم “طَوْر الكُمون” تعديلاً على تعريف اﻷزمة كوضع استثنائي بين مرحلتين مستقرّتين ويُضفي عليها طابع “العاديّة”، ما يجعل تحليلها أكثر موضوعيّةً وبالتالي أكثر صوابيّة. ولعلّ أبرز مساهمة لطَوْر الكمون هو إتاحته المجال لتبيان القدرة الكشفيّة للأزمة، بمعنى كشْف النقاب عن وقائع المُفترَض فيها أن تظلّ مستورة. وفي الحالة الجزائرية، يتمثّل ذلك في الممارسات الفاسدة لبعض النُخَب الحاكمة وفي صراعاتها. كما يتجلّى اﻷمر عينه في جوانب قد تبدو ثانوية ﻷوّل وهلة ولكن سرعان ما يتبيّن أنها بُنِيَوِيّة، كالمضمون الأبَوي لخطابات بعض تلك النخب حيال الفئات الشعبية.
“الكارتيل”

بيد أنّ قدرة اﻷزمة، وهي في طَوْر الكمون، على كشْف خبايا السلطة الجزائرية، لا تبلغ مدى تحديد المسؤوليات على وجه دقيق. فالسلطة في الجزائر لا تُخْتَصَر في دار الرئاسة ولا في قيادة الجيش ولا في أجهزة الاستخبارات ولا في حزبَي النظام (جبهة التحرير الوطني والتجمّع الوطني الديموقراطي) ولا في شركة النفط العمومية ولا في طغمة رجال اﻷعمال، بل هي موزعة على تلك الجهات وغيرها، والتي يصعب ترتيبها في رسمٍ هرمي، نظراً لتبدّل موازين القوى في ما بينها على نحوٍ شبه مُطَّرِد. لذا، يعتمد توما سير رسماً هو أقرب إلى الدوائر المُتّحدة المركز ولكن من دون نواة واضحة! وقد تكون تلك المفارقة هي التي دفعت الباحث إلى استخدام مفهوم “الكارتيل”، المُستَلّ أصلاً من مجال التجارة، حيث يتفّق كبار التجّار المتنافسين على تنظيم مضارباتهم، فيضعون حدّاً أدنى للاسعار ويؤمّنون حركة المبادلات على نحوٍ يفيد مصالحهم جميعاً.
في نزوعه إلى توسيع قاعدته الاجتماعية لتشمل جماعات سياسية واقتصادية وروحية على هامش الحقل الدَوْلَتي، يقترب مفهوم “الكارتيل” من مفهوم المفكّر الشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي – وهو مرجعٌ محوريٌّ في الكتاب – للـ”دولة الشاملة” أو للـ”الدولة الكلّية”، حيث يكاد المجتمع المدني يُضَمّ إلى المجتمع السياسي. ولمّا استُميلت “حركة مجتمع السلم” الاخوانيّة إلى “الكارتيل” طوال العقد اﻷوّل من القرن الحالي، بانَ بعدٌ آخر للنزوع المذكور، يقضي بالانسجام الشكلي مع المقتضى التعدّدي للعولمة.
غير أنّ اتّساع قاعدة “الكارتيل” الاجتماعية يُضعفه بقدر ما يُقويّه. ولا داعي لتعداد تبايُنات تشكيلاته على أكثر من صعيد . فهناك خللٌ أخلاقيٌّ في مبدأ “الكارتيل” بحدّ ذاته، سواء اتّسعت قاعدته أم لم تتّسع. وفي هذا الصدد، أحسن الباحث حميد بوزارسلان عندما استشهد، في إطار تقديمه لكتاب توما سيرّ، بمقولة إتيان دو لا بويسي التي يجزم فيها مفكّر القرن السادس عشر الفرنسي وأديبه بـ”أنّ اﻷشرار إذا ما اجتمعوا تآمروا، وما تصاحبوا، فهم لا يتحّابون، بل يخشَون بعضهم البعض إذ هم ليسوا أصدقاء إنّما متواطئون” ن
إنّ خلوّ “الكارتيل”، بطبيعة حاله، من نواة واضحة، هو ما يحول دون استحواذ أحد لاعبيه على موقع نفوذ يُشْرف من خلاله على كافة السلطات. في ضوء ذلك، قرّر مُتنافسو “الكارتيل” الجزائري الحفاظ على بوتفليقة في سدّة الرئاسة، على رغم تعرّضه لجلطة دماغية غير عابرة عام 2013، لا بل عمدوا إلى ترشيحه لعُهدة رابعة في العام التالي. وبرّروا اﻷمر بأنّ الرجل الذي شارك في حرب الاستقلال والذي مثّل الجزائر في العالم عندما كان وزيراً للخارجية أيّام بومدين “الذهبيّة”، والذي” أخرج” البلاد من الصراع الداخلي المسلّح في نهاية التسعينات، والذي رسّخ السلام عبر استفتاءٍ أوّل على “الوئام المدني” وآخر على “ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”… هذا الرجل بمقدوره وحده “تأمين المستقبل وتعليق الكارثة”.
و”تعليق الكارثة” ظاهرةٌ أثارت اهتمام توما سير في سياق تنظيره لتميّز طَوْر الكمون من اﻷزمة السياسية بمفارقة تقضي بالاستحضار العلني المتكرّر لوقائع يُفترض أن تبقى مستورة كالصراعات الداخلية المُستشرية بين أهل الحكم، أو كانكسار “الربيع الجزائري” (1988-1992) أو كأحداث عامَي 1997 و1998 اﻷكثر عنفاً في إطار “العشريّة السوداء”.
بواسطة هذا الاستحضار العلني المتكرّر لتلك المواضيع الحساسّة ولغيرها، كالمصير الحالك الذي آل إليه أكثر من بلد عربي عرف انتفاضات عام 2011، يُذكّر “الكارتيل” بأنّ النار لا تزال تحت الرماد وأنّ أنجع وسيلة لتعليق الكارثة الحتميّة هي الإبقاء على عبد العزيز بوتفليقة رئيساً لجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية…
على رغم طابعه المتكرّر، ليس الاستحضار العلني المذكور وليد مخطّط أُعِدَّت تفاصيله مسبقاً. وهذه نقطة مهمّة جداً بالنسبة إلى الباحث الذي يُحذّر من مخاطر القراءات التي تُضخّم دور نيات اللاعبين وخياراتهم الواعية على حساب أمور أكثر بُنْيَوِيّة أو، على العكس وبكلّ بساطة، أكثر عَرَضِيّة وعَفْوِيّة. ولئن أقرّ توما سير باستخدام السلطات، عن سابق تصوّر وتصميم، العنف أداة للتحكّم بالمجتمع، فإنّه يشدّد في المقابل على “الحيرة البُنْيَوِيّة” التي تطبع في الوقت نفسه تلك السلطات، ويَذكُر مثلاً بَرْقِيّة ديبلوماسية سرّبها موقع “ويكيليكس” ينعت فيها مسؤولون أمنيّون أميركيّون نُظراءهم الجزائريين بالمصابين بـ”الذُهان الهذياني”. كذلك، يعطي الباحث أمثلة أخرى يندرج بعضها في إطار نظريّة المؤامرة وبعضها الآخر في إطار الشائعات. إلاّ أنّه لا يكتفي بهذا العرض، إذ يحاول فهم دوافع اللجوء إلى قراءاتٍ كهذه ويصل، عبر استناده إلى مقال للباحث إيمانويل طيّب في هذا الموضوع، إلى الاستنتاج الذي نستعيده هنا بتصرّف: ” إنّ الذي يُرَوِّج ما يُقال ويُشاع يشعر بالخروج من حالتَي عُزلة وعجز ليُصبح فاعلاً (أو هكذا يظنّ) في الحدث، عبر تدخلّه في عمليّة نقله وفي مضمون الرسالة التي يحملها. فَعقْلنة العالم عبر الشائعات أو المؤامرات تُتيح للمُرَوِّج أن يُعيد خلق تلك الحقيقة المرجوّة وهي جوهرية في كلّ مُعترك سياسي. بهذا المعنى، يدفع المنهج التآمري إلى التسييس، عبر إتاحته بناء سرديّات تتمتّع بِقَدْرٍ من الانسجام والسبْك”.
والحاجة إلى سرديّات كهذه تزداد إلحاحاً عندما يكون المواطن في حالة “تعبٍ اجتماعي” ناتجة عن عجزه عن فهم كلّ ما يمتّ إلى السياسة بصلة، ما يُفقده اﻷمان ويجعله يشعر بأزمة معنى لا بل بـ”تجمُّد المعاني”، على حدّ تعبير جان بودريار الذي يستشهد به توما سير أكثر من مرّة وبشكلٍ إيجابيٍّ عموماً. والأمر اﻷخير يستحقّ الوقوف عنده نظراً إلى الودّ المفقود بين عددٍ مُعْتَبَرٍ من علماء الاجتماع الفرنسيين وصاحب القلم المُبدِع. فلطالما عِيبَ على محلّل “مجتمع الاستهلاك” و”روح اﻹرهاب” إعطاؤه اﻷولوية للأسلوب الكتابي على حساب الالتزام بـ”القواعد العلميّة”. في ضوء ذلك، يمكننا القول إنَّ في ذكر باحثنا أحد مصطلحات بودريار في أحد عناوين فصوله (وإن كان فرعيّاً)، جرأةً تُحْسَب له.

وفي الموقف من المثقفين الجزائريين النقديين، يتمايز توما سير أيضاً عن عددٍ من الباحثين الفرنسيين العالمثالثيين الذين يُسرعون في إطلاق اﻷحكام الازدرائية، لا بل الاحتقاريّة، التي تختزل طروحات هؤلاء المثقفين في وظيفة إضفاء المشروعية على كليشيهات الرأي العام الغربي إزاء العالم العربي والإسلامي. فالباحث يُبدي تفهّماً حيال مواقف هؤلاء المثقّفين الحادّة، وهم من أفقدتهم مشاريع التكييف الهيكلي الاقتصادية، الرائجة في تسعينات القرن المنصرم على المستوى الدولي، مكانتهم الاجتماعية، ومن دفعهم الصراع الداخلي المسلّح، الدائر في المرحلة إيّاها، إلى المنفى. وإن كان لا يُشاطر تشخيصات الروائيَين كمال داوود وبوعلام صنصال (غير المَنْفِيَين خلافاً لفكرةٍ سائدة)، فإنّه لا يستغرب أنّ تحتلّ دعواتهم إلى الاصلاح التربوي والثقافي موقعاً محورياً في تصوّراتهم للخروج من اﻷزمة. فميزة كلّ مثقّف لا تكمن في نقده السلطة فحسب، بل في نقده المجتمع الذي يعيش فيه أيضاً
وأبعد من نقد المثقفين البلد بحُكّامه وبمحكوميه، يلجأ توما سير إلى النقد الشعبي العام في هذا المجال عبر نقله عدّة نِكات وُفِّق بـاختيارها نظراً لإسهامها، إلى جانب تعابير غير قليلة صاغها الباحث بمهارة، في ترطيب نصّه النظريّ. غير أنّ عَيْب الكتاب الجوهري لا يكمن في طابعه الجافّ، ولا في اﻷخطاء اﻹملائية (وهي كثيرة)، ولا حتّى في الغياب شبه التامّ لمراجع باللّغة العربية، بل في روحيّة عامة قد تكون “الشَعْبَوِيّة العلميّة” التعبير اﻷصدق لوصف أحد أبعادها.

لا شكّ في صوابيّة مُقاربة توما سير لتغيُّر وضعية الشعب في خطابات أهل السلطة وفي ممارساتهم منذ استقلال البلاد. فالباحث على حق في تتبُّعه تحوُّل الشعب من “فاعلٍ” في ثورة صُنِعَت “به وله” إلى “مُهَمَّشٍ” ادّعى ائتلاف الجيش والدولة المستقلّة والحزب اﻷوحد للتحدُّث باسمه والتعبير عن مصالحه، إلى “طفلٍ” منذ نهاية الثمانينات يتعرّض للتأنيب حين لا يُحسن التصويت، أو لا يوافق على الإجراءات الاقتصادية التقشّفيّة، أو لا يخضع بطيبة خاطر للرقابة البوليسية.
لكنَّ توما سير يُجانب الصواب في طريقة نقده عدداً من اﻷكاديميين الذين تناولوا مسألة الشعب، نذكر منهم لَهْواري عَدّي، الداعي إلى تخطّي ثقافة مُتَمَحْوِرَة حول العدالة الجَماعية (لا الاجتماعية) وإحلال ثقافة مُتَمَحْوِرَة حول الحريات الفردية. فنَعْت صاحب هذا الطرح بالمُنْدَرِج في”القالب التأويلي الليبرالي المُحَدِّد لمعايير النظام الديموقراطي الحديث الصالح”، كلام إيديولوجي فضفاض. وهو منحى اعتمده باحثنا، على نحوٍ مُفْرِطٍ أحياناً، في معرض تقييمه أعمال زملاء آخرين له، ما يعطي انطباعاً أنّنا، في الحقل اﻷكاديمي، أمام من نصّب نفسه أبرز مُدافع عن كرامة الشعب الجزائري!
تتفيه المعاني…
ولعلّ تلك الشعبوية العلمية هي التي دفعت توما سير إلى الإنصات أكثر ممّا ينبغي لأعضاء وكوادر في”حزب العمال الاشتراكي”، وإلى الاستشهاد بكلامهم مرّات عدة، وذلك من دون مسافة نقديّة. فلو وُجِدَت هذه اﻷخيرة لَدَفَعَتْهُ إلى وضع كلمة “تروتسكية” بين مُزدوجَين وإلى طرح علامة استفهام حول موقف تلك المنظمة الصغيرة الداعم للجيش إبّان “العشرية السوداء”؛ شأنها في ذلك شأن حُزَيبات أخرى ذات تلاوين، لا بل أقنعة، أيديولوجية متنوّعة
إلى جانب الشعبوية العلمية، ثمّة بعدٌ آخر لروحيّة الكتاب العامّة يكمن في الإفراط في اتّباع النهج النسبي والمودي إلى تَتْفيه الاختلاف بين الفضاء الثقافي الغربي والفضاءات الثقافية اﻷخرى في العالم.
ويصرّ الباحث، الشديد الالتزام بالمنهج المقارَن، على طرد كلّ تحليل يشتمّ فيه رائحة الفرادة، حتى ولو تعلّق اﻷمر بمقارنة بين أنظمة سياسية وليس بين ثقافات. وفي خدمة هذا الهدف، يلجأ مراراً إلى مقاربة ميشال فوكو للديموقراطية الليبرالية، وإلى تفكيك المفكّر الفرنسي منظومات الرقابة والتحكّم والتدخّل التي تُقيّد الحريات على نحوٍ لا يختلف فيه، في نهاية المطاف، نمط الحكم هذا عن اﻷنظمة السلطوية.
فك عزلة الميدان
في سعيه المشروع إلى فكّ عزلة الميدان الجزائري عن الأدوات الكونية للعلوم الاجتماعية، يبدو توما سير مُقنعاً تارةً – وهو كذلك عندما يطبّق على الحالة الجزائرية طرْح تشارلز تِللي المذكور في بداية هذا المقال- وغير مُقنع طوراً. بالفعل، ففي معرض تحليله سوء الحَوْكَمة والفساد والزبائنية ودخول رجال اﻷعمال المُعترك السياسي في الجزائر، يُجري الباحث مقارنة مع إيطاليا، أي مع أحد أقلّ بلدان أوروبا الغربية “ديموقراطيةً” على المستوى السياسي. ولو كنّا ثقافَويين لأضفنا: “وأحد أكثرها جنوبيّةً على المستوى الثقافي”. على أنّ توما سير نفسه وقع نوعاً ما في فخّ الثقافَوية حين “نسخ” في النص الفرنسي مُصطلح “الحُقْرة” المُتداوَل في اللهجة الجزائرية الدارجة للدلالة على مزيج من الاحتقار والظلم الاجتماعيَين. وكأنّ ثمّة خصوصية جزائرية حالت دون الاكتفاء بالترجمة… وبالتَتْفيه.
في جميع اﻷحوال، لا تهدف تلك الملاحظات اﻷخيرة إلى الحطّ من قيمة هذا العمل الشيّق الذي سيشكّل محطّة مفْصليّة عند كلّ من يُقارب الجزائر بأدوات العلوم الاجتماعية، لعلّه يدرك أنّ التحليق في فضاء المفاهيم لا يعفي من الغوص في وحول الميادين. فبتأمينه توازناً دقيقاً بين هذين المُقْتضيَين، قدّم توما سير مساهمة نظرية متينة في فهم السياسة الجزائرية.