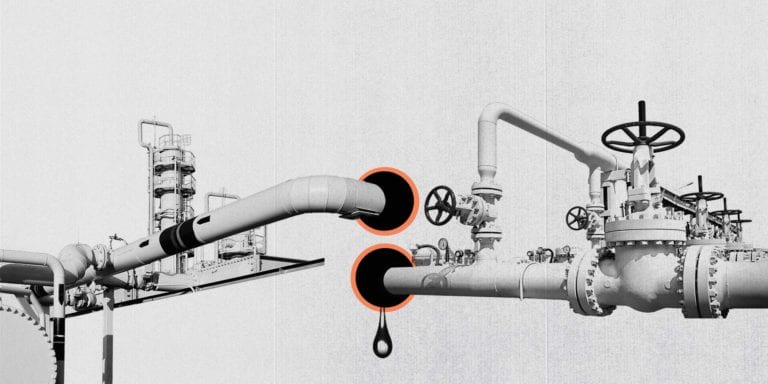تنحسر ممارسة الحياة الاجتماعية كما الاقتصادية والسياسية، للبنانيين أفراداً وجماعات، إلى أدنى مستوياتها. وأسباب هذا الانحسار لا تقتصر على ضرورة المكوث مُنعزلين في البيوت اتِّقاءً لعدوى “كوفيد- 19″، إذ ترتبط أيضاً بتداعيات الانهيار الاقتصادي – السياسي الذي لا سابق له في تاريخ بلدهم وفشل السلطات الرسمية على أنواعها في لجم هذا الانهيار.
وعليه تبدو حياتهم الاجتماعية أشبه بأرض باردة شرعت للتو بالتصحر. هي التي كانت حتى الأمس القريب محل تقدير على ما تتصف به من حرارة وديناميكية عاليتين. في حين تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دوراً إيجابياً فعالاً في إعادة الحرارة إليها ووصْل ما انقطع فيها.
الحياة الاجتماعية اللبنانية بما تعنيه من ألفة وسهولة فائقتين في العيش والتواصل والتضامن بين الناس، وبما فيها من لقاءات متنوعة عائلية في البيوت حول طاولة الطعام المُتْرفة ولقاءات الجيران والأحبّة والأصدقاء في البيوت والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى المهرجانات الثقافية وحفلات الأعراس والولادات وحتى المآتم والجنازات واعياد لا تنتهي… تبدو الآن كهامش ضيق لِمَتن افتراضي يتحقق جزء بسيط منه عبر شاشات هواتفنا الذكية وألواحنا الرقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. أما الجزء الأكبر منه والمرتبط بتداعيات الأزمة الاقتصادية وفداحة تأثيراته، فهو إلى الآن معلَّق غير واضح الاتجاهات عموماً، على رغم أن ملامح منه قد بدأت بالتشكل في أنماط العيش المستجدة لافراد وعائلات الطبقة المتوسطة التي يكاد وجودها يشارف على الاختفاء، ليُصبح اللبنانيون فئتين: أكثرية ساحقة فقيرة وأقلية صغيرة جداً فاحشة الثراء.
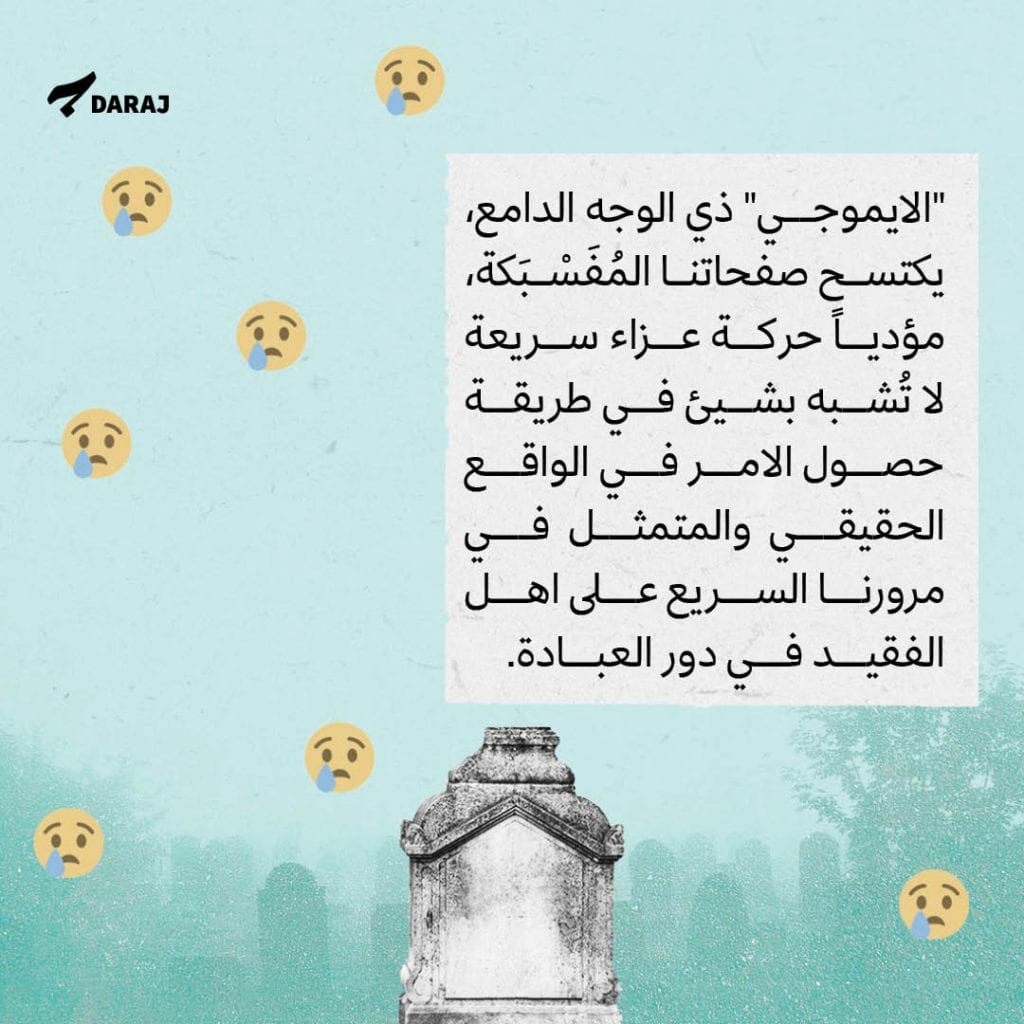
ومع هذا يظلُّ الحدثان الثابتان على مسرح هذه الحياة هما الولادة والموت. ففي الوقت الذي نتعلّق بحدث الولادة ونتذكّره دوماً كعلامة احتفالية سنوية، نعمد الى تجاهل حتمية حدث الموت، ليأتي موعده مفاجئاً وحزيناً، يهزُّ أعماق وجداننا.
الموت وقد أمسى السمة الأكثر بروزاً في حاضر اللبنانيين. هو موتٌ في كل شيء. فمن موت النظام السياسي وبداية تحلل القوانين فيه، مروراً بموت الأعراف والعادات الاجتماعية وطرائق العيش المتنوعة انتهاء بموت الأفراد.
لا اُصنِّف الموت بِمُجمَلهِ في خانةِ الهِجاء. فالموتُ بكونه سُنّة الحياة يأتي طبيعياً ومرغوباً به في بعض الحالات، كموت الأنظمة المُستبِدّة والظالمة، كما موت العادات القديمة الرجعية وسبل العيش المُتخلِّفة. إلّا انَّه في حالة الافراد من بني البشر، يأتي الموت فاجعاً ومؤلماً لا رغبة عندنا فيه.
قبل زمن كنا نتقصّد قراءة زاوية الوفيات في الجريدة الورقية، وربما نفاجأ بوفاة أحد نعرفه، حيث كان احتمال حدوث هكذا مفاجأة ضئيل ويكاد يُشْبِهُ الفوز بجائزة اليانصيب الكُبرى، ولكن مع فارق الشعور العكسي للحدَثين.
الناس نيام!
في ذاك الزمن غير البعيد كان خبر الموت حدثاً جللاً ومُحزناً لا يعْبُر حياتنا بشكل يوميّ. بل يُباغِتنا في أزمان متباعدة، مسبباً اهتزازاً نسبياً للحياة المُطمئنة. حُزنُ هذا الحدث كان يُذكِّرنا بقولٍ مأثور يُنسب الى الامام عليّ وفيه: “الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا…”. أمّا اليوم وفي حضرة الموت العميم والاضمحلال التدريجي لفُسحة العيش، فقد يصحُّ في هجاء الحياة اللبنانية القول بأنّ “الناس نيام فإن عاشوا انتبهوا…”!
لا نجد أمام هول حدث الموت الفاجع للأفراد إلّا المواساة والرِثاء. فإذا كان في المواساة فعل اجتماعي يخفف الضغط النفسي الناتج عن فراق الأحبة والأصدقاء. ففي الرثاء فِعل لُغوي ثقافي بامتياز، وفيه إبراز لخصال الميْت الحميدة وتعبير عما خلّف غيابه من ألم وحسرة. والرثاء هو غير التأبين بكاءً ونواحاً، بل يقع في منزلةٍ عقلية أعلى منه، ليرقى الى تأمل فكري في ظاهرة الموت وما ينتج منها.
وإذا كانت المواساة وشعائر التعزية بالميْت حاضرة بقوة في المشهد الاجتماعي اللبناني وبشكل مُبالغ فيه أحياناً، إلا أنّ في رِثاءه غياب كبير عن هذه المشهدية. فالرثاء كان بالأمس يُكتب في الصُحف والمجلات لأفرادٍ ذوي شأن وتأثير كبير في المجتمع. أما اليوم وبفضل وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام فيضان الموت في كل ارجاء المعمورة، أصبحنا نقرأ الكثير منه مُرسلاً عبر شاشات الوسائط الرقمية.
فيكاد لا يمر يوم من دون إعلان وفاة أو أكثر. موتُ أقارب وأصدقاء قريبين وبعيدين. تُطالعنا صورهم كُل صباح ومساء على جدران مواقعنا الرقمية من “فايسبوك” وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، مُذيّلة بالرثاء لصاحب الصورة المُتوفى.
إقرأوا أيضاً:
الحزن عبر “الإيموجي”
تحصد الصورة مع إعلان النعْوَة أعلى نسب في التفاعل عبر تعبير (الإيموجي) ذي الوجه الحزين والدامع (😢)… هذا “الايموجي” بلونه الأصفر ودمعته الزرقاء السخية، والذي نادراً ما استُعمل سابقاً، نراه الآن يكتسح صفحاتنا المُفَسْبَكة ويقيم فيها طويلاً، مؤدياً إلى حركة عزاء سريعة لا تُشبه بشيء طريقة حصول الأمر في الواقع الحقيقي والمتمثل في مرورنا السريع على أهل الفقيد في دور العبادة. نمد اليد إليهم لنصافحهم في حركة مسرحية آلية مُضنية، واثناءها نُتمتم مُتجهمي الوجوه بكلمات حفظناها عن ظهر قلب؛ “العوض بسلامتكم” او “انشالله بتسلموا” وغيرهما من التعابير. وقد يختلط الامر على أحدهم ليُخطئ عن غير قصد في الترداد قولاً، “مبروك” أو “عقبال عند العايزين”… فيُحرج نفسه ليُخرج العزاء من جو حزين شديد القتامة إلى آخر يسوده شيء من المرح.
في العزاء الرقمي لا شيء من هذا سيحْدث. فالمسافة الافتراضية التي تُدخلنا في تماس مباشر وسريع مع الحدث إنما من خارج واقعه المادي، إضافة إلى صيغة التعبير الاختزالية للعزاء والمُتمثلة بوجه “الايموجي” الحزين وسهولة التحكم به، يُلغي أي التباس قد يحصل فيزعزع كثافة الحزن التي عادة ما تكون المبالغة في إبرازها مطلوبة اجتماعياً.
طبعاً تختلف ترتيبات العزاء وكيفية إجرائها في لبنان تبعاً لاختلاف الانتماء الطائفي والمذهبي وحتى المناطقي. لكنها على العموم تبدو متشابهة من حيث الالتزام بصرامة اجراءاتها الدينية حيث لا يجوز الإخلال مطلقاً بطرائق غسل الميْت ودفنه والصلاة على روحه وإجراءات العزاء. حتى لو كانت إرادة المتوفى غير ذلك وسبق له أن دوّنها في وصيته الأخيرة. كأن يوصي بأن تُحرقَ جُثته، مثلاً، ويُذَرَّ رمادها تحت شجرة زيتون. أو كأن يوصي بأن لا يُصلي على جُثمانة رجل دين، بل أن يُبَثَّ اثناء دفنه والعزاء به، شيء من موسيقى جان سيباستيان باخ. ولكن لا شيء من هذا سيحصل بالتأكيد لأن أهل الميت سيرفضون تنفيذ الوصية أو في احسن الحالات لن يملكوا الجرأة الكافية لتنفيذها وتحدي السلطات الدينية، إلا في ما ندر من الحالات الاستثنائية.
إلّا انّ الجوائح على أنواعها، تُجبر الشعب اللبناني، بانتماءاته الدينية والاجتماعية كافة، على سلوك درب التغيير في الكثير من عاداته واعرافه، ومنها ما يتعلق بأمور الموت وإجراءات دفن الميْت والعزاء بفقدانه التي أصبحت تكلفتها المالية كبيرة وغير مقدور عليها.

ويفتح أهلُ الفسْبَكَةِ أبواب صفحاتهم لمثل هذه التغيُّرات، فيتبادلون التعازي ونصوص المراثي بموتاهم عبر الكتابة نثراً أو من خلال بثٍ موسيقي، وتتعدد اشكال التعبير “الإيموجية” (👍😘🙏💔) مختزلة حالة شعورية فردية، كما تختلف صيغ التعزية وتتنَوَّع بحسب تنوع مشارب المُفَسْبكين الثقافية أو تبعاً لاختلاف منطلقاتهم الإيمانية.
فالسُلطة الفيسبوكية المركزية المُمسكة بإدارة شؤون أهلها لا تتعاطى مع المُفَسْبِكين إلا بما يمثلون أنفسهم كأفراد وليس كجماعات وشعوب واديان. فحرية القول والتعبير مُشرّعة ومستوحاة من ضوابط ومعايير المجتمع الغربي الحديث. فمنذ لحظة الانضمام (ولادة المُفَسْبِك) يُسجَّلُ له تاريخُ ميلادٍ فايسبوكيّ تبدأ معها حياته، ويحق له اثناء هذه الحياة موت فايسبوكي مُتعدد وموقت، يكون الموت فيه ذهاباً وإياباً لسبب يقرره المُفسبك وحده، فيَنْصرِف عن تلك الحياة لوقت من الزمن ليعود اليها مرةً أخرى.
وحتى عند حدوث الموت البيولوجي الحقيقي، فللمُفَسْبك الحق بالخيار كوصِيّة إمّا زواله فايسبوكياً عبر إلغاء صفحته نهائياً او بالابقاء عليها لتُصبح مزاراً، يعود إليها أصحابه ومُحبوه ليقولوا فيه مرثية. لا اعرف إنْ كان يصحُّ إعطاء الصفحة الفايْسبوكية المحفوظة للميْت، صفة “جنّة الخلود الرقمية”! قد تبدو هذه الصفة مُغرقة في الخيال أو مُقلِّلة من قدْر الجنة التي تتحدث عنها الأديان السماوية، إلا أنّ هذه الصفة وبلا شك اكثر واقعية وتحَقُقاً من تلك.
تعود المرثيات الى الظهور تعبيراً نثرياً وتأملياً في أكثر الأمور حزناً في الحياة. فلا الوعد بالجنّة للميْت ولا التمني له برحمة الإله ولا كل طُرق الغسل والدفن، ولا شيء يُكْرِمه أكثر من رِثائه الذي بهِ نتصالح مع الموت وفيهِ نُكرِّم الحياة التي كانت بوسع الفقيد وما زالت في وسعنا.
جدران المراثي
على الجدران المُفسْبَكة تُطالعنا يومياً كتابات الرِثاء ونصوص المراثي منها المُختصَر ومنها المسترسَل، ومنها ما يُكتب بسيطاً وبدائياً، وآخر يبدو مُغْرِقاً في التأمل والاستذكار، بيد أنه غالباً يكون صادقاً ومؤثراً كونه ينطلق من الذات الفردية وحالٍ من التفَكُّر الحُر غير المُقيّد بالأعراف والاديان.
فها هي الزوجةُ تكتب في زوجها رِثاءً ينضح حُباً، والابْنُ يرثي والدته مُستعيداً اجمل الصور من ذاكرته، والصديق يرثي صديقه نادماً على تأجيل اللقاء به دوماً، والحبيب يرثي حبيبته شعراً يستعيد فيه الرحلة الاسطورية لأورفيوس إلى الجحيم لاستعادة حبيبته يوريديس.
كتب المُخرج المسرحي ربيع مروّة أغنية، تؤديها الفنانة ريما خشيش، يرثي فيها صديقته مريم التي باغتها الموت وهي في ريعان شبابها.


فيقول مخاطباً الموت:
ليْتَ للموتِ لساناً يُخاطِبُ الأحياء… يروي حال الغُيّاب
يا ليْتْ…يا ليْتَ لو يروي لي عن هناك
سعيدٌ حبيبي أم حزينٌ؟
ألَهْوُهُ في المماتِ كالحياةِ ظريف؟
ليْتَ للموتِ سلاماً يُهادنُ الأحياء… يرعى شَمْلَ العُشّاق
يا ليْت… يا ليْت يَرُدَّ لي مَنْ هناك
في غِيابِهِ سُهادٌ ونارٌ تحرق الأيام
سماءٌ فَوْقَها تراب
طيْفَهُ ما يغيب يُومي لي بالوصال
وانا في ظلِّهِ شريد
ليْتَ للموت أماناً، ذهاباً وإياباً، يُريحُ بالَ الأرواح
يا ليْت… يا ليْتَ لوْ يودي بي الى هُناك.
إقرأوا أيضاً: