راجت في الآونة الأخيرة، بين عدد من السوريين، مقولة “ثقافة الأغلبية” لتبرير سلوكيات، منها، مثلاً، ارتداء المعارِضة بسمة قضماني الحجاب لمجاملة “المناطق المحررة”، وتصريحات الحقوقي هيثم المالح تجاه لباس الناشطة المغيّبة رزان زيتونة، وصولاً إلى تصريحات الشيخ أسامة الرفاعي، حول المرأة وضرورة صونها من “انحرفات الغرب” والمنظمات التي يدعمها.
والمقصود بـ”ثقافة الأغلبية” وفق مستخدميها، انعكاس فهم السنّة للدين الإسلامي باتجاهيه الاجتماعي والسياسي، وتحويله لميول وتوجهات معادية للغرب والحداثة، وترجمته إلى نمط حياة محافظ. أي خلق سنّة نمطيين، لهم مواقف سياسية موحدة، وحياة اجتماعية موحدة. كتلة صماء تتحرك انطلاقاً من وعيها الديني بمعزل عن الشروط الاقتصادية والسياسية وطبيعة السلطات الحاكمة.
وغالباً ما يتم الرد على مروجي مقولة “ثقافة الأغلبية” بنقطتين، الأولى، أن الأغلبية يجب أن تقوم على ما هو سياسي، وليس ديني، أي على مصالح وتعاقدات وإجماعات وعبر انتخابات حرة، والثانية، أن الأغلبية السنّية في سوريا، ليس موحدة، وثمة انقسامات أفقية في جسمها تجعلها غير قادرة على التقلص نحو القالب المراد وضعها فيه. وعلى رغم أن هاتين النقطتين، تحملان الكثير من الصواب المعرفي، لا سيما بالمعنى السوسيولوجي المتعلق بتوزع السنّة في سوريا على مناطق وطبقات وولاءات شديدة التباين، إلّا أنهما تميلان إلى التنظير الإيجابي، الذي يضمر نيات ديومقراطية حسنة لسوريا، والتي قوامها التمسك بخيار الأغلبية السياسية المتشكّلة من الطوائف والمذاهب والأديان والأعراق كافة، والنفور من ثنائية الأغلبية والأقلية، القائمة على الانتماءات ما قبل “الدولاتية”.
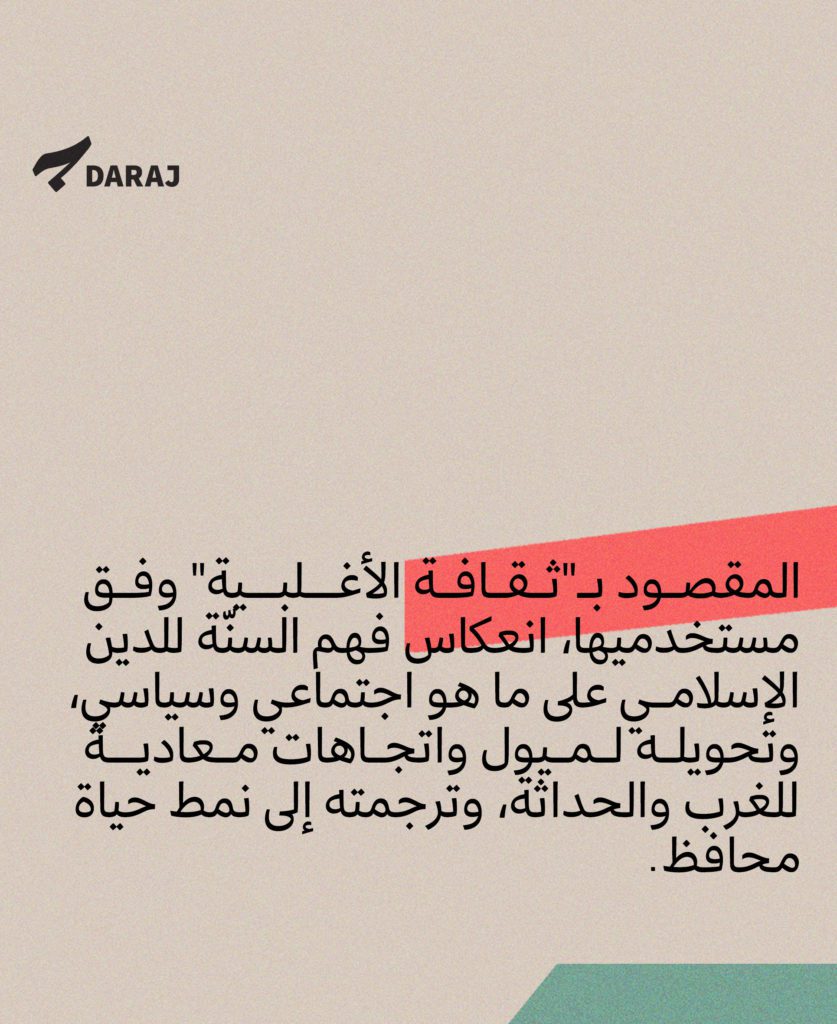
وعلى الأرجح، فإن هذا التنظير بما يحمله من صواب معرفي، لا يكفي لفهم منطق مستخدمي مقولة “ثقافة الأغلبية”، إذ إن الفرق الذي يتسع مع الوقت، بين النيات الديموقراطية والواقع، يمنح هؤلاء الكثير من المشروعية. فبعد 10 سنوات على ثورة سلمية قمعت، فتعسكرت، وبات الكثير من المنتمين إليها جزءاً من حرب أهلية طاحنة ولّدت تدخلات إقليمية ودولية، توزع الوعي السنّي السوري المعارض، بين المظلومية، وتأييد مشاريع إقليمية تعالج هذه المظلومية عبر محاكاة نماذج الخلافة والأمة الحاضرة بقوة في تاريخ المسلمين.
وبين المظلومية وعلاجها، مسار طويل من الشعور بالاستهداف الدائم والاندفاع أكثر فأكثر، نحو التمسك بالقيم المحافظة، المرتبط بفهم محدد للدين، بحيث بات الأخير وعاءً للمظلومية وفي الوقت نفسه علاجها، عبر الاتكاء على ما هو انتصاري في تاريخ المسلمين.
أي أن النيات الديموقراطية الطامحة بأغلبية سياسية تعددية، تغفل التحولات التي أصابت الوعي السني المعارض عقب 2011 والتي دفعته إلى التصلب. وعليه، قد تكون مناقشة مقولة “ثقافة الأغلبية” انطلاقاً من التحولات والظروف التي صلّبتها، أكثر جدوى، بعيداً من النيات الطيبة الميّالة لطوبى أكثرية سياسية صعبة التحقق.
والأمر الملح في نقاش التحولات التي صلّبت الوعي السني ودفعته للمحافظة، بمستوييه السياسي (معاداة الغرب) والاجتماعي (قيم وسلوكيات مستمدة من الدين) هو العلاقة بين المظلومية والخيارات السياسية، فسنّة سوريا المعارضين، لحظة شعورهم بالظلم والاضطهاد والتهميش السياسي، وصولاً إلى التخلي الدولي، انحاز جزء منهم، إلى تركيا التي تستخدم تاريخها خلال الخلافة للتمدد من جديد، واستظلوا بها، وباتوا أدوات في مشروعها في المنطقة، فيما اندفع جزء آخر إلى مشاريع التنظيمات الإسلامية متفاوتة التشدد.
إقرأوا أيضاً:
وبالنتيجة، المظلومية أدت إلى العودة إلى الماضي “المجيد”، سواء مثلته دولة أو مجموعات تسيطر على مناطق في الشمال، وأصبح الوعي السني المعارض أكثر تصلّباً حيال الغرب (الذي تخلى عن إنقاذ السوريين)، وأكثر محافظة وتمسكاً بالسلوكيات النابعة مما هو ديني. بمعنى أكثر وضوحاً، المظلومية تعمقت أكثر، وعالجت نفسها بالحفر أعمق نحو الهزيمة والاسترخاء في ظلها.
قبل تعميم المظلومية على الوعي السني المعارض بعد الثورة، كانت هذه المظلومية محصورة بأحداث الثمانينات، أي أن تأثيرها لم يكن شديد المركزية وعنصراً حاسماً في الوعي السني السوري المحافظ سياسياً واجتماعياً. بيد أن هذا الوعي، وإن تصلّب بعد عام 2011 والهزائم المتتالية، لكنه كان قائماً قبل ذلك، وعبر عقود من حكم البعث، حتى إن الأخير استغلّه واستثمر فيه لمصلحته، لا سيّما من خلال الدخول الأميركي إلى العراق، إذ وجد النظام الذي أراد إفشال المشروع الأميركي في البلد الجار، حاملاً سنياً سورياً يتقاطع معه انطلاقاً من معادة الغرب وتدخله في المنطقة. وعلى المستوى الاجتماعي، تركت السلطة الحرية لسلطة “الإسلام الرسمي” ليكون ضامناً لعدم وجود إسلام سياسي يطمح للحكم، فتوسعت شبكات “القبيسيات” وانتشر الحجاب وصارت تعاليم المشايخ تبث داخل حافلات النقل في العاصمة.
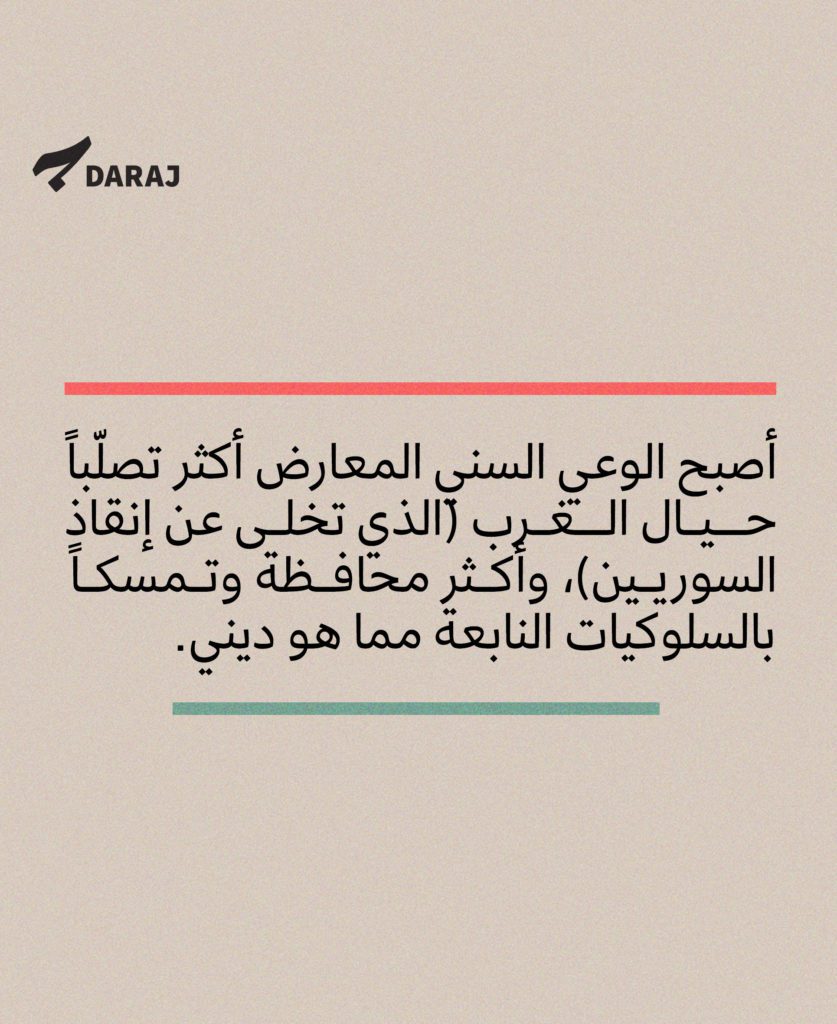
من هنا، فإن الوعي السني القائم على “ثقافة الأغلبية” كان مضراً للسنة السوريين، قبل الثورة وبعدها. في الحقبة الأولى، كانت هذه الثقافة متحالفة مع الاستبداد أو أقله ليست خصماً له، وتنتعش في ظلاله، وفي الثانية، كانت عائقاً أمام تطوير وعي سياسي حديث، ينقل المظلومية من شعور الاضطهاد ولعب دور الضحية، إلى لغة المصالح وموازين القوى والتقرب من الغرب وبناء تقاطعات معه لتحقيق مكاسب، انطلاقاً من طموح كياني دولاتي، يتخلى عن أوهام الماضي.
وعدا ضرر “ثقافة الأغلبية” على السنة كجماعة في مساراتها وتحولاتها الأخيرة، فإن ضررها يطاول السني الفرد الذي، وإن أراد الانتماء لدينه عبر سلوكيات وقيم محافظة، فإن ذلك لا بد أن يحدث في ظل تشابك مع عناصر حديثة، تتعلق بحسم شكل الدولة ودور الاقتصاد في دمج الجماعات، والإقرار بتعددية المجتمع، وليس انطلاقا من الانتماء للعدد، وتجريد الأخير من أي محيط يتفاعل معه. بمعنى آخر، دفع “الوعي السني” إلى ما هو ثقافي وتفاعلي وحديث، ونزع ارتباطه بالماضي المتأتي من المظلومية، حيث البيئة الخصبة لمعاداة الغرب والتمسك بالمحافظة.
وتوفير هذه الفرصة للفرد السني، لا بد أن يسبقها تغير في مسلك الجماعة، أي تحويل المظلومية، لدى النخب والسياسيين والمثقفين وصنّاع الرأي العام، إلى فرصة للاقتراب من العالم ونماذجه في الحكم، وليس محنة للانقضاض عليه.
إقرأوا أيضاً:









