ليس باستطاعة المُتنزّهِ مشياً على رصيف البحر في مدينة بيروت، إلا أن يلاحظ التخريب الفظيع والمُتعمّد للمقاعد المُثبّتة بإحْكام على الرصيف والمُخصصة للعامة. ولا يفُوت المرء المتردد بشكل دائم على هذا الرصيف وغيره من أرصفة المدينة وحدائقها العامة النادرة الوجود أصلاً، أن هذه المقاعد الخشبية تتغير باستمرار نتيجة التخريب الحاصل بها، بحيث يُعاد وضع بدائل لها من مواد أكثر صلابة كالحديد في فترات سابقة أو كالاسمنت والحجر في الفترة الأخيرة.
توحي هذه البدائل بأن الحياة برمتها في مدينة بيروت تعود إلى الوراء متقهقرة من عصر الخشب مع بدء الثورة الصناعية، إلى الحديد في العصر البرونزي وصولاً إلى العصر الحجري.
والجلوس هو الدعوة الوحيدة لأي مقعد أو كُرسي أو ما شاكل. دعوة مفتوحة ابتكرها البشر ويعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث أو ربما ما قبل ذلك. واذا كانت وضعيّة الوقوف وتحريك الرجلين واليدين مشياً على الأقدام، هما سبب رئيس لتطور انسان الهوموس، فَوَضْعِيّتا الاستلقاء والقرفصاء كانتا جزءاً من طبيعته الفيزيولوجية – الغريزية، بحيث حافظتا على جنسه من الهلاك.
فوضعية الاستلقاء كانت وما زالت لحاجة النوم. أما القرفصاء فهي وضعية من مهماتها إخراج نفايات الجسد الجامدة والسائلة. إضافة إلى قدرتها على اراحة العضلات والعظام من مشقات التنقّل على الأقدام. بيد ان تطور وظائف الجسد في العصر الحجري أضاف وضعية رابعة هي الجلوس، بحيث تستوي مؤخّرة الجسد في تماس مباشر بالارض مع طيِّ الرجلين نحو الجسد. وقد خضعت وضعية الجلوس هذه لتطور زمني بطيء وطويل، ناقلة الإنسان إلى عصر الانثروبوسين عبر الكرسي كأداة مُبتكرة.
انطلق هذا التطور مع استقرار التجمعات البشرية الأولى لإنسان الهوموس واكتشافه النار وتطور استخدامه يديه. وهو ما أتاح لوضعية الجلوس أن تصير فكرة قائمة على ممارسات مُستجدّة، ليس طرد الجسد نفاياته هدفها الوحيد، انما ايضاً ممارسة العمل اليدوي، والاهم هو الحاجة الاجتماعية الى مُجالسة أبناء العشيرة الواحدة حول النار. فالمُجالسة، من فعل “جَلَسَ”، هي التي كانت تُعزّز شعور الجماعة بالقوة والتضامن، وتؤكّد في الوقت نفسه انتماء الفرد إلى جماعة محددة.
وعلى رغم أن فعل الجلوس بقي يتطور عبر التاريخ البشري، إلا أنّ الكرسي أداته الوحيدة، ظلّت هي نفسها على مدى مساره الطويل والشاق.
ولكن الكرسي تغيّر شكلاً، بتغير الحقبات الاجتماعية وتنوُّع الانتماء الاجتماعي والثقافي للجالسين عليه، كما وتنوّعت مواده تبعاً لتنوّع وظائفه والرموز التي ارتبطت به. فأكثر الأفكار الرمزية ارتباطاً بالكرسي كانت فكرة السُلطة من زاوية عُلُوِّ الشأن والعظمة والقدرة المطلقة على ممارسة القوة والتحكم والإمْرة.
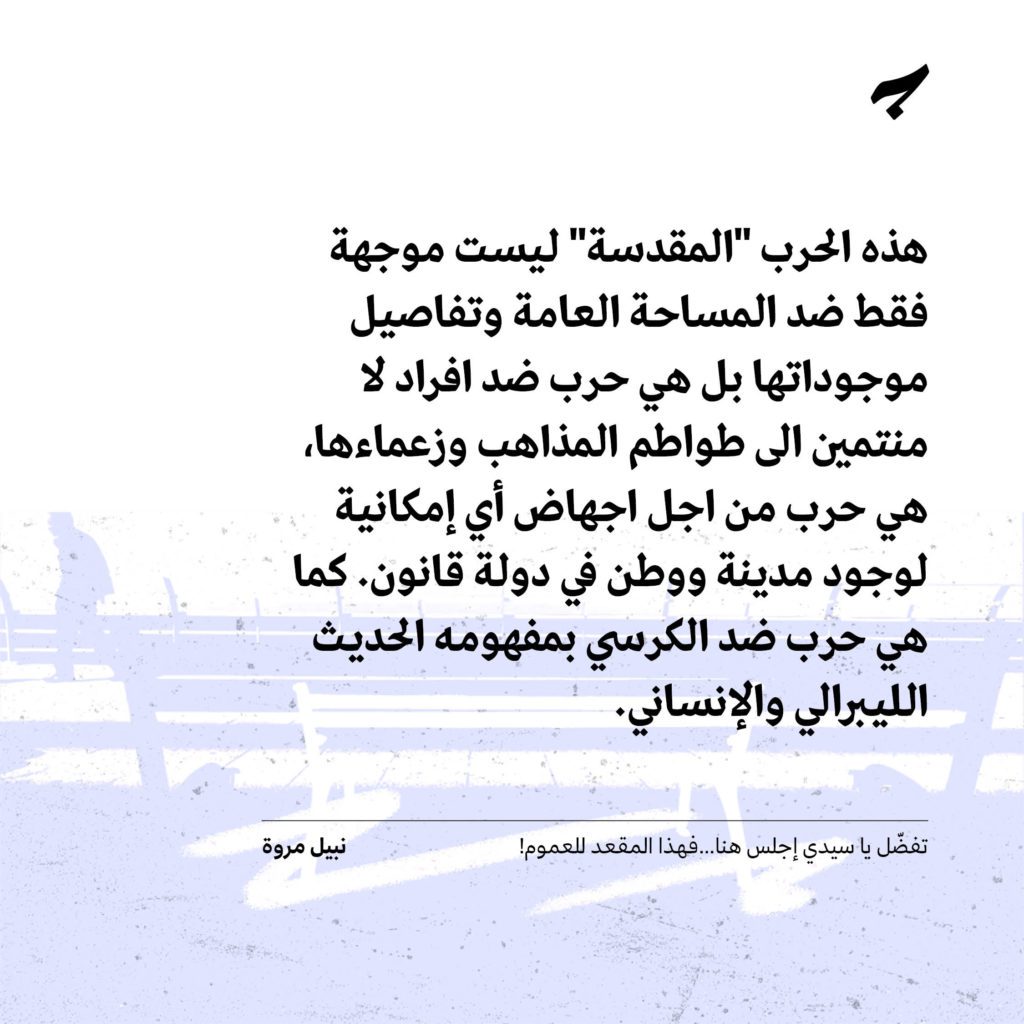
مع مرور الزمن عرفت كلمة “الكرسي” معاني متنوعة ودلالات مختلفة، فيقال مثلاً: كرسي العرش أو الرئاسة لدلالة سلطوية، كرسي الزمالة لدلالة تربوية او ثقافية، كرسي الاعتراف لدلالة أخلاقية، الكرسي الرسولي لدلالة دينية، وثمة الكثير من التسميات المهنية التي ارتبطت به من دون أن يُقصد بها فعل الجلوس.
فبدءاً من اول كرسي مُكتشف صنعه إنسان العصر الحجري الحديث، إعلاءً لشأن زعيم القبيلة أو تكريساً لكاهنها، مروراً بكرسي الملك الفرعوني المحمول على الأكتاف والمصنوع من نبات القصب وجلود الحيوانات، وصولاً إلى ظهور أول كرسي خشبي (كليسموس) مع مسند للظهر واليدين، في روما القديمة، انتهاءً بالكرسي البلاستيكي الحديث (المونوبلوك) والمُلوّث للطبيعة، يكشف لنا تاريخ تطور الكرسي عن المنعطفات الأساسية التي مرت بها الحضارة الإنسانية، وعن بعض المسارات المعقدة في علاقة الفرد من جهة والجماعة من جهة اُخرى، وعن العلاقات المضطربة إلى حدود العنف بين الجماعات المتنازعة من أجل الاستحواذ على السُلطة- الكرسي.
واذا كان لكرسي “كليسموس” الخشبي أنْ حظِيَ بانتشار واسع في روما القديمة، فذلك نظراً لما كانت تُمثله أثينا القديمة كأول مجتمع مديني ديموقراطي في العالم. إذْ كان في وسع أي مواطن اثيني أن يقتني هذا الكرسي للجلوس عليه. في أثينا مدينة العالم (بوليس) نشأ تقليد الجلوس في الساحة العامة كمفهوم اجتماعي قائم على المساواة والحرية لجميع مواطنيها. شوارع وساحات أثينا كانت مساحة للحوار الثقافي- السياسي والتلاقي الاجتماعي.
بعد اندثار المدينة الاثنينية وظهور الأديان الموحِّدة وقيام تحالف متين بين رجال الدين وحُكّام الامبراطوريات الجديدة، تراجع انتشار الكرسي الخشبي عموماً في العالم، وأصبح محصوراً بفئة الأثرياء والملوك، بعدما أضيفت الى مسانده حشوات من ريش الطيور، مُغلّفة بجلود الحيوانات، وقد تعددت أحجامها وتزيّنت بألوان وتطريزات تُمثل القوة والعظمة. في حينها كان جلوس العامة من الناس متاحاً فقط على دكّات خشبية غير مريحة شُكِّلت كيفما اتفق ومن دون معايير وظيفية وجمالية.
تغيَّر وضع الكرسي نسبياً مع عصر الثورة الصناعية الأولى وظهور الملامح الأولى للمدينة الأوروبية. امّا الثورة الفرنسية التي أرست لمبادئ حقوق الإنسان فقد أعادت نسبياً للكرسي مفهوماً ديموقراطياً كان قد تمتع به في المجتمع الأثيني القديم.
ولكن بدءاً من النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وفي عز الثورة الصناعية الثانية التي شهدت على أهم الاختراعات التكنولوجية، حصل انتشار كثيف وغير مسبوق للكرسي بحيث تنوع استخدامه بنشوء الوظائف الجديدة بفعل هذه الثورة.
انتشار الكرسي أو المقعد في القرن العشرين كان بمثابة الانفجار الكبير (البيغ بانغ) الذي أسس لعصر الجلوس المريح، مُنهياً لعصور طويلة كان المشي أو الوقوف فيها وضعية ملازمة للعمل. في حين أن وضعية القرفصاء تكاد تنقرض مع دخول عصر الكُرسي إلى غرفة الخلاء وفي داخل كل بيت، بحيث عدلت بشكل نهائي في وضعية إخراج نفايات الجسد والأهم كونها أسست للمدينة الحديثة، معلنة قطيعة نهائية مع الريف.
الكراسي والمقاعد على أنواعها وأحجامها غزت العالم وأصبح وجودها أمراً بدهياً لا غنى عنه في كل الأمكنة والمساحات: في البيت والمقهى والمدارس والشركات والمحال التجارية وكل وسائل التنقل وحتى في الشوارع والحدائق والساحات العامة.
في منتصف القرن العشرين وبعد حربين عالميتين انتشرت في بلدان العالم الأول المقاعد العامة، المصنوعة موادها الأساسية من الخشب، والمُثبتة في الحدائق والساحات العامة. كان هذا تعبيراً عن توازن لقيمة الرفاهية في مقابل قيمة العمل، ووعياً متقدماً لاستعمال المساحات العامة في المدينة من أجل التلاقي والتشارك بين بين قاطنيها على قاعدة المساواة في المواطنة وعدم التمييز في الانتماء.
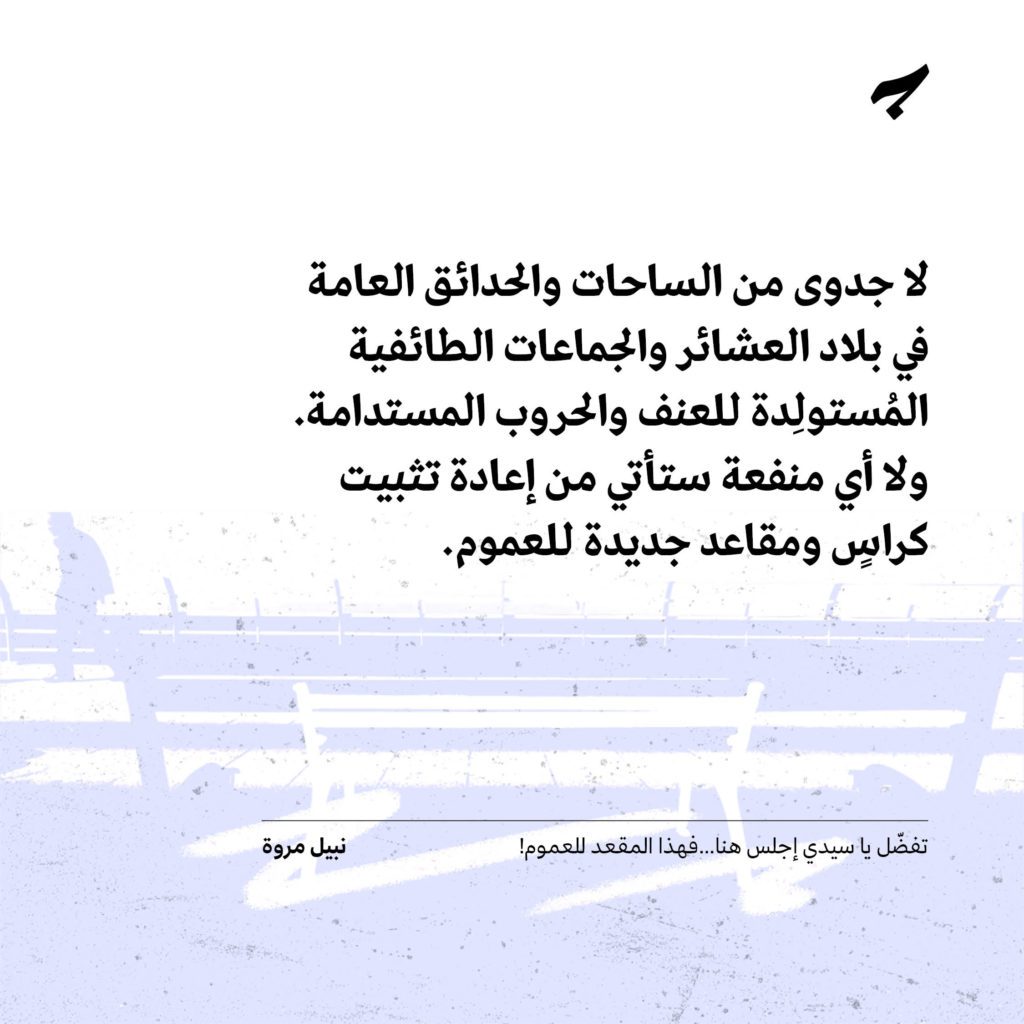
المعماري المعاصر ويتولد ريبشنسكي يقول في كتابه المُعنون (الآن، اُجْلِسُ نفسي: من الكليسموس الى المونوبلوك): “إن الطريقة التي نجلس بها، وخيارنا بالجلوس على ماذا وأين، يُفصحان عن طريقة تفكيرنا ويتكلمان بوضوح عن ذوقنا، وعن الكثير من القيم التي نحملها في عقولنا…”.
في بيروت، المدينة التي عشت فيها منذ الطفولة وما زلت الى الآن، تُخاض حرب شعواء منذ زمن بعيد ليس فقط ضُدّ المقاعد العمومية انما أيضا ضد كل الأمكنة والمساحات العامة في المدينة بكل تفاصيلها وموجوداتها.
انها حرب تُخاض، من أكثرية الجماعات اللبنانية المنتمية الى قبائل وعشائر وطوائف متنافرة حيناً ومتحاربة أحياناً أخرى، تحت شعار انْ لا وجود للمساحة العامة المشتركة وموْجوداتها. ففي الوقت الذي يُظهِر وعي هذه الجماعات حرصاً فائقاً في الحفاظ على المُلكية الشخصية الخاصة بالفرد، وصيانتها وتقديمها بأبهى الصُوَر، في الوقت عينه يُظهِر هذا الوعي استهتاراً تجاه الملكية العامة ورغبة شديدة بالاستيلاء عليها أو تخريبها اذا لم يكن الاستيلاء ممكناً.
إنها ليست حالة فصام نفسية تعيشها هذه الجماعات، بل المرجح، برأيي، أن ثمة نقصاً فادحاً متراكماً في وعيها بشعور الانتماء لوطن ومدينة واحدة، برغم الأغاني والأشعار والسرديات التي قيلت في حب الوطن.
لا جدوى من الساحات والحدائق العامة في بلاد العشائر والجماعات الطائفية المُستولِدة للعنف والحروب المستدامة. ولا منفعة من إعادة تثبيت كراسٍ ومقاعد جديدة للعموم.
هذه الحرب “المقدسة” ليست موجهة ضد المساحة العامة وتفاصيل موجوداتها وحسب، بل هي حرب ضد أفراد لا منتمين إلى طواطم المذاهب وزعمائها، هي حرب من أجل إجهاض أي إمكانية لوجود مدينة ووطن في دولة قانون. كما أنها حرب ضد الكرسي بمفهومه الحديث الليبرالي والإنساني.
الرابح في هذه الحرب سيكون دوماً مفهوم الكُرسي- السُلطة. أمّا الخسارة فستكون من نصيب الكرسي العمومي بمفهومه الحديث والانساني. وستسفر المعركة عن ركام من المقاعد الخشبية العمومية مُذيلّة بلافتة عنوانها: هذا مقعد عمومي…تفضل يا سيدي بالجلوس.
إقرأوا أيضاً:








