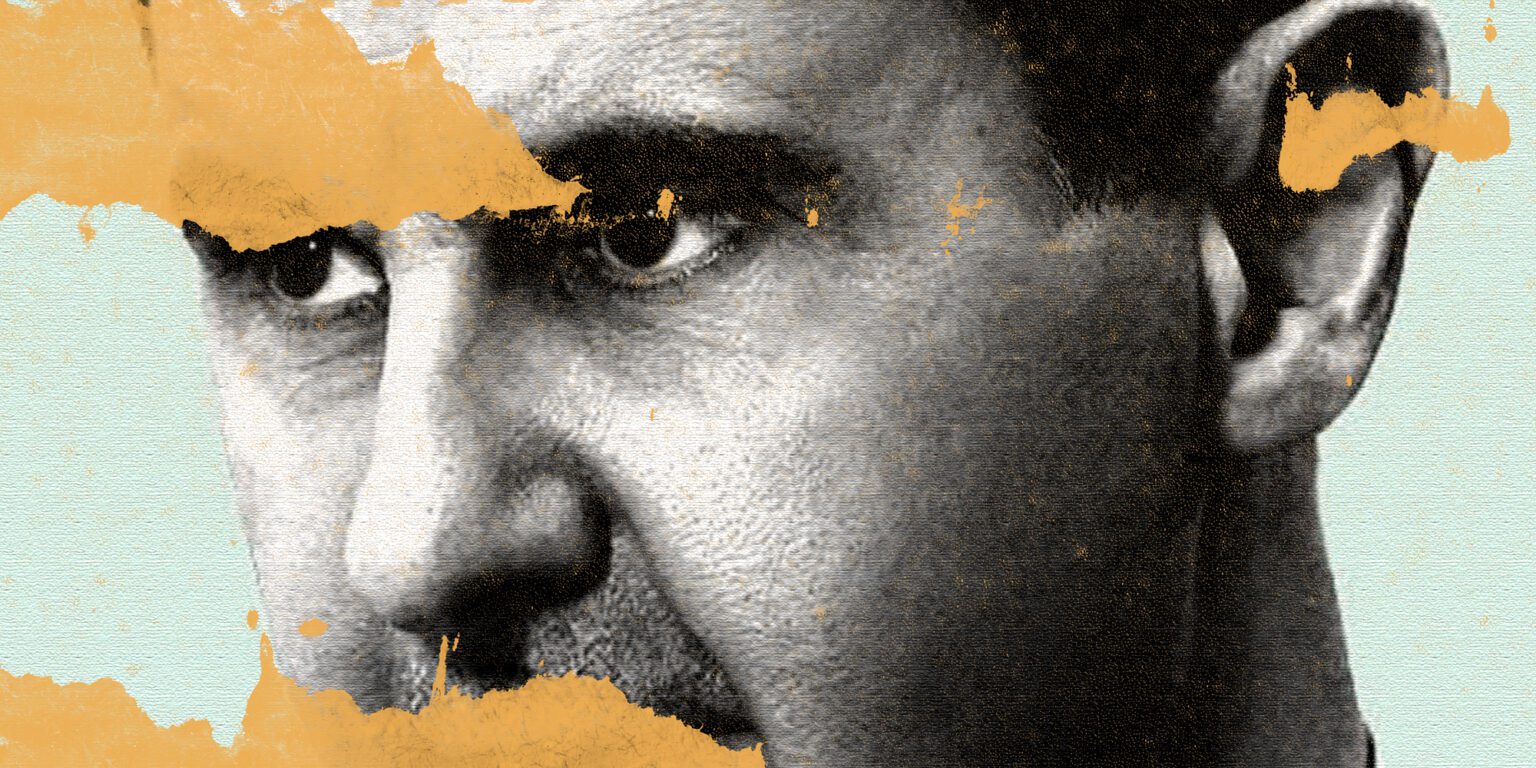يحدثني صديق سوري، لاجئ مقيم في منطقة مجاورة للمنطقة التي أقيم فيها في ضواحي بيرن/ سويسرا، بألم شديد عن جيرانه الأفغانيين في البناء نفسه الذي يقطن فيه. هؤلاء الجيران أمضوا إجازة هذا الصيف في زيارة لأهلهم في… سوريا!
أخبرني صديقي السوريّ بحرقة عن زيارة جاره الأفغاني هذا الصيف، إلى السيدة زينب في ضواحي دمشق. والواضح أن للأفغاني أقارب يقاتلون في لواء “فاطميون” الشيعي الأفغاني، الذي قاتل إلى جانب النظام في سوريا بقيادة الحرس الثوري الإيراني، وقد استقرت بهم الحال وعائلاتهم في منطقة السيدة زينب. يضيف جاري مذعوراً، أننا بتنا في خطر حقيقي قد يحول البلاد التي تركناها فراراً بأرواحنا وأرواح أولادنا وبناتنا، إلى بلاد أخرى لا نعرفها.
لم أتمالك نفسي وأنا أسأل صديقي عن إدلب، التي باتت بدورها أفغانستان أخرى، ولكن بصيغة طالبانية! أعمم هنا الحكم على المنطقة، في إشارة إلى “السلطة” التي لم يوافق سكانها ومن هجّر إليها على هذا “الأمر الواقع”. لكن بقدر ما أثار السؤال امتعاضه، سبب لي ذعراً، إذ خطر لي في اللحظة نفسها التي كان فيها جاري السوري يندب الحال التي وصلت بلادنا إليها بسبب النظام وحُماته، ناهيك بأنه، أي السؤال، بدا لي لحظة طرحه، وكأنه صفعة لكلينا.
فعلاً، ماذا عن إدلب؟! (المقصود ليس إدلب التي عرفناها سابقاً، بل إدلب “الجديدة” في ظل سيطرة القاعدة عليها، كائناً ما كان المسمى الجديد، بعد ألف مسمى سبق، لهذا التنظيم الإجرامي) هل هي سوريا التي نعرفها، أم أنها سوريا أخرى لا نعرفها ولا نريد أن نعرفها؟! الحديث عن سوريا لم يعد له معنى بعدما فقدت تلك الكلمة، سوريا نفسها، معناها تماماً، بسبب ملحقها الذي فرض عليها، طيلة عقود، كل ما يمكن تصوّره من وحشية وفجور: “سوريا الأسد”.
معجم “سوريا الأسد”
تمتلك الكلمات في “سوريا الأسد” وقعاً محدداً سلفاً حسب ذلك القاموس الخشبي والمستعار، أو الملطوش، منذ ما قبل انقلاب حافظ الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 1970. أتحدث عن فترة النصف الثاني من الستينات، حيث حكم يسار البعث، ونشر في الوقت نفسه قاموسه الذي يتضمن الكثير من المصطلحات “المنحوتة”، مثل: انفصالي، انبطاحي، زئبقي، إلى آخره من تلك التوصيفات التي لا يعلم، ربما حتى الله نفسه، ماذا تعنيه بالضبط. (في تلك الحقبة، والتي دامت بضع سنين فقط، لم ينج من قاموسهم الخشبي أحد، حتى أسماء أندية كرة القدم!).
ما يعنينا هنا هو تلك الكلمة التي كثر استخدامها أخيراً، وبالذات من النظام وشبيحته في مواجهة الانتفاضة المستمرة في السويداء ضد النظام، إنها كلمة “انفصالي”. الكلمة التي كلما قفزت أمامي في أي تقرير أو خبر عما يحدث في السويداء الآن، أجد نفسي، مجبراً، ومن دون إرادة مني، على التساؤل حول الذي يحدث في إدلب نفسها، وإن كانت لا تزال جزءاً من سوريا التي نعرفها.
يمكن القول إن شمال شرقي سوريا، الخاضع لسلطة “قسد”، يتم التعامل معه كقطعة منفصلة من عموم السوريين( بمن فيهم الكرد) عن “الجوهرة الأم- سوريا الأسد”، منذ لحظة سيطرة “قسد” عليها. وهذا تيمناً بالحالة الكردية العراقية، أو أقله بانتظار حل ما على مستوى بنية النظام الجديد في سوريا، وصيغته التي يمكن الاتفاق عليها بين كل المكونات، ما بعد حقبة الحكم الأسدي. ذلك النظام الذي لم يولد بعد، على رغم سقوط النظام الأسدي فعلياً.
مفارقة تهمة “انفصالي”
المشكلة الحقيقية بما يخص كلمة “انفصالي” بصفتها تهمة، ليست من جهة النظام الأسدي الفاقد الصلاحية والمعنى أو حتى الحدود الدنيا من الإدراك، بكل أشكاله، بين جميع مؤيديه وقياداته؛ خصوصاً أنه “نظام مخدرات”، بل تكمن في أن قطاعاً واسعاً من السوريين، ضحايا الاستبداد الأسدي وقاموسه الخشبي، ما زالوا مقتنعين حتى اللحظة بأن صفة “انفصالي” هي شتيمة! لكن من هو الشخص الذي يمتلك ذرة إدراك بسيط واحدة، ولا يريد الانفصال عن حفرة الموت التي صارتها سوريا بسبب الأسد وشبيحته؟!
إذاً، حتى نكون منصفين تجاه الحد الأدنى من الحس السليم فقط، فمن باب أولى أن نقول إن الانفصال عن حفرة الموت هذه، هو رد فعل طبيعي لأي إنسان يريد أن يحيا. بعدها يمكن أن نسأل أنفسنا عن شكل “الحياة” الذي نريده، وإن كان موتاً أمرّ من ذلك الأسدي، أم محاولة للبحث عن سبل للنجاة والعيش كبقية البشر، وكلمة انفصالي هنا قائمة على أساس النجاة من نظام الأسد، من دون الأخذ بالاعتبار المقومات السياسية والاقتصاديّة للانفصال، وقدرة “دويلة” على الاستمرار في المنطقة.
إقرأوا أيضاً:
أين تقع سوريا المُتخيّلة؟
لأن البشر أحرار في ما يختارون لأنفسهم (لهذا تقوم الثورات، لإعادة هذا الحق إلى أصحابه)، فمن الطبيعي أن نقول إن إجماعاً ما، في مكان ما، على خيار محدد، أمر لا بد أن نحترمه، كائناً ما كان ذلك الخيار. وهنا، تفرض المقارنة نفسها بين حالتين: إدلب والسويداء. ليس فقط من ناحية الإجماع، بل وأيضاً من ناحية أيهما، ومن خلال انفصالهما “المحقق” في حالة إدلب، والذي ستقود التطورات الأخيرة إليه، ولو كتسوية مؤقتة في حالة السويداء؛ أيّ قد تحوي تلك الحالتان في داخلهما مساحة ما، لسوريا التي ما زال الجميع يحلمون بها، “سوريا المتخيّلة” رغم كل شيء؟!
السؤال الذي يطرح نفسه في حالة إدلب هو: هل اختار ملايين السوريين الذين أجبروا على النزوح إلى تلك المنطقة، الجيب الصغير في شمال سوريا، فعلاً، نمط الحياة المفروض بقوة السلاح عليهم؟ بل، وقبل طرح السؤال المتعلق بذلك النمط السلفي شديد التطرف (الطالباني)، هل اختاروا بطوعهم أن يُرحّلوا إلى إدلب، عبر تلك الحافلات الخضراء، التي صارت، خلال ذروة مرحلة الترحيل، مثار تفكه خفيفي الظل وعديمي الضمير، أنصار الأسد؟
في كلتا الحالتين، ستكون الإجابة بـ”لا” واضحة ولا تقبل أي لبس. أقله عند الحديث عن السواد الأعظم من السوريين الذين عاشوا حياة مختلفة تماماً عن تلك المفروضة عليهم في المكان الذي لجأوا إليه، والذين لم يختاروا بأنفسهم مغادرة مواطن سكناهم، وآبائهم وأجدادهم من قبلهم، بل أجبروا على ذلك بعدما انهار حلم تحويل بلادهم إلى بلاد صالحة للعيش البشري الطبيعي.
إن كان لا بد من الحديث عن “أحلام” بسعة وطن، وورثة تلك الأحلام، ومن دفعوا الثمن الباهظ لفشل تحققها، فبالتأكيد إدلب، بنسختها الطالبانية بالطبع (النسخة التي اغتالت واختطفت وعذبت حتى الموت زينة ناشطيها وقادة الرأي بينهم، من سكان إدلب الأصليين والوافدين إليها على السواء) ليست المكان الذي اختاره السواد الأعظم من اللاجئين إليه، ولا من سكانه الأصليين، بصفته بديلاً عن الحياة في حفرة الموت الأسدية. إدلب التي نعرفها، بطبيعتها وناسها، من دون العمائم السوداء واللحى الطويلة المفروضة عليها الآن، هي من أجمل محافظات سوريا للمناسبة، وفي كل التفاصيل.
أما السؤال عن المساحة المتاحة لسوريا المُتخيلة في إدلب الطالبانية، سوريا التي ما زال الجميع يحلمون بها، فإجابته واضحة… باستثناء راية الثورة، لا وجود لسوريا، التي نحلم بها، ولا إمكان لوجودها، هناك. حتى راية الثورة نفسها كانت تمزق وتداس بالأقدام من إرهابيي التنظيمات الإسلامية (يجب ألا ننسى هذا أبداً) وكانت تفرض رايات تلك التنظيمات على الناس.
لاحقاً، تم تبني رايات الثورة، أهو قرار من “الرعاة”، الممولين وأصحاب القرار الفعلي في تحركات تلك التنظيمات ومصيرها، بالإبقاء على راية الثورة لإعلان وراثتها لأنفسهم حصراً؟! أم أن القرار اتُّخذ خوفاً من تمرد جمهور ثورة 2011 من اللاجئين إلى إدلب، والأدالبة معهم، وهم بالملايين، دفاعاً عن رايتهم وثورتهم؟! هذا التفصيل ما عاد مهماً هنا، كون الصلة بثورة 2011 بقيت فقط عند تلك الراية ولم تتجاوزها أبداً.
في السويداء الوضع يختلف، لم ترفع راية الثورة (العلم ذو النجوم الثلاثة) بما يكفي لتكون رمزاً للتحرك، فهل تملك تلك الراية ما يكفي من المدافعين عنها، وعن ثورة 2011، من أبناء السويداء نفسها؟ هنا، لا يمكن أن ينسى أي ممن شاركوا في ثورة 2011، في مختلف وجوهها، الدور الذي لعبته ضاحية جرمانا، على سبيل المثال وليس الحصر، في تلك الثورة. كانت فعلياً هي القاعدة الخلفية لكل نشاطات الدعم الممكنة للثورة وناشطيها، من أي طائفة كانوا، في دمشق ومحيطها، وحتى أبعد من هذا.
بسبب تلك الأدوار كلها، اعتُقل أبناء جرمانا، نساء ورجالاً، من الدروز، وعُذبوا ولوحقوا وفروا من البلاد كلها. وهؤلاء، مع امتداد مهم لهم في السويداء وقراها، هم بنات ثورة 2011 وأبناؤها، تماماً وبالقدر نفسه الذي يمكن أن يقال عن اللاجئين السوريين الذي أُجبروا على ترك قراهم وبلداتهم ومدنهم والرحيل إلى إدلب، وعن أبناء إدلب. ولكن أين هؤلاء اليوم مما يحدث في السويداء؟ وماذا يعني رفعهم علم الثورة؟! لا يمكن إنكار التظاهرات التي خرجت في إدلب نصرة لأهل السويداء، ورفعت العلم ذاته ذا النجوم الثلاثة، لكن هل “سوريا المستقبل” في إدلب الواقعة تحت حكم إسلامي، هي ذاتها “سوريا المستقبل” في السويداء؟
سؤال تتعلق الإجابة عنه بحجم تلك المساحة المتروكة لسوريا التي حلم بها الجميع، داخل السويداء نفسها. هذه المساحة التي بقدر ما ستكبر، بقدر ما ستلعب دوراً في تحريض بقية المكونات في المشاركة، ليس في مناطق النظام فحسب، بل في إدلب نفسها، إذ لا قيمة لشتيمة الأسد الآن في إدلب… ولكن عندما يتعلق الأمر بالجولاني وأضرابه وسادتهم ومموليهم الإقليميين، فتلك مسألة ستختلف بالتأكيد. وهنا يمكن لإدلب أن تستعيد سوريتها وبتحريض من السويداء. كما فعلتها السويداء مرة وحرضت سوريا كلها على الثورة ضد الفرنسيين.
السؤال إذاً، ليس حول “انفصال” المدينة عن حفرة الموت الأسدية، الذي لا يمكن لعاقل ومحب إلا أن يتمناه للسويداء وأهلها؛ بل هو سؤال حول السويداء الجديدة التي ستنشأ من كل هذه المعاناة اليوم. هل ستكون “السويداء السورية” التي قد تعود إلى لعب الدور نفسه الذي لعبته المدينة والمحافظة وسكانها من الدروز إبان ثورة 1925 في سوريا؟! ولا داعٍ هنا للقول بأننا “نحشو” حراك السويداء بما لا طاقة له به… فعلتها السويداء سابقاً وكانت جديرة بها، وهذا الفعل نفسه، ثورة 1925، هو الذي يشكل الركيزة التي يستند إليها جلّ أبناء المحافظة في تحديد دورهم وهويتهم كسوريين. وهو الحدث التاريخي نفسه الذي استند إليه، في تعريفه للمحافظة وأهلها وهويتهم الطائفية والوطنية، من استنتج لاحقاً بأننا وعبر أسئلة مشروعة يجب أن يواجه بها حراك السويداء، إنما “نحشو” هذا الحراك بما هو فوق طاقته!
الإجابة عن السؤال أعلاه بنعم، كما يتمنى كثر، تتطلب حضوراً وازناً وبارزاً لبنات ثورة 2011 وشبابها من أبناء المحافظة، وتأثيراً مباشراً وملموساً من جهتهم على الحراك، يشي بحجم شعبيتهم داخله؛ أما إن كانت الإجابة بلا، فسنكون أمام “السويداء الدرزية”، وبالتالي ستنضم إلى “إدلب الطالبانية”. ولينادوا ساعتها بسقوط الأسد ما شاؤوا، ولننتظر “جميعاً” نحن الحالمين بسوريا ما بعد الأسد، كدولة متخيّلة تسكنها جماعة متخيّلة.