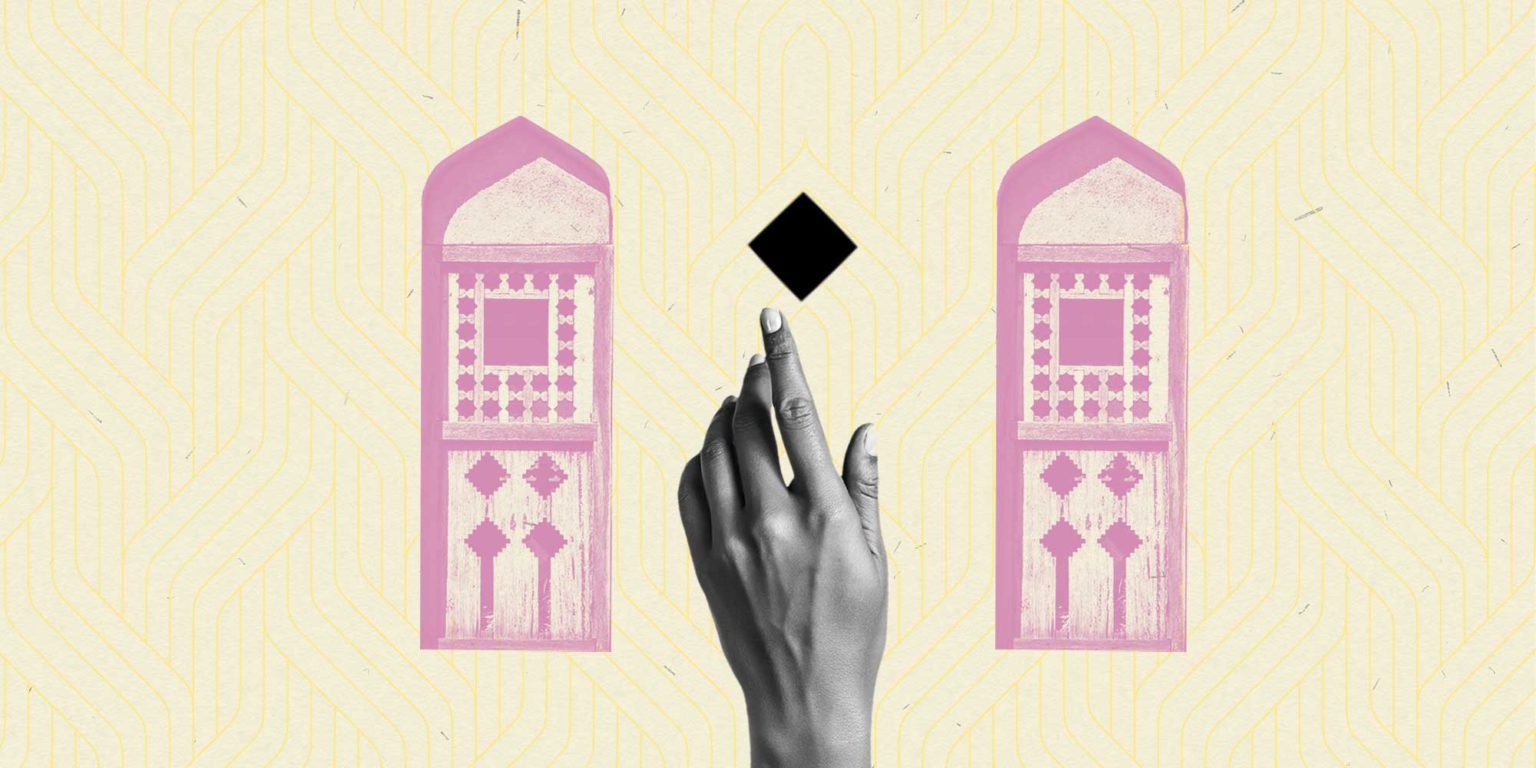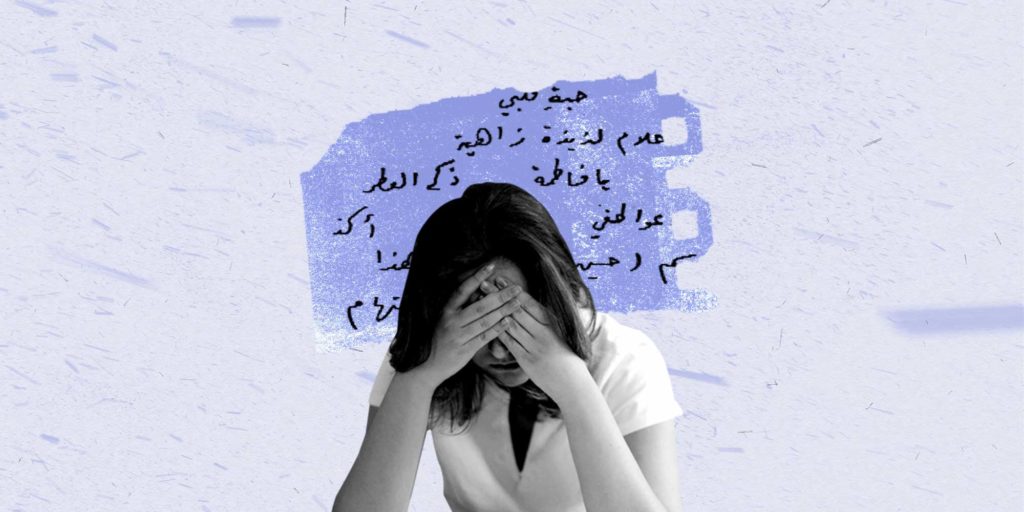لا يتطوّر مجتمع أو يتقهقر لسبب يكمن في طبيعته.
ليست الحضارة حِكراً على جنس أو عرق أو لون، لكنها حِكر على معرفة دون أخرى.
ليس الجنس أو العرق أو اللون العظيم هو الذي يبني الحضارة، بل الحضارة (وهي نَسَق معرفي ثقافي معيّن) هي التي تجعل مِن شعبٍ ما عظيماً.
لا تتحضّر الأمم إلا حين تكون الحضارة حاضرة في ذهنيّتها، وحين تُدرك أنها (تحتاج) إليها إذا ما أرادت أن تحيا وتستمرّ وتبقى.
ولا تستطيع أمّة أن تتحضّر إلا حين تعرف ماهية الحضارة، وكيفية تحقيق ذلك.
لا تغيّرات ملموسة قريبة ستتحقق لصالح حل مشكلة الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ سيكون حدوث مثل هذا التغيير لمصلحة الحياة وحبّها واحترامها خلال الـ٢٠٠ عام القادمة خارقاً بكل المقاييس.
أن تنتقل نُظُمُ السلطة القبليّة لِتَصير نُظُمَ المواطنة والمدنيّة والحداثة، وأن ينتقل مجتمع (الولاء لمن يُشبهون ويَتّفقون) و (البراء ممن يُخالِفون ويَختلفون) إلى مجتمع التعدد والرفاه خلال قرنين من الزمن لهوَ الإعجاز بعينه!
وفي ظل التغيرات النوعيّة المعاصرة التي تطرأ على ظروف العالم كأزمة الأوبئة والاحتباس الحراري تصير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سباق جدّي وحاسم مع الزمن لن تنفعها فيه جملة معارفها القديمة، لعلّها -قبل بقية دول العالم- ستصير المسرح الضخم للأجزاء القادمة من فيلم MAD MAX !
قال الربيع العربي إن الفقراء (فقراء الحقوق) الذين يُشكلون غالبية السكان يريدون شيئاً؛ لا نستطيع أن نتّفق على أنهم كانوا يريدون شيئاً مُحدَّداً بعينه، لأن الاختلافات بين الأطراف عميقة ومتباينة بشكل دموي مقيت، وهو ما يُشير إلى أن (الحق بالحياة) نفسه هو موضع جدل وخلاف، وهذا ما يجعل من القضية شائكة ومعقدّة يتطلّب حلّها ٣ قرون على الأقل من العمل الجاد والمضني، وربما حربين كُبريين أو ثلاث كي يتسنّى للعقل الجمعي فيها معرفة الحدود التي تميّز المصلحة عن الضرر (الحياة عن الموت)، اللهم إلا أن تحدُث سابقة تاريخية!
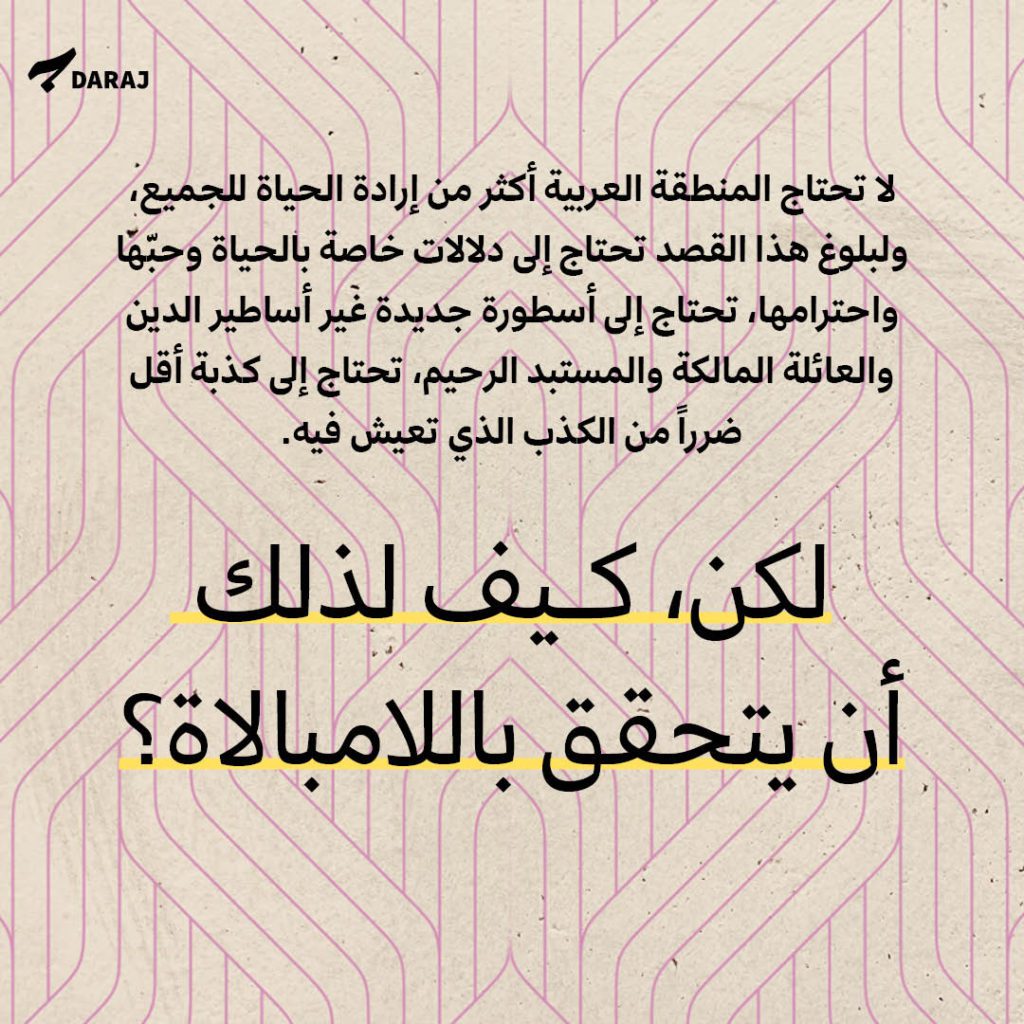
خَلُص العالم الحديث إلى نتائج أكّدتها تجارب قاسية في أكثر من موضع زماني ومكاني قالت بأنّ الإنسان جدير بأن يُعوَّل عليه، وبأن إرادة الحياة غير ممكنة دون اعتبارها مصلحة مُقدَّمة على كل المصالح، وأن العقل يَصف العالم ويستطيع فهمه والحكم عليه والتشريع فيه لتحقيق تلك المصلحة، وأنّ للإنسان كل الحق في أن يحيا حياته بالطريقة التي يريدها طالما أنه لا يدعو إلى الكراهية ولا يحرّض على العنف تجاه الآخرين.
من ناحية أخرى، لم تستطع الكثير من شعوب العالم، وفي مقدّمتها شعوبُ المنطقة العربية أن تضع حدّاً لصراع قديم بين العقل واللاعقل، ناهيك عن أن تحيط وعياً بآليات تَهافُت المستبدّ القديم (العسكري والديني والأميري) على السلطة، ولم تستطع كذلك لا أن تثق بالإنسان، ولا أن تعوّل عليه، ولا أن تتجاوز مآسيها على أصعدة السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة والفن والدين.
لا يزال حال الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتدهور منذ القرن الثالث عشر للميلاد، ولولا أن أقوياء العالم اليوم استفاقوا -نسبياً- إلى ضرورة اللجوء إلى السِّلم لكانت المنطقة لا تزال ترزح -رسمياً- في عصور الانتداب حتى اليوم!
في الفترة التي سبقت القرن الثاني عشر كان حالُ الأوروبيين متقارباً مع حال جيرانهم العرب المسلمين، لكن شيئاً فشيئاً كانت الكفة تميل لصالح الأوروبيين، في حين بدأ الواقع العربي تخلّفهُ وانحطاطه المدوّي على كافة الأصعدة.
لم يبدأ الأمر حين استعاد الإسبان الأندلس، بل قبله بحوالي مائتي عام، في الفترة التي تعرّض فيها الشارح الكبير لأرسطو إلى النفي والاضطهاد، حين أُلزِم العقل بالوقوف جانباً، ليُؤتى بحراس المعبد ورجال الكهنوت كي يجاوروا الراعي ويستفردوا معرفيّاً وإدارياً بالرعيّة حتى يومنا هذا.
وما الواقع المأساوي الذي تعيشه شعوب المنطقة إلا (نتيجة) لتخلّف معرفي قديم أودى بها إلى ماهي عليه اليوم؛ مُعَاداتُها للعقل والشكّ، وتغليبُها الأسطورة في شؤون الحكم والإدارة، وتعطيلُها أبسط شروط التعلّم والاكتشاف، ونبذُها وتحقيرُها للإنسان والفلسفة والعلوم جَعَلَها مستعصية في مؤخرة السلّم الحضاري.
لا نستطيع أن نقول بأن العقل العربي متوقّف عند نقطة معينة في التاريخ الماضي، وذاك لأن الزمن يسير باتجاه واحد وهو الأمام، لهذا فالتوقّف يعني عودة إلى الوراء بالضرورة، أي بُعداً عن الحاضر الذي يزداد ابتعاداً في كل يوم، وفي كل دقيقة.
في المقابل يستطيع كل المراقبين أن يتأكّدوا بصريح الأدلّة من أن معرفة العقل العربي عن العالم لا تكفيه لإطعام الخبز، ناهيك عن أن تعدِل في تقسيمه، أو أن تبني الحضارة!
نشأ كاتب هذا المقال في بلدة صغيرة بين حلب والرقة، درسَ الشريعة الإسلامية سبعة أعوام، واشتغل خطيباً في مسجد لأربع سنوات، وكان على اتصال وثيق بقاعدة الهرم الاجتماعي السوري، هناك حيث السلطة لما هو منقول على ما هو معقول مثلما هو الحال في الكثير من دول العالم أو ربما كلها!، عايشَ الثورة والحرب الأهلية السورية على اختلاف شعاراتها ومراحلها، وشهِد اتساع نفوذ الآيديولوجيا الجهادية في عقر داره، اشتغل صحفياً في سوريا وتركيا قبل أن يفرّ منها هارباً إلى أوروبا، وهو الآن يريد أن يدلي بشهادة قد تكون مفيدة!
إقرأوا أيضاً:
المعرفة
إننا نُولد صفحة فارغة، نجهل كل شيء، ونتعلم كل شيء بالاكتساب.
منذ اللحظة الأولى تتم عملية إدماجنا في سياق معرفي يُحيط بنا، ويشمل كل مناحي حياتِنا، إنه الأسرة، والشارع، والمدرسة، ودار العبادة، والجامعة، والمكتبة، والعمل، والتلفزيون، والراديو، والإنترنت، وهو حيّز تجربتنا الحسية والإدراكية.
ومن خلال ما نكتسبه داخل هذا السياق يتشكّل وعيُنا بالعالم، وفهمُنا لقوانينه وقواعده والطريقة التي يعمل بها، ويتبلوَر حُكمُنا وتقديرُنا لكل شاردة وواردة في حياتنا.
هذه المعرفة هي النظام الذي تعمل وُفقه عقولُنا، وهي ما يُشكّل الفارق الأكثر وضوحاً بيننا وبين الكائنات الأخرى، وبيننا أنفسنَا كأفراد ننتمي إلى الجنس البشري، وهي الفارق بين الحضارة والحضارة الأخرى.
إننا لا نولد عارفين بالخير والشر من تلقاء أنفسنا، ولا واعين بشكل فطري للفرق بين المصلحة والضرر الذي تُحدثه اختياراتنا، ولا بين الحرية والعبودية، ولا بين الديموقراطية والديكتاتورية، ويَعتَمِدُ معنى كل شيء في حياتنا على ما نتلقاه ونستقبله، لذا فالأصل فينا جهلُنا، والاستثناء هو أن نعرف.
بقدر ما تكون هذه المعرفة التي نكتسبها قاصرةً عن الإحاطة بالعالم حولنا، بقدر ما ينعكس ذلك قصوراً في فهمِنَا أنفُسَنَا، وقصوراً في فهم الطريقة التي يعمل بها العالم، وفي تفاعلنا معه، وفي معرفتنا بالممكن والمستحيل فيه، وبالتالي قصوراً في أفُق حاضرنا، ومآلات مستقبلنا.
فالـ “ممكن” النرويجي مثلاً يختلف عن “الممكن” الفنزويلي نظراً للاختلاف المعرفي بين كلا الشعبين/الحكومتين/الدولتين، فكل منهما يدير شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والثقافية بالطريقة التي يَعرفها، بالطريقة التي (يرى الصواب من خلالها)؛ والواقع النرويجي يتغيَّر بتغيُّر المعرفة النرويجية، وكذلك يتغيّر واقع أي أمة في العالم.
يُولد الإنسان جاهلاً ليتعلّم كل يوم، وهو محدود بحدود معرفتهِ التي تُشكّل هويّته، والتي يتوقّف عليها مصيرُه ومستقبلُه.
الخير – الصواب – الفضيلة
أخطَر ما في المسألة هو أنني لا أستطيع أن أرى (إلّا) الصواب الذي تقودني إليه معرفتي، بمعنى أنني لا أستطيع أن أختار ما لا أعرف نفعه، ولا أن أتجنّب ما لا أعرف خطره، لا أستطيع أن ألاحظ أصلاً ما هو خارج حيّز إدراكي، ما هو غائب عن مجال وعيي، لا أستطيع أن أختار ما لا أرى الصواب والخير والفضيلة والمصلحة فيه.
فحين أكون فاسداً أو مجرماً مثلاً فإنني إنما أفعل ذلك لاعتقادي بأني أفعل (الصواب) من وجهة نظري، وذاك لأن مجموع معرفتي هيَ من تقودني إلى هذا الاستنتاج، لأن تعريفي وفهمي وتقديري لكلمة “الصواب” أو “المصلحة” أو “الخير” أو “الفضيلة” يقتضي هذا القول أو الفعل أو الاختيار الذي أقوم به.
وحين أفعل ما تفعله مجموعة من الناس، فأختار ما يختارون، وأتحدث ما يتحدثون، وأنتمي إلى ما ينتمون، فإنني إنما أفعل ذلك لاعتقاد مني بأن هذه الطريقة هي الطريقة الصائبة لفعل الأشياء، وسأظل متمسكاً بها طالما أرى الصواب فيها، طالما أعجز عن ملاحظة الضرر الذي تُحدثه.
إنني حتى وإن اخترتُ أن أُنكر حقيقة الضرر الذي تتسبّب به اختياراتي فذاك لأنني أرى الصواب في الكذب على نفسي.
فَلَو يعلم السياسي الفاسد، أو الإرهابي الذي يفجر نفسه، أو الديكتاتور الذي يُعادي كل من يعارضه.. لو يعلم أنه يَسير بنفسه إلى (ما يَجلب لها الضرر الجسيم) لما أقدم على اختيار ذلك؛ لو لم يعتقد أن (مصلحته) تكمن فيما يفعله لما أقدم عليه، لسبب بسيط، وهو أننا لا نستطيع أن نختار لأنفسنا ما لا تستسيغه عقولنا وضمائرنا.
هذا يعني أن الإنسان على الدوام هو الأدقُّ تعبيراً عما يدور في عقله، وهو أصدق التابعين وفاءاً لمعرفته وأفكاره لأنه لا يستطيع أن يَكُوْن ما هو غائب عن عقله، وهو في كل يوم وفي كل لحظة يكشف عما في وعييه قولاً وفعلاً وحضوراً.
وللأسف، هذا يعني أيضاً أن واقع الإنسان اليوم هو أفضل ما يستطيع أن يقدّمه، فلو كان (يعرف) طريقة (أفضل وأكثر صواباً) للقيام بالأشياء، لَقامَ بها!
إننا نُولد صفحة فارغة، نجهل كل شيء، ونتعلم كل شيء بالاكتساب.
السلطة دائماً وأبداً
تتخذ السلطة مكاناً لها في أعلى قمة الهرم الاجتماعي للدولة، ولا يمنحها ذلك القدرة على أن تدفع باتجاه خير الناس وصلاحهم فحسب، بل يمنحها أيضاً القدرة على اختيار الفشل الذريع والموت.
لكن، ما هي السلطة إن لم تكن “الزبدة”؟ إنها خير الحليب كله، أليست السلطة هي خلاصة ما يَقبَلُه الشعب؟ أليست هي ما يراه الشعب صواباً في الاقتصاد والمجتمع والسياسة؟
في كتابه “الحداثة والهولوكوست” يقول عالم الاجتماع البولندي زيجمونت باومان: “لا يمكننا بعد اليوم أن نلوم هتلر وحده على ما حدث وما يمكن أن يحدث، فإلى متى نُبرئ ساحة المؤسسات الثقافية والعلمية والإعلامية والبيروقراطية التي ساندت هذا الرجل؟ وإلى متى نبرئ ساحة المثقفين الذين وَجدوا في جرائمه رسالة ثقافية حضارية ومحارَبة للظلامية؟ وإلى متى نبرئ ساحة رجال الدين الرسميين وغيرهم ممن أضفوا على تلك الجرائم صبغة شرعية؟ وإلى متى نبرئ ساحة الجامعات التي التزمت الصمت إزاءها، لا بل وتعاون مثقفوها مع أجهزة الأمن في استبعاد مئات الآلاف من عالم الالتزام الأخلاقي؟ وإلى متى نبرئ ساحة أساتذة الفلسفة والأدب الذين أحيوا فلسفة “الكائن المستباح” لا لشيء سوى أنه -في نظرهم- يخالف السلطة الإلهية للدولة؟!”.
لا أحد يحكم لوحده، لا تستطيع سلطة في العالم أن تنال الشرعية في شعب لا يستسيغها بعقله؛ سُلطة أي شعب هي خلاصة ما يَعرفه ويَقبلُه هذا الشعب، “الأب القائد” في سوريا هو مفهوم موجود داخل الأسرة السورية قبل أن يوجد على المستوى السياسي، طائفيّة السلطة اللبنانية تستمدّ شرعيّتها مما يعرفه ويقبله العقل الجمعي اللبناني؛ والأنظمة الأميريّة في دول الخليج هي الخير والصواب حسب تصوّرات الأسرة الخليجية.
إن أصغر الدوائر الاجتماعية في الدولة هي قاعدة الهرم التي نستطيع أن نكشف من خلالها ما يَحدث على مستوى السياسية في الأعلى، وأصغر دائرة اجتماعية هي الأسرة التي حين نعرف ما تعرفه نستطيع أن نعرف إلى أين يتّجه مستقبل مجموع الأُسَر في الدولة.
والأسرة أولاً لأن الأسرة هي الآخَر الأوّل الذي (نتعلّم منه) و (نتعامل معه) في حياتنا، إنها مرجعيتنا المعرفيّة الأولى، إنها الأساس الذي ننطلق منه، إنها قاعدة النظام وقاعدة السلطة؛ وطبيعة العلاقة بيننا كأفراد داخل هذه الأسرة تنعكس على طبيعة العلاقة بين مجموع الأفراد في الدولة.
فالعلاقة الأُسريّة المحكومة بنظام أبوي تعني أن الأبوية مُستَسَاغة كنظام إداري-سياسي، ونبذ الرأي الآخر في الأسرة يعني أن المخالفين منبوذون على مستوى سياسي، العنف في الأسرة يعني أن الدولة نفسها تستسيغ العنف.
والعلاقات الأسريّة القائمة على أساس التمييز الجنسي بين أفرادها تُشير إلى (وعي) معيّن، تشير إلى (صوابيّة) منح الأفضليّة لأحد الجنسين على الآخر، وهذه (الصوابية) بدورها تكشف عن نظام معرفي أعمّ وأشمل تتشاركه مجموع الأُسَر، وهكذا يكون التمييز الجنسي (صواباً) على مستوى الأفراد في الدولة.
بهذا المعنى يبدو القول “كما تكونوا يُولّى عليكم” قولاً صحيحاً، لأن الحاكم ونظامه الذي يَحكُمكم هو ابن أُسَرِكم، ابن معرفتكم التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، ابنُ معرفتكم الإدارية والسلطوية، وابنُ فهمكم لأنفسكم، وابنُ فهمكم للعالم.
إقرأوا أيضاً:
المشكلة
لا يتغيّر واقع مجتمع إلا بعد أن يطرأ التغيير على واقع أصغر الدوائر فيه؛ ولا يتغير واقع إنسان دون أن يتغير وعيه، ووعينا بالتحديد هو المشكلة.
من يمتلك المعرفة يُسخّر الطبيعة لصالحه، من يرى الصواب في العدالة يعدل، من يراه في القتل يقتل، من يجهل المصلحة في الخير لا يستطيع أن يختاره، من يجهل مصلحته يقودها إلى تهلكة.
في أواخر العام ٢٠١١ عُدنا أنا وصديق من مظاهرة مناوئة للنظام السوري في بلدة “مسكنة” بين حلب والرقة، وكان قد أنهى أكبرُ إخوته آنذاك مُدةَ خدمتهِ العسكرية، ولهذا اجتمعنا مع بعض أقاربه والمعارف في منزله حول مائدة طويلة أُعدّت خصيصاً للاحتفال بهذه المناسبة، وبعد أن هدأت الأنفس والبطون وحان موعد شرب الشاي، وفي جوقة تداول الأحاديث حول ما يجري في سوريا ألقى أحد الوجهاء في صدر المجلس جملةً لا يزال يتردد صداها منذ ذلك الوقت.
قالها بلهجة سكان حوض الفرات السوري، وبملامح جادّة تخلو من أي حياد أو موضوعية: “يا ابن أخوي، نحنا ما نريد حرية، آني ما أريد بناتي يفرعن ويروحن ع المدارس”. ومعنى “فرَّعَ” بلهجة أهالي حوض الفرات السوري أي حسَرَ الرأس، كَشَفَهُ.
قد يَقصد صاحبنا أنه لا يريد أن يتم إلزام بناته بالتخلي عن الحجاب كشرط لدخول المدرسة، وقد يقصد أيضاً أنه لا يريد أن تَمنحهُنّ كلمة “حرية” الحقَّ نفسه بالتخلي عن الحجاب، لا نستطيع أن نتأكد مما كان يريد قوله بالضبط، لكننا على جميع الأحوال نتّفق على أن هذا الرجل الذي تستطيع أن تقابله في كل مكان في العالم يجهل ما تعنيه الكلمة، وهذا هو جوهر المشكلة برمّتها.
لطالما كان موضوع اللغة شاغلاً ومؤرّقاً، إبان دراستي للشريعة لم يفارقني السؤال: لماذا نختلف على ما يقوله النص؟ إلى أي حدّ يريد منا “الله” أن نعرف كي نتمكّن من فك شيفرة ما يقول؟ ما هو هذا العقل الذي يستطيع أن يُبرهن بشكل حاسم وقطعيّ على صحة فهمه لما يريد القولُ حقيقةً أن يقول؟ كيف يمكن فهمه بدقة ١٠٠٪ في حين أن كل كلمة فيه قابلة للتأويل إلى ما لا نهاية؟!
ثم حين بدأت التنظيمات الجهادية تتوغل في عمق المجتمع السوري بعد الـ ٢٠١٢ بدا جليّاً وجدّياً كيف أخذَ الاختلافُ على تأويل مقاصد النص أبعاداً دموية لا حصر لها، دون أن يستطيع أيّ من الأطراف المتحاربة آنذاك أـن يُحدِّد أو يُؤكّد على “المعنى الصحيح”؛ لولا القوة!
تبيَّن بعد ذلك أن مشكلة التأويل ليست مشكلة محصورة بالنص القرآني وحده بل هي مشكلة أعمق بكثير، مشكلة في اللغة نفسها، لا العربية فحسب، بل مشكلة عالمية تخص كل لغات العالم، وإلا لماذا كانت كل تلك الأناجيل والشروحات والتفاسير والنسخ لو أن اللغة فعلاً كافية ووافية لتحديد الأشياء وحصرها والإشارة إليها؟!
هذه الرموز المرسومة والمكتوبة والمقروءة والمنطوقة التي نتواصل بها هي إشارات غير مفهومة، لا يستطيع أحد أن يحيط علماً بحقيقة مقاصِدِها، لأن كل كلمة فيها تعتمد على تأويل خاص بكل واحد منا.
ليس للكلمات معنى ذهبي، فلكل كلمة تفسير يتضمّن مجموعة من الكلمات، وهذه الكلمات تتطلب بدورها شرحاً باستخدام المزيد والمزيد من الكلمات …
اللغة هي الشعر نفسه، حين نريد أن نفهم ما تريد قوله فإننا نلجأ إلى تأويل مفرداتها، ثم نُرجّح أحد المعاني على البقية، وهذا التأويل هو المشكلة التي يتوقّف عندها كل شيء في حياتنا، لأنه يعتمد على مجموع ما نعرفه، يعتمد على مجموع خبرتنا اللغوية، على كل التراكيب والصور التي نعرفها، أي على مجموع (ذاكرتنا المعرفيّة)؛ وما عساها تكون تلك الذاكرة إن لم تكن المكتبة!، ثقافتنا، ذاكرة كلّ الذكريات.
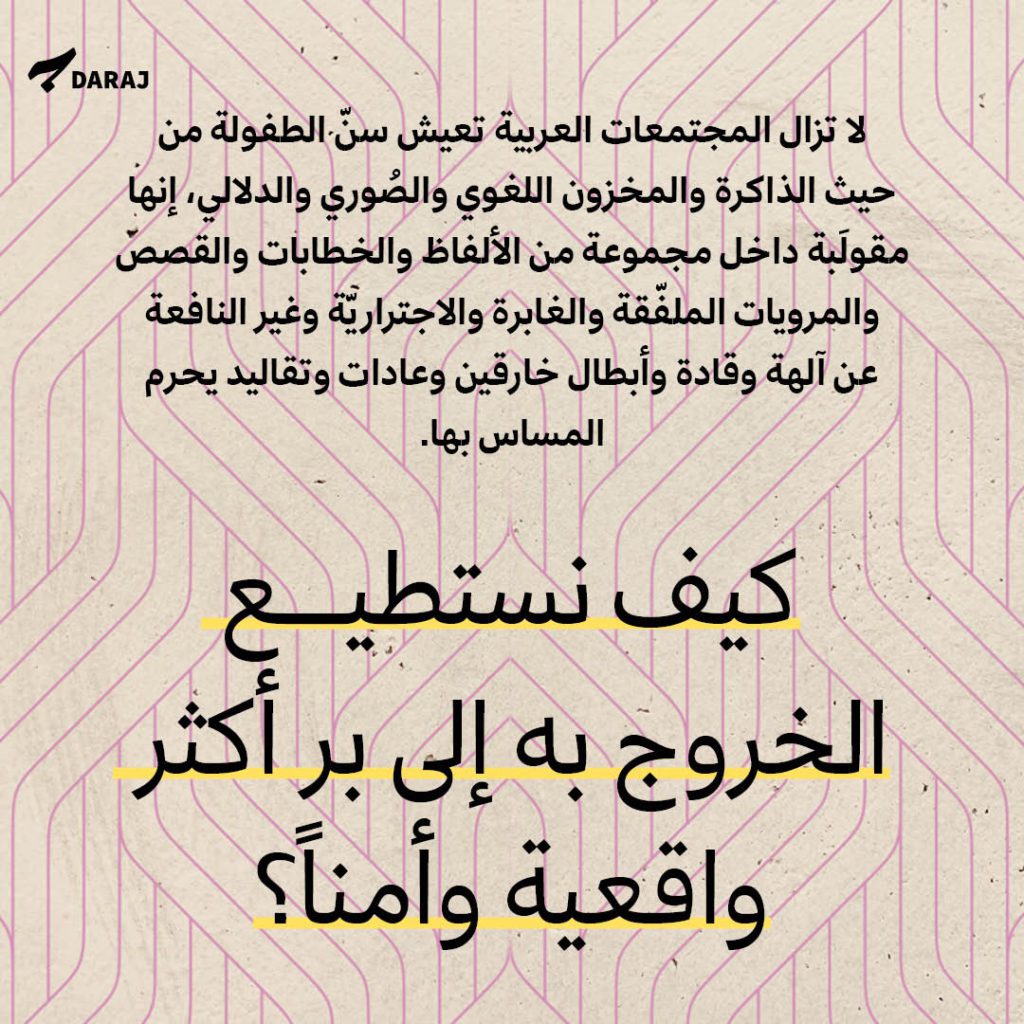
ولنفرض مثلا أن روائياً يصف لك في الرواية كرسيا في غرفته، فإنك لا تستطيع أن “تفهم” منه شيئاً دون أن تعود إلى ما لديك، قصور حصيلتك الصُّورية-اللغوية في هذا المقام سينعكس بالتأكيد على فهمك وتفاعلك مع ما يقول.
فلو كان معنى كلمة (كرسي) ينحصر في معرفتك مثلاً بكرسي ذي أبعاد خاصة لا تعرف غيره، فإنك وقتها لن تفهم مما يقول أبعد من الكرسي الذي تعرفه.
ولو افترضنا أيضاً أن أحداً استطاع إقناعك بطريقة ما أن “الكرسي” يجلب “ضرراً”، فإنك لن تستطيع أن تختار ما تعتقد أنه سيجلب هذا “الضرر” إليك، بالمثل تتفاعل مع كل قضية في هذا العالم.
بهذا المعنى يبدو القول “إنّ مِن البيانِ لَسِحْراً” قولاً صحيحاً، لأن الناس مسحورون لصالح الخطاب الذي تتفاعل معه عقولهم، مسحورون ومحكومون لصالح الخطاب الذي يستسيغون فهمه؛ لا خيار آخر لدينا، إننا مُقيّدون بحدود فهمنا لهذه الإشارات التي ندعوها باللغة.
يبدو أن كلمة “حرية” أثارت في نفس صاحبنا صور عدم ارتداء بناته للحجاب في مكان عام، وهذا ما لا يرى المصلحة فيه، ولا يريده، ولا يمكن أن يختاره.
فهمُهُ للكلمة ليس اعتباطياً، هذا الربط بينها وبين التصوّر الذي يتصوّره هو ربط مكتسب من الواقع المعرفي الذي يعيش فيه، ويتشاركه مع الناس حوله.
حدثتني والدتي عن قصة مشابهة تقريباً، تقول بأن والدها لم يسمح لها بالذهاب إلى المدرسة دون ارتداء الزي التقليدي -يُدعى “الصاية والزبون” في منطقة حوض الفرات السوري- الأمر الذي رفضته إدارة المدرسة، لينتهي بها المطاف في ألمانيا دون أن تتعلم قراءة العربية أو كتابتها.
يبدو أن الرجلين على اختلاف جيلهما ينهلان من معرفة واحدة، إنهما يتشاركان تصوّراً متقارباً لمعنى “الفضيلة”.
هكذا تتآلف عقول وأفئدة وضمائر وقلوب الناس، حين تتشارك تعريف العالم بالمفاهيم نفسها التي ترتبط بالتصورات نفسها.
مجموع هؤلاء الناس الذين يتشاركون تَصوُّراً معيّناً للغة يُشكلون المجتمع، قواعده وقوانينه التي تُنظّمه، معنى الخير والشر، والخطأ والصواب، والفضيلة والرذيلة فيه، وبالتالي واقع ومستقبل الدولة بطبقاتها الاجتماعية والاقتصادية، والأهم: السياسيّة.
إذاً، يستحيل أن تتمخض السلطة عن غير جنس معرفتها، العلاقة بينهما بيولوجية، السلطة على مجموعة من الناس هي سُلطة تتحدث نفس لغتهم، وتتشارك معهم وعيهم وثقافتهم ومجموع القيم التي يتصوّرونها في حياتهم، فالنبي الصيني يُبلّغ رسالته بخطاب صيني، بمفاهيم وثقافة ومعرفة وتصوّرات صينية، ولهذا السبب السلطة في مصر لا يمكن إلا أن تكون مصرية، وفي سوريا سوريّة، وفي لبنان لبنانية.
فالسلطة هي نحن، هي مجموع كلماتنا وتصوّراتنا الخاصة عن اللغة، هي الخطاب الذي نتواصل من خلاله، هي فهمُنا للغة، إنها الخطاب الذي نستسيغه ونَقبلُه ونُذعِن إليه.
لا تستطيع سلطة أن تنال شرعية في وسط تعجَز عن التواصل معه بشكل مستساغ ومفهوم، وليس من مصلحة السلطة أن تخاطبنا بما لا نستسيغ تَصوُّرهُ، وإلا تخسر بالتالي منصبها.
في إيران، لم يكن من مصلحة بقاء الشاه محمد رضا بهلوي في الحكم أن يقتصر مفهوم “الانفتاح” على عروض السينما الأوروبية، الأمر الذي لم تكن غالبية الشعب مستعدة لقبوله بديلاً عن الإصلاح السياسي والاقتصادي، الأمر الذي ألّبَهم عليه، وحين عاد الشعب إلى معرفته لينطلق منها نحو التغيير لم يجد في غير “آية الله” بديلاً.
وبالمثل، ليس من مصلحة الحكومة الحالية في لبنان أن تسمح بابتكار تصوّر أوسع لمعنى “المواطنة” يتجاوز تصورات “الطائفة” لأنها تصير وقتها مُطالَبة بأن تعيد ابتكار نفسها إذا ما أرادت أن تواكِب الجمع وتحافظ فيه على السلطة.
وليس من مصلحة بقاء السلطة في السعودية أن يكون لـ “العدالة” معنى آخر غير ما تقتضيه مصلحة “الله” و “ولاة الأمر”، لأنها تصير وقتها مطالَبة بالتخلّي عن أسطورة شرعيّتها القبَليّة الدينية في موضع السلطة.
وليس من مصلحة بقاء السلطة في قطر أن يكون لـ “الديموقراطية” معنى أوسع من استبعاد آل مرّة، وليس من مصلحتها أن تشمل الديموقراطية الحق باختيار رأس النظام وشكله والحكومة.
لهذا السبب تريد تلك الحكومات التي تقود المنطقة نحو الهاوية أن تُحكم قبضتها على الخطاب واللغة، على الصحافة والراديو والتلفزيون والإنترنت، تريد احتكار المعاني، لأنها لا تريد أن تسمح لنا بتصوّر واقع آخر لا يحافظ على امتيازاتها.
مَن يُسيطر على الكلمات يسيطر على الفكرة والتفكير، والتصوّر والتقدير، والحكم والتدبير، ويُحدد معنى العالم والطريقة التي نحيا بها فيه.
تجلّيات المشكلة على واقع المنطقة العربية
ترتبط اللغة العربية بالدين، وتستمد منه روح المعنى والدلالة، وهذا الدين متداخل بدوره عميقاً بكل ثقله المقدّس في اللغة، لهذا يرتبط تعريف العالم في العربية بالإحالة إلى جملة التصورات الدينية التي تشكّل الذاكرة المعرفية، والواقع المعرفي الثقافي العربي.
يؤمن أبناء جلدتنا بالمعجزة، بالخارق للعادة، باللامحدودية، بما لا يمكن للعقل أن يتصوره، وبالتالي فإن معنى حياتهم بحد ذاته غير قابل للتصوّر، لأنه معنى إعجازي!
يعتبر أبناء جلدتنا الحياةَ اختباراً للطاعة، فالإرادة العليا (الله) خلقت السماوات والأرض لغرض واحد، وهو أن تختبر الناسَ أَيُهُم أحسن عملاً، عِلما أن الإرادة العليا تعرف مسبقاً الصالح من الطالح بوصفها تعرف كل شيء، ما يعني أنها خلقتنا بين السماوات والأرض لغرض التسلية!
يَعتبر أبناء جلدتنا في إرادة الحياة شأناً دنيوياً، وذلك باعتبار كلمة “دنيوي” هنا تشير إلى ما هو فانٍ، وزائل، ومنزوع القيمة، ومحدود؛ في مقابل إرادة ذاك الثابت، والكامل، كُلّي القيمة، المُطلَق، واللامحدود: الإرادة الإلهية بقضائها وقدَرِها.
يرون في الإنسان كائناً ملعوناً لفضوله، مَسلوبَ الإرادة والاختيار بـ “القَدَر” الذي لا قدرة له على تجاوزه، باعتبار أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم مقابل أن يمنحهم الراحة اللامحدودة بعد الموت.
حتى المستقبل بحدّ ذاته غير قابل للتحقيق بإرادة الإنسان وحده -حسب تصورات العقل العربي عن اللغة العربية- إذ يستلزم لأجل ذلك أن يَقبل اللهُ حدوثه، “ولا تَقولَنَّ لشيءٍ إنّي فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله”، “وما تشاؤون إلا أن يَشاء الله ربُّ العالمين”.
هكذا تصير الحياة حِملاً ثقيلاً لا طاقة للضمير الإنساني على احتماله، وهذا ما يجعل إرادة الحياة نفسها تافهة ووضيعة، إذ يُدفع الأفراد للعيش في أبعاد موازية، في عالم الاغتراب الإنساني الذي يَصعب تفسيره والتعبير عنه، هناك، في ما وراء الطبيعة.
حين تتعطّل إرادة الحياة في مجتمع يصير كل ما في عالمه غير جدير بالاحترام، ويصير كل ما هو موجود غير جدير بالأخذ على محمل الجدّ، فلا يثير الفضول فيه معرفةً أو فهماً، وهكذا تنعدم حاجته إلى التصوّرات الجديدة، والأشياء الجديدة، والكلمات الجديدة.
وحين تنعدم الحاجة إلى الكلمات والتصورات الجديدة يتضاءَل حجم العالم وينغلق الصندوق على من هم فيه، ويصير كل ما هو خارج عن حدوده مجهولاً مُثيراً للخوف والريبة، لأن الكلمات لا تستطيع وصفه، ولأن العين لا تستطيع أن تراه.
وفي مجتمع كهذا لا يربطه بالعالم إلا لغة ميتافيزيقية مغامِرة لا يستطيع العقل أن يكون حصيناً، لهذا يظلّ عُرضة لكل أشكال الخداع والغش والتلاعب والتضليل.
وبالنتيجة تنعدم قدرة أبنائه على التواصل بشكل إيجابي مع بعضهم، وتخيّم على حاضرهم أجواء انعدام التفاهم والثقة، وتزداد فرص استخدام العنف، اللغة التي يُحسن الجميع فهمها واستغلالها.
مجتمعات كهذه هي أكثر عرضة أن ينسحب أفرادها من الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يعيشون فيه، والثمن الذي يدفعونه لقاء عدم التدخّل في الشأن العام هو حيازة الشر للسلطة، والتضحية بمصيرهم ومصير أبنائهم.
مجتمعات من هذا النوع أيضاً يُشكلُ فيها وعيُ أولئك المنغلقين على أنفسهم الصوتَ الذي يقلب كفة الموازين في المسائل كلها، إنهم أكثرية الشعب، إنهم أولئك الذين يُشكّل صمتهم صمت العقل في الدولة، إنهم أولئك الذين يَسهل شحنهم وتعبئتهم دون الحاجة للكثير.
في المقابل يظل أولئك الذين يرغبون بمناقشة مسائل الحُكم والنظام أقلّية، يُعاديها من هم في أعلى السلطة، ولا يفهمها ولا يكترث بها المنغلقون في الأسفل، فتضيع الحقوق بضياع المطالبين بها وضياع معنى الكلمات الدالة عليها، فيسير الراعي بالراقصين على مزماره إلى حيث يريد دون معارضة أو شك.
لا عجب بعد هذا أن يكون معنى “الشر” في منطقتنا يكمن في “الشك” و”المعارضة” و “الاختلاف”؛ ولا عجب أن يقتصر معنى “العلمانية” على “الديكتاتورية” تارةً و”الإلحاد” تارة أخرى؛ ولا عجب أن يقتصر معنى “الديموقراطية” على مبنى البرلمان.
كذلك الأمر في حصر “الدين” بـ “الإسلام”، وربط “القصاص” بـ “الحياة”، والإشارة بـ”الحرية” إلى “التفلّت” من عباءة “القيم”، والربط بين “الوطن” و”القائد”، و”الوطنية” بالحب غير المشروط لهذا الوطن/القائد، و”الخير” بما هو متعارف عليه، وأمثلة أخرى لا نستطيع حصرها.
هذا التمييع للمعاني يشكّل واقع العقل والتفكير العربي، ويشكّل أساس ذاكرته ومعرفته.
كيف يستطيع العقل أن يعيش في حاضر لا تصفه اللغة؟
كيف لِلُغة تُفسّر الواقع بطريقة غير واقعية أن تُميز بين ما هو واقعي وما هو غير واقعي؟
كيف يستطيع العيش في الحاضر مَن هو غير حاضر لغوياً وإدراكياً فيه؟
ليست الحضارة حِكراً على جنس أو عرق أو لون، لكنها حِكر على معرفة دون أخرى.
الحل؟!
لا تزال المجتمعات العربية تعيش سنّ الطفولة من حيث الذاكرة والمخزون اللغوي والصُوري والدلالي، إنها مقولَبة داخل مجموعة من الألفاظ والخطابات والقصص والمرويات الملفّقة والغابرة والاجتراريّة وغير النافعة عن آلهة وقادة وأبطال خارقين وعادات وتقاليد يحرم المساس بها. كيف نستطيع الخروج به إلى بر أكثر واقعية وأمناً؟
يحتاج بناء الحضارة دولة المواطنة، ولا يمكن أن تتحقق دولة المواطنة دون ثقة الناس ببعضهم، ولا تتحقق الثقة دون التواصل، ولا يتحقق التواصل دون اللغة.
لا يمكن بناء الحضارة دون تعزيز دور الأفراد وإشراكهم جميعاً وبشكل عادل ومساوٍ وكريم في عملية بناء الدولة، ولا يمكن للحضارة أن تستمر دون الديموقراطية وتداول السلطة، ولا يمكن بناء الحضارة دون فصل نهائي وحاسم بين التشريع الديني وممارسة السياسة، ولا يمكن ذلك دون التعويل على الإنسان والعقل الإنساني.
تقع المسؤولية على عاتق اللغة كي تدفع باتجاه تجاوز الحاضر المأساوي إلى ما فيه خير الناس، حرّيتُهم، وكرامتهم، والعدالة بينهم، والمساواة في الحق والواجب والخبز والبحث عن السعادة.
اللغة هي المطالَبة بأن تنزع القداسة عن المقدّس لإعادة نقده والتفكير فيه، واللغة هي المُطالبة بأن توضّح الفرق بين المصلحة والضرر، وبين العقل واللاعقل، بين المصلحة والضرر، بين الحياة والموت.
اللغة هي المطالبة بأن تَفْصل بين معنى الاختلاف ومعنى العداوة، وهي المطالَبَة بمدّ جسور التفاهم والاتفاق على تلك الضرورة التي لا حياد عنها، ضرورة أن نبحث عن مخرج، وأن نختلف دون أن نلجأ إلى العنف.
لا تحتاج المنطقة العربية أكثر من إرادة الحياة للجميع، ولبلوغ هذا القصد تحتاج إلى دلالات خاصة بالحياة وحبّها واحترامها، تحتاج إلى أسطورة جديدة غير أساطير الدين والعائلة المالكة والمستبد الرحيم، تحتاج إلى كذبة أقل ضرراً من الكذب الذي تعيش فيه.
لكن، كيف لذلك أن يتحقق باللامبالاة؟ الشعر العربي يكره الحياة وساعتها، والأدب العربي يسعى وكأنما عن قصد إلى تخدير الناس واستغفالهم بالابتعاد عن الخوض في قضايا السياسة، والصحافة والتلفزيون والراديو والإنترنت مملوكة للحاكم وجماعته الذين يريدون احتكار الحقيقة.
هيهات أن يلاحظ العقل العربي مأساة واقعهِ دون استقلال اللغة والصورة!
خاتمة
لأن الإنسان عدو ما يَجهل، نحتاج بالتالي إلى التعريف.
ولأن اللغة غير مفهومة نحتاج إلى ما هو أكثر أصالة: الصورة، صورة الإنسان الذي يستطيع، نحتاج تصوّراً عن شكل للحياة الكريمة التي لا تتضمّن إقصاءاً لأحد. وإلا، يظل عسر التواصل الإيجابي يخيّم على العلاقة بين الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة.
يقول دوستويفسكي: الذكاء لن ينقذ العالم، الجمال سينقذ العالم.
إقرأوا أيضاً: