إلى جولان حاجي
لأنّ الجميع غادر، يدُفْنَ العجائز في مقبرة الكلدان وحيدين تماماً، من دون شخصٍ واحدٍ من ذويهم. يدفنون في أرضهم وكأنهم في منفى.

حق عدم العودة
القاسم المشترك الأكبر بين أهل الجغرافيا السورية المقيمين خارجها، هو كابوس ليلي عام. على رغم اختلاف الكابوس بالتفاصيل بين حلم وأخرى، إلا أنّه يمتلك ميزة متشابهة تشكّل أساس الهوية الوطنية السورية، وهي: الرعب من العودة.
لكابوسي سيناريوات مختلفة. أرى نفسي في زيارة إلى البلد، وأتعرَّض للاعتقال بالطريقة الخفيفة السلسة ذاتها التي اعتقِلْتُ فيها في كليّة الطب البشري في جامعة دمشق، حيث سُحِبت من بين الطلاب، كما تقصى قطعة مغناطيس معدنية بين مجموعة أخشاب. وعلى رغم تواضع فترة اعتقالي في مدّتها الزمنية، مقارنة بمعدّل الاعتقال السوري الوسطي، إلا أنّها تركت في ذاكرتي مشاهد مُزلزِلة للوجدان البشري.
في سيناريو آخر، أرى نفسي عدت إلى سوريا، وضيّعت كلّ أوراقي الثبوتيّة الألمانيّة، ولا أستطيع العودة إلى برلين مجدداً كلاجئ. كوابيس الآخرين أن يصبحوا لاجئين، وكوابيسنا هي الخوف من فقدان صفة اللجوء، والعودة إلى مكان الأصل. سوريا، بلد احتمال التشوّه الجسدي الدائم، والضرب كيفما كان على الوجه، وغياب الرحمة الإنسانيّة، بلدٌ تطالب بحقِّ عدم العودة إليه.
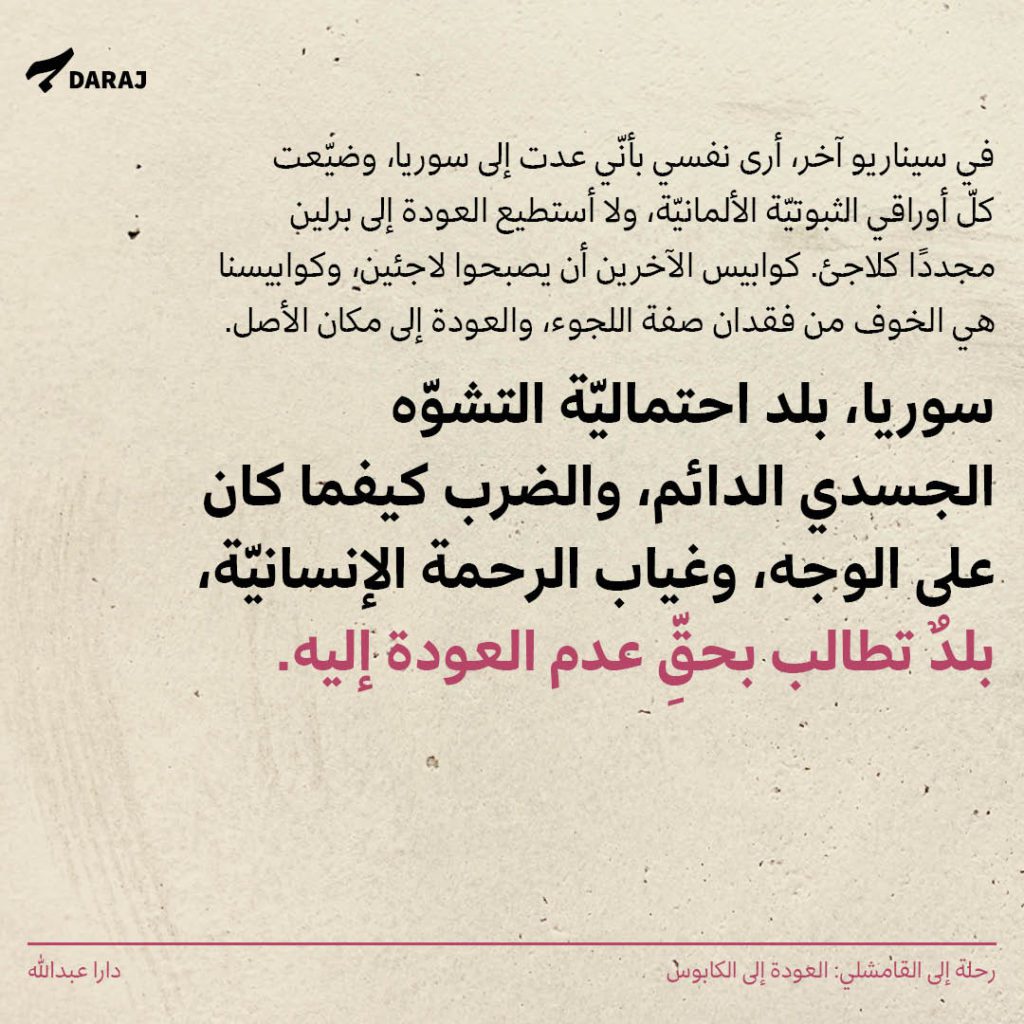
العصب الناصف
لم أندمج ثانية مع دراستي في كلية الطب البشري، ودخلتها فقط بسبب عطش الأهل لسماع كلمة “دكتور”، والضغط الاجتماعي على مراهق أنهى التعليم الثانوي في الـ17 من عمره. أثارني تاريخ الجثث بدلاً من تشريحها، ولم أطبِّع يوماً مع قسوة التجارب، ولا أنسى الأرنب الذي أخرجَ صوتاً من أعماقه وهو يرفض مصير التجربة في المختبر. عند قراءة المحاضرات، كنتُ أستمتع بالجمل الشعرية في الكتب الطبيّة، بدلاً من المعلومات الدقيقة حول آليات اشتغال الجسد البشري. كنتُ أجمع جملاً مثل: “مسافة دخول الرصاصة ضمن المادة الحية هي عمق الجرح” أو “فائض قوّة جهاز المناعة لن يؤدّي إلا لهجوم الذات على الذات” أو “العين لا ترى الأشياء، الأشياء ترى العين”. السنة الثالثة تجاوزتها فعلياً بالغشّ المحض. كنا “عصابة” نوزّع المقرر المطلوب بيننا، ثم نتفق على شيفرات جسدية لتبادل الأجوبة الصحيحة. الطريقة الأفضل كانت تحريك الأقدام من تحت الطاولة. القدم اليمنى إلى الأمام تعني الإجابة “أ” وإلى الخلف الإجابة “ب”، وهكذا. بعد عشر دقائق من إعطاء أسئلة الاختيار المتعدد، كانت الأقدام تحت الطاولات تبدو وكأنّها رقصة تانغو مُراوحةً في المكان ذاته بين أفراد “العصابة” التي تتواصل بشكل دقيق عبر لغة الأقدام. بعد كل 20 سؤالاً، يتمّ افتعال حركة نتفق عليها، إما سعلةٌ ذات صوت مسموع، أو سؤال عن الوقت، أو إسقاط مُتعمّد للقلم. كان تخرّجي من كلية الطب سيكون أشبه بشهادات الدكتوراه التي نالها أولاد القذافي، وكنت أسخر من نفسي بأنّ كلية الطب وفَّرت عليه جهد تمرين عضلة ربلة الساق في الجيم. في الفصل الثاني من السنة الأولى، أيقظني الأستاذ المشرف على تدريس مادة “تشريح الأطراف” من سُبَاتي في آخر مقعد، وطلب منّي فجأة أن أقف أمام الجثّة الموجودة في المختبر. أوقفني أمام ذراعٍ مقطوعة، وسألني عن مكان العصب الناصف، وهو أشهر عصب في الجسم، وعدم معرفته دليل على جهلٍ هو أقرب إلى الأميّة الطبيّة. وقفتُ أمام الجثّة كجثّة، وسألته عن الفرق بين لون العصب ولون الشريان، فقال إنّ الفرق يجب أن يكون واضحاً، كالفرق بين المريض والطبيب.
إقرأوا أيضاً:
الطابع المزدوج
مذ أتذكّر نفسي حتى أشعر أنني اثنين، إذْ لشخصيتي دوماً طابع مزدوج ومَنْبعَان منفصلان. في سوريا، أنا ابن لغتين: كردية تُنقَل بالسرّ عبر الأسرة، وعربية مفروضة بالقسر من الدولة. في ألمانيا، أنا ابن تجربتين: سورية أحرِق فيها البلد لشخصٍ واحدٍ، ويطلب من الفتيات الصغار ضبّ أرجلهنّ باستمرار تمريناً على تغطية عضو الشرف، وألمانية (برلينيّة بالأحرى) تُرَفعُ فيها أعلام التعدد الجنسي في شهر الـفخر Pride أكثر من الأعلام الكرديّة في عيد النيروز. الطابع المزدوج والانتماء المَثْنوي بشكل مشيمي إلى تجربتين مختلفتين جذريّاً يغذِّي النفس، ويوضّح أكثر فكرة هيغل بأنّ العلاقة بين الذهن والمادة، بين العقلي والفيزيائي، بين الروح (Geist) والجسد، بين الفكرة داخل الرأس ونوع المشاعر المُعبَّر عنها، هذه العلاقة، ليست سببية (Kausal) أو خطيّة، والكلام هنا يتطلّب بعض التوضيح.
يبكي الإنسان عند الفرح أو الغضب أو الألم أو أي شيء آخر، ورؤيةُ الدموع منهمرة على الوجه، هو أمر غير كافٍ أبداً لتحديد المحتوى الموجود في الذهن. البكاء لا يشير بشكل حاسم إلى شيء واحد. أستاذ الرقص والتمثيل، دوريس هومفري قبضَ على هذه الإشكالية في كتابه “فن صناعة الرقصات”، إذْ يقول: “خلال عملي في الإعلانات، كنت أعلِّم الشباب كيف يمارسون الحب والفتيات كيف يكنّ مفترسات أو مغويات أو مغازلات. وخلال دروس الرقص، كنت أعلِّم الطلاب كيف يظهرون مشاعر القلق أو الخوف، وغيرها من الحالات العاطفية. لا شكّ في أن كلّ هؤلاء الشباب والشابات كانوا اختبروا هذا المشاعر، ولكن الحركات التي تمثّلها والتقنيات الجسديّة التي تعيد إحياءها، بدت غريبة تماماً بالنسبة إليهم. الإيماءات الوجهية وأنماط السلوك الحركية تُؤسَّس بين البشر من خلال العادة التاريخيّة والاستخدام المتكرر. الكثير من المشاعر يمكن التعبير عنها من خلال طرق متعددة ومتنوّعة لدرجة يصعب فيها تحديد نمط معين مشترك جوهري لها… الأمل ليس له شكل”.
محتوى الذهن وما يدور في نفس الإنسان، يرتبط حصراً من خلال العادة والتكرار مع أنماط تعبير خارجية معيّنة. الإنسان يمكن أن يبتسم عند الإهانة، ويظهر إهمالاً متعمداً تجاه شخصٍ يرغبه بشده، ويصمت عند الحب. طقطقة الأصابع ربما تكون دليلاً على الاستغراق في التفكير أو علامة من علامات التوتر النفسي أو ببساطة: الملل. الابتسامة، أبسط تعبير وجهي، في بعض المجتمعات تعبّر عن الود، وفي سياقات أخرى تشير إلى الإحراج، وفي سياقٍ ثالث، يمكن أن تكون الابتسامة تعبيراً عن عدوان شديدٍ مُقبل إذا لم يخفَّض التوتر.

عملية ربط محتوى معيّن في الذهن مع نمط تعبير معين في التجسيد، هو أمرٌ يتبع فقط للعادة والتكرار. لما دخلت الأفلام اليابانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، كان الجمهور الأميركي يجد صعوبة بالغة في تحديد المشاعر التي كان يظهرها الممثّلون اليابانيون. لم يكن واضحاً إذا ما كانت التعابير الوجهيّة للممثّلين تنقلُ الغضب أو التوتر أو الحب، كما أنّ الكوميديا اليابانيّة لم تجد مكاناً لها في الثقافة الأميركيّة حتّى الآن. دوماً، طرائقنا في التعبير، كنوعيّة نكاتنا ورقصاتنا الجماعيّة وذائقتنا في الطعام، تبدو لنا جوهريّة وثابتة وأصليّة. في حين أن طرائق الآخرين في التعبير، ونوعيّة نكاتهم، وكل أساليب تجسيدهم مشاعرهم، تبدو لنا طارئة وعابرة ومكتسبة.
أصحاب الطابع المزدوج يمتلكون إمكانية الترفّع والسموّ، وإدراك أنّ الرابط بين المحتوى في الذهن ونمط التعبير الجسدي (الروح والمادة) ملحوم فقط من طريق العادة ومصبوب بالتكرار. الانتماء المثنوي يعطيكِ دلائل حسيّة وملموسة عن نكاتٍ كرديّة تفقد طاقتها الكوميديّة إذا قيلت بالعربيّة، ونكات عربيّة من المستحيل أن تنقل إلى الكرديّة. ويبدو أوضح مدى نسبية ولا دقة الأحكام التي يطلقها البشر مثلاً حول لغات بعضهم. كأن يقول عربي (لا يعرف الكردية طبعاً) إنّ اللغة الكرديّة فيها “قسوة وخشونة”، أو يقول كرديّ إنّ صوت اللغة الصينيّة يشبه “رنة الصحن على الإسفلت”، أو يقول صيني عن اللغة الإيطاليّة بأنها “شاعرية ومستعجلة”.
مالكو الطابع المزدوج يدركون أسرع أنّ العلاقة بين الذهن والجسد ليست سببيّة ولا مطلقة ولا كونيّة ولا ثابتة ولا فطريّة. أيُّ محتوى في الذهن يمكن أن يتجسّد بأي شكل تعبيري. والدليل الدامغ على حرية الذهن المطلقة وعدم خضوعه لأي شكل من أشكال السببية وقدرته على الانغلاق على نفسه وتحييد الجسد هو: ظاهرة الصمت. في الصمت الإنسان قادر على خلق أي محتوى داخل الذهن بدون إشهاره بأي شكل تعبيري. الصمت هو الحرية المطلقة للذهن مع صفر تجسيد.
أن تكون اثنين، هو أمر يشكل مناعة ضد العنصرية، وأي شكل من أشكال التقوقع الثقافي والأحكام المسبقة، ويزيد القدرة على تفهّم الآخرين وبناء قنوات الاتصال معهم.
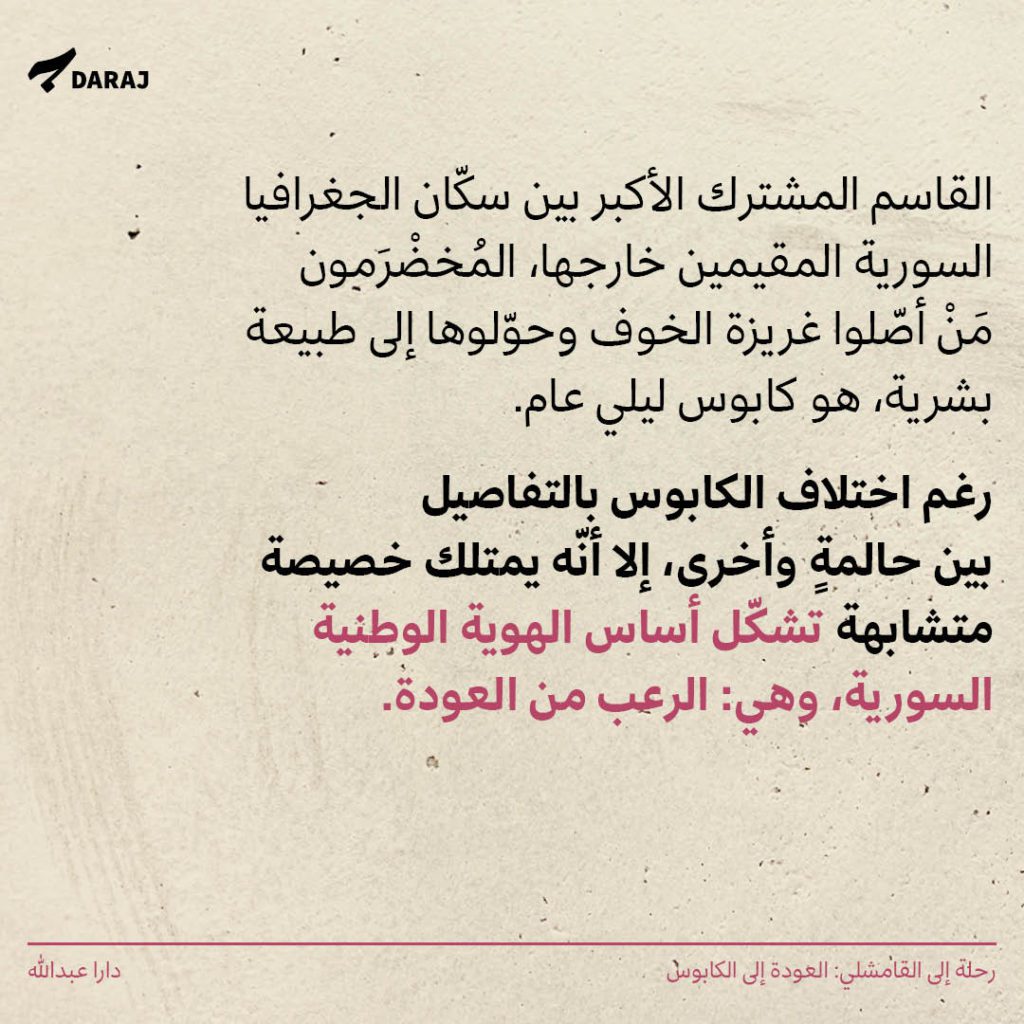
الحرية اللامرئيّة
أشير بشكل مباشر إلى تجربتي الشخصيّة أثناء النقاشات مع بعض شرائح اليسار الثقافي الشاب في برلين، وتحديداً التيار العدمي المعادي للسياسة، والمعارض لطوطم غامض ومطّاطي اسمه “السيستم” System. الاعتقاد هو أنّ الأنظمة متشابهة، وأي “سيستم” هو توأم أي “سيستم”. ومنه، فإنّ النظام الإيراني هو مشابه للنظام الألماني، وميركل هي مثل الخميني، وأميركا هي مثل الصين. أتدخّل فوراً هنا، وألوِّح بتجربتي الشخصيّة. لم يجرّب أحد من جماعة “ضد السيستم” أن يقبّل قدم رجل مخابرات في السجن، كي يُسمَح لمراهق مُزرَقّ مصاب بالربو أن يتنفَّس. لم يقف أحدٌ منكم 15 ساعة متواصلة على قدمه كي ينال 4 ساعات من الجلوس، لأنّ مساحة المكان لا تسمح بجلوس الجميع. لا تسألهم أمهاتهم عن صور من زوايا مختلفة كي لا تُنْسَى الملامح. منذ نحو 30 سنة، لم يتعرّض أحد للإخفاء القسري في ألمانيا في أمكنة لا يدخلها الضوء، وأوّل شيء يسأله الخارج منها هو الوقت.
أرفض أي تشابه مزوّر للحقائق ومُسوٍِّ للتجارب حفاظاً على الطابع المزدوج لتجربتي. كبرتُ في ظلّ نظام دكتاتوري، وأتذوق بكل متعة مستوى الحريات الموجودة هنا في برلين. مع التذكير بضرورة بعدي من التصورات بأنّ أي نموذج هو “نهاية للتاريخ”. التاريخ لا يعمل عند أي أحد، ولا يتوقّف عند أي نموذج، والتاريخ لا ينتهي أصلاً. الفيلسوف الليبرالي الأميركي، جون رولز، أشار في كتابه “نظرية في العدالة” إلى أنّ أولوية الحرية السياسية في الغرب، سيحوّل قيمة الحريّة عند الأجيال المقبلة التي لم تختبر النظام الشمولي، أو التي لم تشهد التحوُّل من النظام الشمولي إلى النظام الديمقراطي، إلى قيمة غير مُفكّر بها، وكأنّها جزء من طبيعة الأشياء، وليست عقداً سياسياً قابلاً للاختفاء. الحريات الأساسيّة المترسّخة فعلاً في مكان مثل برلين ترسبت في القاع الاجتماعي وتغلغلت في الحياة اليومية، وصارت غير مرئيّة لدرجة عدم الانتباه لوجودها. لن يرى هذه الحرية ويستمتع بها أفضل من أشخاص مزدوجي التجربة خرجوا من جحيمٍ تُوشَم فيه الأجساد بصور باسل الأسد وحصانه لحظة القفز.
إقرأوا أيضاً:
الكاتب الواحد
في كلية الفلسفة في جامعة هومبولدت حيث أدرس، أبقى حريصاً على عدم تلقّي أي رعاية خاصّة أو تمييز إيجابي. على رغم لكنتي الألمانية الواضحة، أخفي هويتي السورية، حتّى أقطع الطريق أمام أي تعامل استثنائي، وأظهر علناً عدم راحتي من أي طبطبة على الكتف. أرفضُ اختصاري كبروزٍ لونيّ من خلال الاندراج ضمن فئة مزعجة وتسمية معيبة اسمها “الملونون” أو People of Color، ولن أقبل تحويلي إلى أعرجٍ يُوضَع بالقرب من خط النهاية عمداً، كي أنال التصفيق الرافع للمعنويات، كطفلٍ انتقل للتوّ من طور الحبو وصار قادراً على الوقوف. أريد ذوباناً كاملاً في الجميع، وألا يشار إليّ بأي إصبع، وكأنّني شيء موجود هناك لا يحتاج لأي تبرير. لست منتجاً حتمياً لمكان ولادتي، ولون جلدي ليس لون ذهني، وجسدي فقط قطعة بيولوجية، لا تقول شيئاً عن ميول النفس القارّة داخلها. أخيراً، فهمت قلقي وعدم راحتي أكثر عن الأمسيات الأدبية والفعاليات الثقافية التي لها علاقة في سوريا في ألمانيا، خصوصاً عن الكتابة في المنفى وأدب اللاجئين. شعرت بالزيف من قراءة نصوص تُقتَل حساسيتها بالترجمة. ولأنّ في الترجمة نوعاً من التأليف وإعادة كتابةٍ للنصّ الأصلي، فإنّ النصوص السوريّة المترجمة إلى الألمانيّة تتشابه في أسلوبها، لأنّ المترجمين من العربية إلى الألمانية قلّة ويُعدّون فعلاً على الأصابع. تبدو النصوص السورية المُترجمة وكأنّها قد كُتِبَت من شخص واحد.

اتفاقية جنيف
خرجت من سوريا في آذار/ مارس 2013، وبعملية حسابية بسيطة فإنني أمضيت نحو 30 في المئة من عمري في ألمانيا. ذاكرتي حول سوريا فقدت طابعها الاتّصالي، لكنها ارتفعت حدّة في استحضار التفاصيل. فجأةً، أتذكّر شارعاً في القامشلي، أين ينتهي الزفت ويبدأ التراب، والمداخل الثلاث إلى الملعب البلدي، والزخارف المرتجلة على أبواب كلّ جار، وكلّ عملية تذكّر تترافق مع انقباض داخلي. ذاكرة البشر ليست كذاكرة الكمبيوتر، تمكن “فرمتتها” وحذف البيانات داخلها، لإدخال معلومات وتجارب جديدة. الذاكرة التي تتعرّض لمحاولات إفراغ مقصودة واستئصال تجارب قديمة عن طريق حشو محتوى جديد تصبح جرحاً غائراً داخل النفس، يعبّر عن نفسه بأشكال سلوكية مختلفة. التشفّي من الماضي عبر المبالغة في ادعاءات الاندماج، وإشهار السعادة والنجاح في الأمكنة الجديدة، هي تشويشٌ على رضّ عميق. في نصّها التاريخي “نحن اللاجئون” تقول حنة آرندت إنّ اليهود زايدوا أحياناً على بعضهم البعض في الشعور بالمواطنة والالتزام بالقوانين في الأمكنة الجديدة التي هربوا إليها أثناء الحرب العالمية الثانية. ترديد عبارات مثل “ما عندي أصدقاء سوريين”، ونفورنا المبدئي من بعضنا، وقلّة إحساسنا بالأمان حين نكتشف فجأة أن سورياً في السهرة، وكأنّنا أقطابٌ مغناطيسيّة متنافرة. تهزّني عبارة أمّي “تعال قبل أن نموت”. الطريقة الوحيدة لدخول الكابوس، سوريا، هو معبر سيمالكا على نهر دجلة الذي يربط بين إقليم كردستان العراق وشمال شرقي سوريا. بيدٍ مرتجفة وقلبٍ يخفق كمحرّك سيارة، حجزت تذكرة إلى أربيل في 27 تموّز/ يوليو. سأصل إلى أربيل في 28 تمّوز، وأكون في قامشلو في يوم 29، وهو، للمفارقة البورخيسيّة، اليوم الذي وقّعَت فيه اتفاقيّة جنيف للاجئين عام 1951.
خانة القومية
تستغرق الرحلة من أربيل إلى نهر دجلة نحو أربع ساعات. نهر دجلة هو خط حدودي يفصل بين إقليم كردستان العراق ومنطقة الجزيرة السورية. ضفّتا النهر بالغتا التسييس، في الطرف العراقي يهيمن البشمركة وفي الطرق السوري يسيطر الـ”هفال”. سائق الأجرة كان كردياً سورياً وتحدّث عن معاناته من العنصرية اليومية والقوانين التعسفية لإدارة الإقليم بحقّ اللاجئين السوريين. طلب السائق إيقاف السيارة لأنّه يريد الصلاة، ومدّد سجادته على الأرض. يظهر خطّ الأفق فقط في حالتين: الصحراء والبحر. عند الأفق ولشدّة الحرارة تترقرق الأرض الصلبة وكأنها خُلطَت بسائل. وتبدو التربة للعين عند التحامها بقطر الشمس وكأنها فقدت تماسكها وتخلخلت صلابتها. أسمعُ صوت السائق يتلو القرآن بصوتٍ عال، وتبدو عربيته ركيكة، هذه العناية في اللفظ والبطء في القراءة تدلّ على أنها ترديد لكلام غير مفهوم. مدد إصبعه وجعل صوته مسموعاً لحظة الشهادة. أنهى الصلاة وضبّ السجادة وانطلقنا إلى معبر سيمالكا.
سيمالكا هو الاسم المعروف لنقطة الحدود غير النظاميّة والتي قرّرت القوى الدوليّة إبقاءها مفتوحة لـ “أسباب إنسانيّة”. المعبر يُفتَح أيام السبت والإثنين والأربعاء، ومعروف أنّ التعامل مع الوافدين في الجهة الكرديّة- العراقية مروّع، وثمّة تقصُّد في جعل الإجراءات البيروقراطيّة مهينة وشاقة وغير واضحة. سائق الأجرة فتح المجال لتلقيني نصيحة بعد اعتذار لبقٍ من نوع النصيحة نفسها، إذْ أخبرني بضرورة أن أخفي الوشم على ساعدي، وأزيل القرط من على أذني، لأنّ شاباً آتياً من ألمانيا أقلّه قبل أسابيع من المطار إلى المعبر سمع تعليقات مهينة بسبب مظهره. سحرني مشهد الوشم على يدي تحت الشمس اللاهبة. نظرت إلى مرآة السيارة، وأزلت الحلق ببطء، ومن بعيد بدأت انعطافة نهر دجلة كخطّاف منجل تلمَع، وكأنها قطرة زرقاء في بحرٍ من اللون الأصفر.
تعرّفت في المعبر إلى مجموعات مختلفة من الناس. لاجئون من مخيم “دوميز” في إقليم كردستان العراق يزورون أهلهم، ولاجئون من دول الخليج وأوروبا، وخصوصاً ألمانيا والسويد، وصحافيّون أجانب حريصون على عدم مخالطة أحد والتقوقع معاً، وعاملون في المنظمات الدولية. التقيتُ بشاب من منبج يقضي ستة شهور من سنته في منبج، والنصف الآخر من السنة في السويد، وكان الأكثر خبرة بالإجراءات المرورية. شرح لي بدقّة الشبابيك التي يجب أن أتنقّل بينها عند ختم أوراق الدخول في طرف “الكاكا”. في الطرف الكردي العراقي أعطونا استمارة تجب تعبئتها، وفيها بند مكتوب فيها بشكل مباشر “القومية”، والمتوقَّع هنا احتمالان فقط: عربي أو كردي. غمز لي الشاب من منبج وهو يشير إلى خانة القوميّة، فقلت له مازحاً: “يالله حس حالك كرديّ شوي بزمن البعث”، وضحكنا بصوتٍ عال.
عبرنا نهر دجلة في حافلات تعلو منها موسيقى صاخبة، ودخلت إلى الأراضي السوريّة حيث تسيطر “الإدارة الذاتية الديموقراطية”. النبرة تغيَّرت فوراً، والحضور الكثيف للنساء واضح مقارنة مع غيابه المطلق في طرف “الكاكا”، والإجراءات البيروقراطيّة كانت أسرع بما لا يُقاس. أقلّ من نصف ساعة حتّى حضنت أخي الذي جاء لاستقبالي بسيارة “فان” مكيّفة، والمشوار الآن هو من معبر سيمالكا في الطرف السوري إلى قامشلو، والذي يجب أن يأخذ تقريباً نحو 3 ساعات. أوّل حاجز عسكري تمعّن بهويتي أعادها إليّ فوراً. في الحاجز العسكري الثاني، طلب الشاب، والذي لم تكن لحيته قد بزغت في ذقنه بعد، أن نركن السيارة إلى اليمين لأنّه سيقوم بـ “تشييك” اسمي. ما أن سمعت كلمة “تشييك” حتّى اشتعل كلّ جسمي بتيار من الرعب الأسود. حاجز عسكري في صحراء قاحلة مع شبّان مراهقين مدجّجين بالأسلحة تحت شمس عموديّة، هذا تجسيد كامل للكابوس السوري المشترك بشحمه ولحمه. هدّيت رأسي على كرسي السيارة، وتذكّرت أنّني لم أنم منذ 36 ساعة، وإذا نمت الآن فإنّي على الأقل محميّ من رؤية الكابوس المشترك لأنّه أمامي. راقبت أنني غير قادر على التحكُّم برجفة يديّ، كمياه تتدفق من شقّ باب. بعد خمس دقائق أعاد الهويّة ورحّب بي، وانطلقنا إلى قامشلو.
وصلت إلى البيت فرأيت أمّي تبكي على الشرفة، وأبي يتجنّب المشهد مُختبئاً في البيت. كبرتُ في عائلة لا يُحبَّذ الضعف فيها، ونادراً ما يتمّ الحديث عن المشاعر. نبقى صامتين ببساطة، ونبلع ريقنا عند الألم، كمن يتجرَّع كرة نار ويطفئها في معدته. نتجنَّب المكاشفة، وكأنّ التصالح مع الضعف عري للجسد، والهشاشةُ عار والمشاعر علامة انهيار. قبّلت يدي أمي وأبي ودخلت البيت الذي لم أدخله منذ عقدٍ من الزمن. تغدّيت برغلاً ولحماً مطبوخاً بعناية، وتقاطرت بعدها وفود العائلة للترحيب. في الليل، وأنا محاط بضجةٍ، تكوَّرت تحت المكيف الصحراوي، فغطونيببطانية خفيفة فوراً. بدأت الضجة تخفت تدريجاً، ولا أدري إن كنت أنا أستغرق في النوم فيقومُ وعي بإزالة الأصوات لشدّة التعب، أم أنَّ الضيوف يرحلون فعلاً. استغرقت في النوم ضمن ضجيجٍ من نوع خاص: محيط كامل يتكلّم بالكردية حولي.
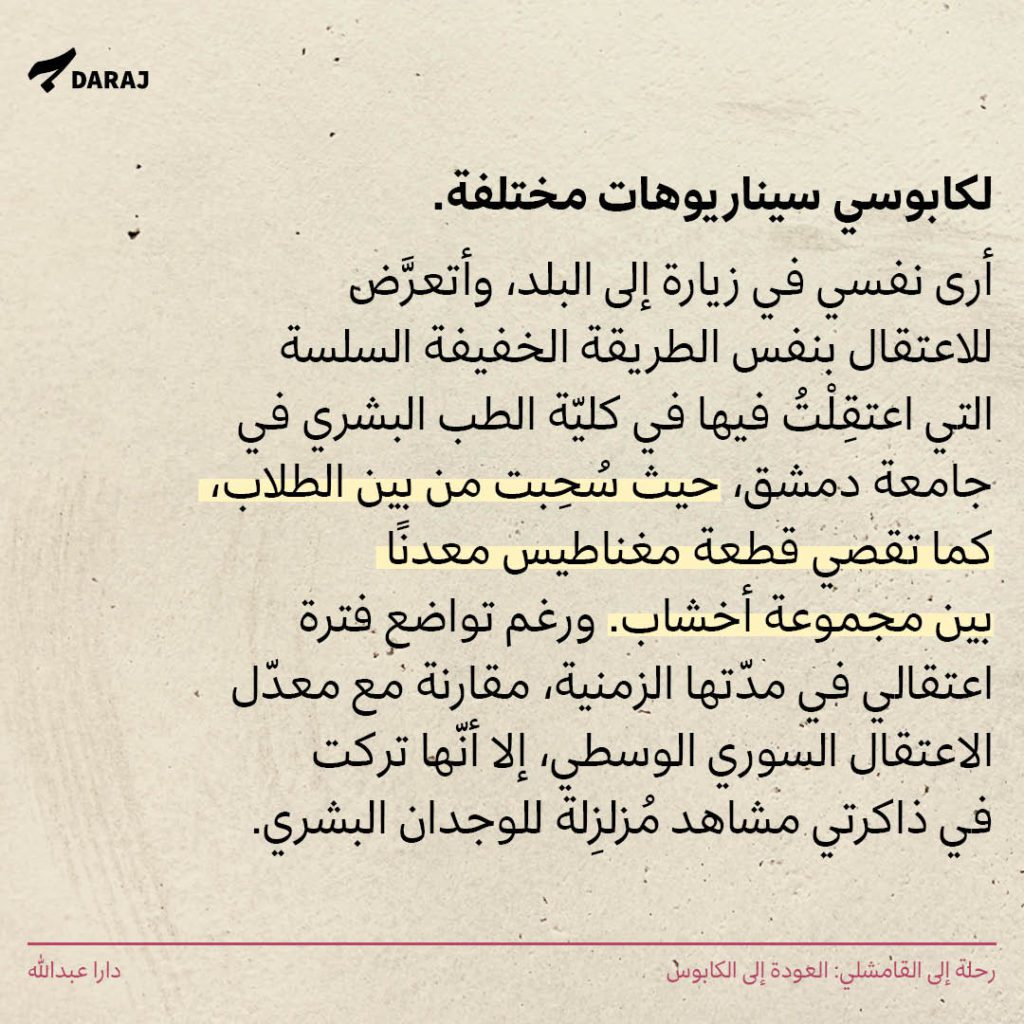
نفي الحلم
لحظة خروجي إلى الشارع، بدا لي وكأنّ الأمر مرتّب له تماماً، والبيئة المحيطة اقتباسٌ من عمل تخيّلي. القامشلي عادة بالنسبة إلي هي مادة للأحلام. التضاريس المُقتبسة في الأحلام إما تكون مشوّهة ومشوشة أو دقيقة وحقيقية. البنية التقسيميّة الأساسية للمدينة لم تتغيّر. لا مشاريع إعمار جماعية أو سياسات بناء على المستوى العام، بل فوضى عمرانيّة توسُّعية نحو الأعلى من دون أي تنسيق مشترك على المستوى الجمالي. الشوارع كما هي، شارع السياحي وشارع القوتلي وشارع المصارف وشارع الخليج. زرت بيت عمّي وعمّتي في حيّ العنتريّة، المنطقة التي لم أدخلها قبل 15 عاماً، وعرفت البيتَيْن دون أي مساعدة. ولأنّ وجودي مؤقّت وعابر، له بداية ونهاية، تماماً كالحلم، كانت لحظات التطابق بين الأماكن التي ترد عادة في الأحلام ومروري بها بعد عقدٍ من زمن، تثير دفقة من الكهرباء وكأنّ الأحاسيس الخمسة أصيبت بعطلٍ وصارت غير موثوقة. يتبعُ اندلاع هذا البرق داخل الذهن، تركيزٌ للفصل بين حالتي الحلم والواقع. في أوّل عشر دقائق وأنا أمشي على شارع السياحي، كنت أراقب خطواتي وهي تدعس الأرض وكأنّ إنساناً قد هبط على سطح القمر، كنت فقط أنفي باستمرار بأني في حلم بتفعيل يقظتي وصَفْع بديهتي.
المال الكمي
اليورو الواحد هو 3800 ليرة سورية. وتحويل 150 يورو يتطلّب عد 250 ورقة من فئة الـ2000 ليرة سورية. الـ500 ليرة هي القيمة النقدية الأصغر تقريباً، والأوراق النقدية من فئة 100 انقرضت، وإذا وجدت فستكون مهترئة ومتعفّنة وكأنّها سجّادة على باب خيمة عزاء قد دعِسَت بألف قدم. حول خصر كلّ شخص حقيبة صغيرة لحمل رزم المال. الكلّ يعدّ المال، والأصابع تحتاج بللاً من البصاق، لأنّ جفافها يعرقل عملية العد. لشراء خضرة الأسبوع أنتَ بحاجةٍ ربّما لعد 40 ألف ليرة. صديقٌ سخر بشكل لمّاح: “جيوبنا دائماً فارغة: إما لانعدام المال أو لكثرته العددية”. الكثرة هنا فيزيائية وكمية وليست قيمية أو معنوية. وكأنّ حضور المال يقلّ بارتفاع قيمته، ويزداد تواجده البصري بتدهورها. المئة يورو تجلب 380 ألف سوريا، والشعب كله “مليونير”. اليورو الواحد وهو يحرّر كلّ هذه القطع النقدية الحاملة لصور بشار، يشبه الرهينة الأجنبيّة وهي تحرّر عدداً هائلاً من الرهائن في أسر المنظمات الإرهابية. في سوق الصرافة في القامشلي ولصعوبة العدّ عند تحويل المبالغ الكبيرة، يصبح الوزن معياراً للقيمة. وزن المال بالكيلوغرام هو قيمته الحقيقية، إذْ ينقل المال مصفوفاً في رزم على عربات نقل البضائع. كان للـ500 ليرة القديمة في التسعينات وبداية الألفينات وزن بصري في ذاكرة كلّ سوري. حملت القطعة صورة زنوبيا، وكانت متناسبة بقلّة حضورها وأثرها الشرائي مع الطابع الصنمي وتقشُّف حضور حافظ الأسد. صورة بشار الأسد وقيمته السياسيّة لا يمكن فصلها عن قيمة الورقة النقدية السورية. التطابق دقيق بين الاستعارة الشعرية والحقيقة الاقتصادية. كثرة صور بشار على أوراق نقدية تقاس بالوزن، أسقطت عنه الثقل المعنوي والهيبة الرمزية. من يضع صوره على عملة تُقاس بالوزن، يجعله مجرّد كم واقعي في السياسات الدولية.
إقرأوا أيضاً:
حدود دوليّة
يشلّ الحرّ الحركة في المدينة لمدّة ساعتين في الظهر. أثناء وجودي في القامشلي، لم تنزل درجة الحرارة عن 41 درجة مئوية، وارتفعت في أيام متتالية إلى 44 درجة. يسمعُ صوت صراخ الأطفال من حرّ الليل من شرفات المباني المتلاصقة، والناس يتقلّبون في أسرّة صارت مستنقعات من العرق. في اليوم التالي، المدينة بشكل كامل مُصابة بالأرق. في شارع السياحي، ثمة مَبْنيَان معروفان لا يعانيان من انقطاع الكهرباء، مبنى الأمم المتحدة ومبنى منظّمة الصحة العالمية. مبنى الأمم المتحدة هو قلعة قرميدية لرجل أعمال كردي، كان معروفاً بعلاقاته الأمنية السابقة مع النظام. المبنى الأحمر الفاخر كان لغزاً لسكّان المدينة، واختلطت الحقائق حول ديكورات الجبصين داخله مع إشاعات الناس المُضخِّمة. المبنيان مُحصَّنان ومُدرّعان ومحاطان بصفوف من كاميرات المراقبة والأسلاك الشائكة وقطع الإسمنت المربعة، وكأنهما هناك وليسا هناك في الوقت نفسه. إحدى قنوات تواصل المبنيَيْن مع الناس هي حاويات القمامة، إذْ معروفٌ أنّ بعض الناس ينبشون في زبالة منظّمة الصحة العالمية بحثاً عن أيّ شيء يؤكل إسكاتاً لنداء الجوع. وأنا أمرّ بالقرب منهما، شعرتُ بأنّني أمام حدودٍ دوليّة.
سكين داخل الأذن
نوعيّة المازوت الذي يسُتخدَم في السيارات رديئة للغاية. على رغم قرب المنطقة من منابع النفط، إلا أنّها تستهلك أسوأ أنواعه. كلّ سيارة عند الإقلاع تبخُّ دخاناً أسودَ وكأنّه قيء مكبوت. السيارة التي تقف في الخلف، تُصاب بالعمى لثوانٍ حتى تنقشع غيمة الدخان الكثيفة. لغياب قوانين جمركيّة وكثرة الفساد ازداد عدد السيّارات في البلد بشكل فايروسي. كل سيّارة هي مفاعل تلوّث صغير يساهم في ازدياد سماكة طبقة الدخان المستقرّة فوق المدينة. أوّل ما خرجت إلى شرفة بيتنا لاحظت فوراً الرداء الرمادي الشفاف. وكأنّ المشهد قد تعدَّل أمامي من صورة بألوان طبيعية إلى صورةٍ ازدادت فيها شدّة الرمادي الغامق بشكل مقصود.
الكهرباء لا تأتي في القامشلي. خطّ النظام هو الأقوى شدة والأقلّ حضوراً، ويأتي كل يوم لمدّة ساعة. خط النظام هو الخط الوحيد القادر على إشعال المحركات التي تسحب المياه إلى الخزانات وغسالات الثياب وغلايات المياه. عندما تأتي كهرباء النظام تستنفر المدينة، وكأن النظام غزا، وتزداد حركة الأفراد في البيوت للقيام بالمهمات الضروريّة. على هذا الفعل أن يتحوّل إلى غريزة، وأيّ إهمال سيكلف البيت العطش أو التعفُّن لتوقّف دورات المياه. عند انقطاع كهرباء النظام تعمل المولّدات المحليّة التي تُقاس قوّتها بـ”الأمبيرات”. المولدة كافية للإنارة والتبريد وإشعال المكيف الصحراوي. بيتنا وضعه جيد نسبياً لأنّه يتقاطع مع المولدة التي تنير مبنى الأمم المتحدة. والمزحة لدينا فوراً جاهزة عند انقطاع كهرباء النظام: “اقلبوها من بشار على الأمم المتحدة”.
في القامشلي أكثر من 20 ألف مولدة. وللمولدة صوت مُتكسّر غير منتظم لا يمكن للدماغ التصالح معه. ضجّة السيارات أو صوت أمواج البحر تصبح خلفية للصمت، ولكن صوت المولدة لا يقبل المساومة. تعمل هذه المولدات على مدار الساعة لتسبح المدينة في ضجة مستمرة، وكأنها سكين مستقر في غشاء الطبل. بعض الجيران في بعض الأحياء قتلوا بعضهم حرفياً بسبب الشكوى والخلاف حول أصوات المولدات. من كلّ مولّدة تخرج حزمة من الأسلاك تتجه إلى عُقدٍ بين الأحياء، لتستقر بعدها في كلّ بيت. تخفّ كثافة الحزمة مع الابتعاد عن منبعها وهي تتوزع بين الأحياء والبيوت. السماء في القامشلي متروسة بأسلاك متداخلة من المستحيل تتبع تاريخ ومصير سلك واحدٍ فيها. في السوق حيث يزيد الاكتظاظ، تكدَّست أسلاك المولدات في بعض الأماكن، وصارت تشكّل ظلاً تحتها وكأنها سقف. صعدت إلى الطبقة الرابعة إلى مبنى في السوق ونظرت إلى الأسفل: طبقات متداخلة من الأسلاك تسبح في غمامة من الرماد الغامق وكأنها شرايين وأوردة في قطعة لحمٍ ميتة.
6814
في فترة إقامتي كنتُ أنام لوحدي في غرفة الصالون حيث التلفزيون، وتذكَّرت بأن النوم وحيداً في غرفة التلفزيون كان ممنوعاً في فترة المراهقة. لا أتذكّر بدقة، ولكنّ أحاسيسي الجنسيّة بزغت وأنا في الحادية عشرة من عمري. وبمجرّد العبور من الطفولة إلى المراهقة، من حياد الغريزة إلى الاصطفاف الجنسي، حتّى تبدأ معها مراقبة الأهل الحثيثة للحماية من وباء الجنس. الجنس تهديد للنقاء وخطر على المدرسة وإلهاء عن الإنتاج ومفتاح المصائب وعامل مُفسِدٌ يتطلّب الملاحقة والتقليم. في القامشلي، وفي بداية الألفينات كانت المجلات التركية تدخل المدينة عبر شبكات التهريب. تحتوي المجلات على صور عارضات الأزياء التركيّة بملابس السباحة وأحياناً عاريات الصدر، ومالك المجلة حاكم الجميع. الأسعار متفاوتة، تصفُّح المجلة في المدرسة هو بخمس ليرات، فيما أخذها إلى البيت ليوم واحد هو بعشرين ليرة. التلفزيون الأرضي كان يبث بعض القنوات التركية المحلية مثل Show Tv وATV وD وCine5، والأخيرة تسمّى بالتركية “سينابيش”. الـ”سينابيش” تعرض بورنو يومي الجمعة والسبت، ولكن متابعة القناة مهمّة شبه مستحيلة لأنّها تتطلب تسلّقاً خطيراً إلى سقف المنزل الخارجي لتدوير اللاقط الأرضي باتجاه الأراضي التركية. إذا لم تُمسَك من قبل الأهل، فإنّ البيوت الطينية المتلاصقة تجعلك أمام مرأى عيون أي جار سيمرّر المعلومة للأهل لاحقاً. أصلاً يتمّ تمييز اللاقط النافر المتجّه إلى تركيا بسهولة أمام جميع اللواقط الأخرى المشتركة في الاتجاه ذاته، كوضوحٍ شخصٍ قرر ألا يصفّ سجادته باتجاه القبلة في صلاة جماعية. تدبُّ الحياة فينا لما تحدث وفاة في عائلة صديق، إذْ أنّ سفر أهالي الفقيد إلى القرية لأيام العزاء الثلاثة، يقدّم لنا بيتاً خالياً ولاقطاً نوجّهه براحتنا إلى تركيا. يُدعى الأصدقاء من أجل “امتحان الرياضيات” لنشاهد أفلام الـ -16 على “السينابيش”. مع الكمبيوتر وأقراص الـCD حصل تغيّر جذري. صارت الأفلام الجنسية متاحة بين شبكات المراهقين وناسخات الأقراص الليزرية تسهّل نشرها بأسعار معقولة. عناوين الأفلام كانت مرتجلة، ولعلّ تشابها طفيفاً بين ممثلة أفلام بورنو والممثلة السورية نورمان أسعد أطلق اسمها على فيلم بورنو، شاهده على الأقل 30 في المئة من المراهقين السوريين، وتطلّب الأمر نفياً متكرراً من الممثلة نفسها.
ومع ازدياد المنافذ إلى عالم البورنو، يزداد توتّر الأهل وتستفحل أساليبهم في اقتحام الخصوصيّة. أكثر من مرّة، كان والدي يقوم بنوبات تفتيش على محفظة الأقراص الصلبة في المنزل، إذْ يختار بشكل عشوائي قرصاً مريباً من دون تسمية ليجربّه ويتأكّد من المحتوى. ولكن الرغبة الجنسية عند المراهق هي مثل همّة التعلّق بالحياة عند الغريق، خلاقة في التفكير وقابلة للتأقلم مع الرقابة وقادرة على الالتفاف، ولا شيء يوقفها. لم أكن أشتري أيّ فيلم معنون بعبارات مثل “سائق البريد” و”بائعة الحليب”، وكنت أحمّل الفيلم على الكمبيوتر، وأخفيه في مجلّدات محفوظة في مجلدات محفوظة بدورها في مجلدات، حتّى إن عملية إيجادها كانت تتجاوز خبرات والدي المتواضعة في التكنولوجيا. ولكن القمع الأكبر داخل وجدان كلّ مراهق هو العنف الثقافي حول العادة السريّة. العادة السريّة إجراء مضادّ للطبيعة البشريّة وتدخُّل في البيولوجيا الجسديّة، وهدرٌ للمادة النخاعيّة- الدماغيّة.
السائل الأبيض هو خلاصة خلايا عصبيّة تتكسَّر من الدماغ، وتسبب خسارة لا رجعة فيها للذاكرة والتركيز. الاستنماء هدرٌ لمخزون الرجولة المحدود في الخصيتين، وتبذيرٌ لإكسير القوة في الجسد البشري. لا يُوصَف الألم النفسي داخل روح المراهق، خصوصاً عند العجز أمامه كخطأ متأصِّل يتكرَّر لا يمكن تجنبّه. تصبح العادة السريّة جريمةً يرتكبها باستمرار شخصٌ ذو ضميرٍ أخلاقي حيّ، وتثير كلّ مرة مشاعر ذنبٍ بالقوّة ذاتها. حتّى إنّ خدر اللذة الذي يصيب القدمين والتعب الجسدي الخفيف بعد الانتشاء، كنا نفسّره كتأكيد لصحة الرواية المتداولة بأنّ العادة السرية استنزاف للجسد البشري. كنا خائفين حتّى في لحظة القذف، إذْ كنا نحرصُ على عدم تلويث المحيط بنجاسة السائل، ولا نضع المنديل الأبيض في الزبالة لأنّ رائحته الواخزة تجلُب الشبهة، بل كنا نحرقه كما تُحرق الجثث في بعض الحضارات الآسيوية.
بعد عام 2003 دخل الستالايت وصار الصراع بين الآباء والأبناء داخل البيوت رقمياً وأكثر دقّة. قنوات “السكس” الكُبرى مثل XXL وSatisfaction كانت موجودة على القمر الأوروبي. قام والدي بإبادة قارة أوروبا، وترك فقط القنوات الكردية وقنوات الرياضة وقنوات عالم الحيوان. عملية تنصيب قنوات “السكس” تتطلّب معرفة بالرقم السري، وحتّى عند معرفة الرقم السري، هناك مجازفة في تدوير الستالايت من قمر عربسات باتجاه القمر الأوروبي (كان اسمه Hot Bird) في الليل، لأنّ الدوران يصدر صوتاً يثير الجلبة. بعد شهرين من شرائنا للستالايت عرفت أنّ الرقم السري هو سنة ميلاد أبي 1956، واحترمتُ كسله بعدم التفكير بكلمة سرّ قوية. أزعم أنّي أسرع شخصٍ في العالم في عملية تنصيب القنوات الممنوعة وإزالتها فوراً، إذ أنّ العملية تتطلب مني أقل من 15 ثانية، والوصول من باب البيت إلى غرفة التلفزيون تتطلّب عشرين ثانية على الأقلّ. أمّا تبرير وجودي على القمر الأوروبي فهو جاهز: أنا أستمتع بالقنوات الكردية، وتكذيبي هو تشكيك بولائي القومي. بقيت سنة ولادة أبي كلمة سر جهاز الستالايت لمدّة سنتين، لدرجة أنه أحس بالخطر من هذا الاستقرار، وقام بتلقاء نفسه بتغيير الرقم السري كإجراء استباقي، أذكر أنّ يوم تغيير الرقم كان يوم كارثة بالنسبة إلي.
لمدّة شهرين وأحاول في مواليد الجميع، مواليده بترتيب رقمي مختلف، ومواليد أمي ومواليد أخي، ومواليدي حتّى، وتاريخ ثورة البارزاني وكل شيء. لم يفلح الرقم، واستهلكت كلّ الصور في ذاكرتي، وأصيب خيالي بالجفاف التام، ولم يعد قادراً إلى على الاجترار. بعدها بفترة حصلت على معلومة ذهبيّة من صديق غيّرت قواعد اللعبة تماماً، وهي أنّ لكل جهاز كلمة سرّ من المصنع قادرة على فتحه بعض النظر على كلمة السر التي وضعها المستخدم. رقم جهازنا كان 6814، ولما فتح الجهاز، بدا الأمر وكأنّ كنزاً قد فُتِح أمام شخص غارقٍ في ديون تهدّد حياته. بقيت الأمور هكذا، لكل رقمه الخاص، حتّى إن والدي لما كان يدخل الرقم السري، وهو يخفي جهاز التحكم خوفاً من تفسيري لحركات يده واختلاس نظراتي، كنت أغادر الغرفة وأدّعي الترفُّع عن المعرفة، وأظهر احتراماً مؤدباً للخصوصية.
إقرأوا أيضاً:
مقبرة الكلدان
حاولت زيارة “مدرسة العروبة” التي أتممتُ فيها تعليمي الإعدادي والثانوي، فرأيتها قد تحوَّلت إلى ثكنة عسكريّة ومركزٍ إداري تابع للإدارة الذاتيّة. رجوت الحارس المسؤول، وطلبت منه أن يسمَح لي فقط بالدخول والقيام بجولة سريعة، وسألته عن إمكانية رؤية الضابط المسؤول، فقطع الطريق أمام كلّ المحاولات، وكانت نبرة الرفض تتصاعد بعد كلّ محاولة. الملاحظ هو أنّ هنالك تقصّداً من الإدارة الذاتية بوضع موظّفين وعسكريين من عرب المنطقة في الأمكنة التي تتطلّب احتكاكاً يومياً مباشراً مع الناس، كالدوائر البيروقراطية والحواجز العسكريّة داخل المدينة والمناصب الحكوميّة البارزة. ولكن النواة العسكرية والقرارات الاقتصادية الاستراتيجية والهيمنة السياسية محتكرة على العصب السياسي الذي يمثّل حزب العمال الكردستاني في سوريا.
القامشلي مُقسَّمة إلى قطاعات، وأعلام الجميع مرفوعة. في “المربع الأمني” وسط المدينة، صور حافظ الأسد وبشار الأسد. في منطقة الوسطى تنتشر قوات السوتورو السريانية المسيحيّة، والتي تحاول الحفاظ على نمط الحياة المسيحي المتبقي بعد الهجرة الكُبرى. المسؤول عن مقبرة الكلدان قال إنّ بعض العجائز يدفنون بدون وجود ولو قريب واحد من أسرهم بسبب الهجرة الجماعيّة. يدفنون في بلدهم وكأنهم في منفى. الروس موجودون في المطار، ولأنّ منطقة المطار كانت تعج بصالات الأعراس الكبرى في المدينة، قام الروس باستئجارها وتحويلها إلى معاقل عسكرية ضخمة. الأميركان معدومو التماس مع السكان، إذْ يتواجدون بشكل حصري في قواعدهم العسكرية المتوضَّعة في العمق الصحراوي، والبعيدة حتى عن مرمى نظر طرق السيارات. الإشارة الوحيدة بأنّ هنالك قاعدة عسكرية أميركيّة قريبة هو تعطّل الأجهزة الإلكترونيّة والكهرباء بسبب الحقل المغناطيسي الذي يتم توليده في دائرة ذات قطرٍ معين. طائرات الدرون تدور فوق القواعد وتقوم بمناوبات، وتبدو من بعيد بحركاتها السلسة وسرعتها الرشيقة وكأنها أجسامٌ طائرة مجهولة. المفارقة البصرية الناجمة عن وجود هذه التكنولوجيا الهائلة في هذه البيئة الفقيرة، تجعل الوجود الأميركي وكأنّه مهمّة علميّة لـ “ناسا” من كوكب إلى كوكب آخر، وليست وجوداً عسكريّاً سياسيّاً. بقية المدينة والمنطقة تسيطر عليها الإدارة الذاتيّة الديموقراطيّة وتشكيلاتها العسكريّة المختلفة مع صور كثيفة لعبدالله أوجلان في الساحات العامّة، ومقولات له مترجمة إلى اللغات العربيّة والسريانيّة، وهي في الحقيقة مترجمة إلى الكردية أيضاً، لأنّ أوجلان يكتب باللغة التركيّة.
الطارئون
كلمة “الثورة” كدلالة سياسية وحدث تاريخي لها وقع مختلف تماماً في القامشلي. “الثورة” هي بداية الانهيار وتغيُّر كلّ شيء إلى الأبد والهبوط الصاروخي من السيئ إلى الأسوأ. لا خيارات سياسيّة ذات وزن واقعي متكافئ تتمّ المفاضلة بينها. الوضع هو إيجاد للنّفْس تحت ظلّ قوى أمر واقع مختلفة، وفي وضع ميداني متحوّل، وأحوال جسديّة تماسيّة مع الخطر الجدي. في أحوالٍ يكون فيها الأمن مقابل السياسة، لا مكان فيها للسياسة، والتنافس يكون بين مشاريع أمنيّة- خدماتيّة لا بين مشاريع سياسية- أيديولوجية. الخيار هو بين مشروعين عند أهالي المنطقة (كرداً وعرباً). المشروع الإسلامي الجهادي الذي يتدخّل بالحياة الخاصة ويراقب التدخين ويراقب أجساد النساء، وبين مشروع الإدارة الذاتية الذي يهيمن على الإيقاع السياسي والاقتصادي العام والقرار الاستراتيجي العسكري مع عدم تدخّل على مستوى الحياة الخاصة أو محاولة تغيير القيم الثقافية الاجتماعيّة السائدة، لا إيجاباً ولا سلباً. المشروعان لا ديموقراطيان، ولكن الخيار هو للمشروع الأقل التصاقاً بالجسد والقادر على إعادة إنتاجه بالحدّ الأدنى. ولشدّة مرارة الخيار أحياناً، ليس من الغريب سماع آهات الترحّم على أيام حافظ الأسد!
عند مواليد الألفينات، من كانوا أطفالاً وفي بدايات المراهقة في عام 2011 لديهم إحساس مختلف تماماً عن إحساس من رآها قبل عام 2011. سوريا عندهم مقطوعة وموقّتة وفي حالة تحوّل دائم، وليست مكاناً يمتلك حدوداً جغرافية واضحة، ولها مركز سياسي هو دمشق واقتصادي هو حلب. هؤلاء لم يعبروا نهر الفرات في حياتهم وبعضهم لم يزر مدينة دير الزور حتى، المكان لديهم هو قطعة قماش تُمزَّق وتُرقَّع باستمرار. أناس صار الاستقرار لديهم هو الاستثناء، والوجود الطارئ والإحساس البرزخي هو الطبيعة.
برلين
في صباح يوم 16 آب/ أغسطس، ودّعت أهلي متجهاً من القامشلي إلى أربيل في رحلة ماراثونية. المشاعر كانت متضاربة بين الفرح الواضح والراحة الخفية بالعودة إلى برلين، والالتهاب الداخلي المزمن بأنّ أمي وأخي وأبي يعيشون في هذا الكابوس. دخلت إلى برلين، ووصلت إلى حي كرويزبرغ حيث أقيم بالقرب من قناة مائية ساحرة. وضعت يدي على العشب الأخضر وأدخلت رأسي بين ساعديّ، وتذكّرت كيف خفّت قدرة والدي على السمع، وكان يتظاهر بأنّه يفهم جملاً لم يكن يسمعها جيداً. كان يدِّعي الفهم كي لا ألاحظ وأشعر بالقلق. فتحت عيني وسحبت دموعي من على شفتي كي تدخل الملوحة إلى فمي.
الصور بكاميرا دارا عبدالله
إقرأوا أيضاً:


















