لا يُمكن أن يتوقف النقاش حول الدين والسلطة طالما أنّ الإنسان بطبيعته يُولد جاهلاً، وطالما أنّ السلطة هي مَن تتولى -عبر أدواتها- أمرَ تعريفه بالعالم، وتعريفه بنفسه، وطالما أنّ هذه المعرفة التي تُلقّننا إياها السلطة هي التي تُشكّل هويتنا الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، التي بدورها تُشكّل حاضِرنا ومستقبلَنا.
لا يُمكن أن يتوقف هذا النقاش طالما أنّ الإنسان يَميل إلى اليقينيّات التي تُريحهُ عذابَ الشك والتفكير، وطالما أنّ هناك سُلطة تَحكُم وتتحكّم بمصائر الملايين من الناس عبرَ وسائط مختلفة وفي مقدمتها سطوة الدين، وطالما أنّ شعوباً يتمُّ تكريسُ جَهلها، وإفقارُها وإذلالها والتضحية بها باسم الدين، وطالما أن هناك مَن يتحارب فَيَقتُل ويُقتَل بدافع ديني.
أتاحت لي سبعُ سنواتٍ قضيتها في دراسة الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عملي في الصحافة، أن أكون الشاهِد المطّلِع على حَدثٍ تاريخي كالانتفاضة السورية عام 2011، فخلالهُ ستأخذُ التجربةُ الإنسانية بما درستُهُ وعرفتُه عن الدين، ستأخذ به (وبشكّل جدّي) إلى حدّ الممارسة الأقصى، والأقسى -حسبما توضّح ذلك التجربة-؛ سيَختبرُ هذا الحدثُ المُؤلم في تجلّياتهِ مدى صلاحية النصّ الديني، وأبعاد تطبيقه وتفسيره، وسيؤكِّد هذا الحدث المعاصر ما قاله فلاسفة عاشوا قبلهُ على مدى قرون.
هذه المادة هي الجزء الأخير من سلسلة مقالات أسرد فيها تجربة إنسانية مهمّة، وأتناول فيها موضوع الدين واللائكية، وذلك باعتبار هذه الأخيرة ضرورة وحاجة ملحّة اليوم، وكل يوم.
لماذا يجب على السياسي ألا يستغلّ الدين في رحلة بحثه عن السلطة، ولا في ممارستها؟
لماذا يجب على الدين بدوره أن يتبرّأ من خِطابه السياسي كلّياً في المجال العالم، ويتعهّد بألا يتطلّع نحو السلطة؟
لنقاش هذه المسألة، تناولَت المقالات السابقة موضوعات:
١- المعرفة، كيف أنها تُشكّل هويّتنا؛ وكيف أنها خاضعة للسلطة، والدور الذي تلعبه “المعرفة الدينية” في منح السلطة مشروعيّتها وقوتها.
٢- الجهل، بوصفه أصل الشرور جميعها، تُريد السلطة تكريسه لضمان حكمها.
٣- الخوف، باعتباره الشلل الذي يَسلب المجموعة البشرية كل قواها مِن أن تأخذ بزمام المبادرة للتفكير والتغيير.
٤- الكراهية، وذلك من حيث كونها تُصيبُ تماسُكَ النسيج الاجتماعي للمواطنين في مقتل، وتُعرّضهُ لخطر التفكّك والتحلّل والاندثار.
وفي هذا السياق، سيتحدث هذا المقال عن العنف.
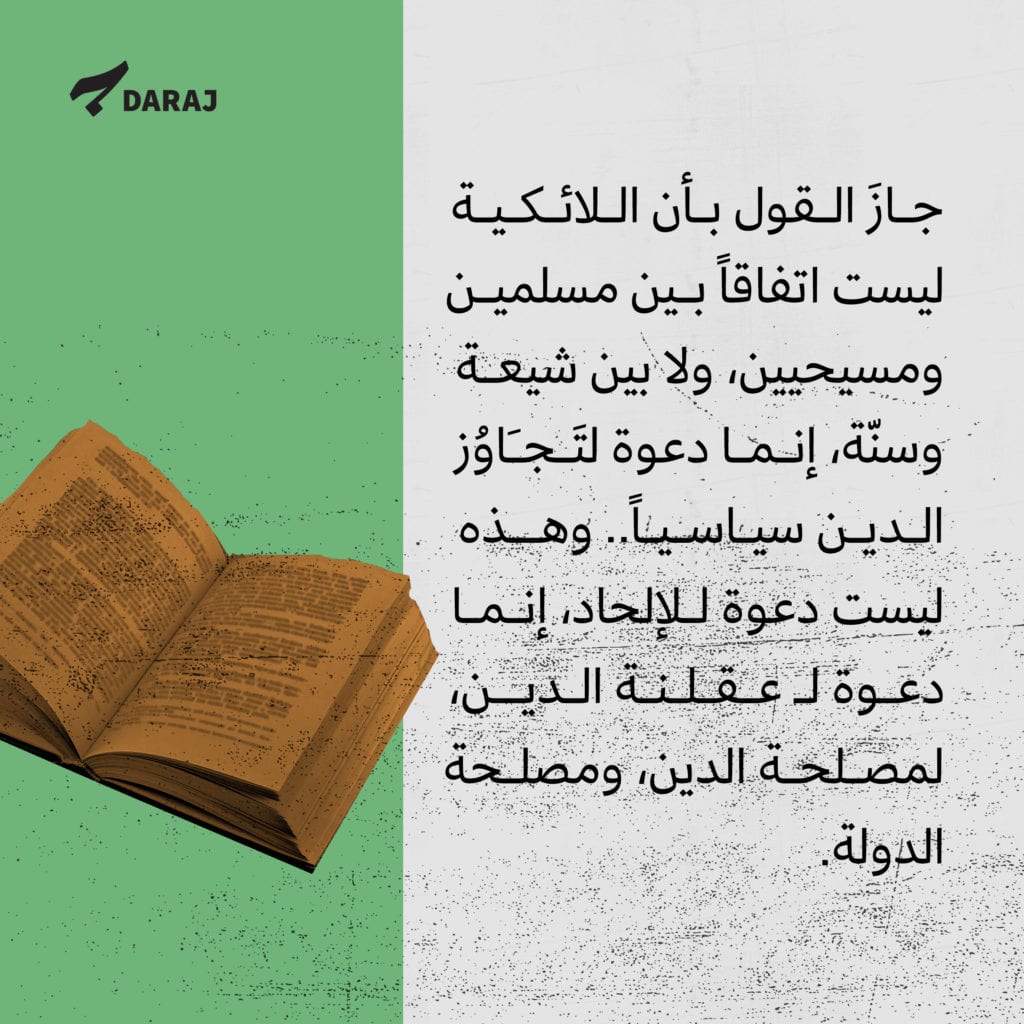
الشرّ المُطلق
العنف الذي تتحدث عنه الخطابات بوصفه جريمة هو ذاك التعدّي بالأذى الجسماني، وهو مُجرَّم وشنيع في حيّز التفاعل الإنساني الحديث مراعاةً لحساسيّة أنه سلوك يَدفع بشكل مُباشر باتجاه الموت.
وهذا السلوك التدميري الخطير الذي هو غاية الشر في العالم لا يُمكن حَصرُ أبعادهِ والتنبؤ بنتائجه، لذا فهو قابلٌ لأنْ يَخرج عن السيطرة دائما.
لهذا السبب تتعهّد السلطة في المجتمعات الحديثة بأن تحتكر وحدها العنف، وتتولى مسؤولية ضبطه واستخدامه بطريقة عقلانية وفق ما يُراعي مَصلحة المجموعة البشرية التي تَحكُمها.
يُعلّمونك في مادّة “الفقه” الإسلامي أنّك إذا ما أردتَ اختبار صحّة قانون، فعَليك أن تتخيّل تطبيقه على العالم بأسره، فإن صَحَّت مضامينه بشكل شامل دون أن يُحْدِث ضرراً فهو صحيح، وإلا فهو باطل.
الأمر مشابه لقول إيمانويل كانط: “تَصرّف فقط بالحِكمة التي تَجعلك تتمنّى تحويلها إلى نظام كوني.”
ويُعلّمونك أيضاً أنّ التعدّي يَظلُّ مُنضبطاً بقدر ما يَنضبط القانونُ الذي يَنُصُّ ويُحدِّد، وأنه حين يَكون نَصُّ القانونِ غير منضبطٍ فإنهِ يُؤذِنُ وقتذاك بالخروج عن السيطرة، والفوضى.
وإذا ما جئنا نتخّيل ممارسة العنف كـ حق مشروع غير مُحتَكَر من قبل السلطة، فسننتهي إلى تجارب معاصرة كالسورية واليمنية والليبية، وحتى “حزب الله” في لبنان، الذي تُشكّل تلويحاته بممارسة العنف أنسبَ الأمثلة في معرض الحديث عن الفوضى التي يُسببها عدم احتكار السلطة للعنف.
اللهم إلا إذا اعتبرنا أن حزب الله هو نفسه السلطة التي يَجب أن تحتكر لنفسها ذاك العنف، ووقتها يجب أن نلومه لأنه يسمح للجيش اللبناني أصلاً بحيازة السلاح!
إقرأوا أيضاً:
السلطة دائماً وأبداً
السلطة هي كل شيء، مَن يَحوز السلطة يَستطيع تسخير كل ما يَقع تحتها؛ وهذا بقَدر ما يَمنح السلطة قوّتها إلا أنه في الوقت ذاته مَكمن الضعف، إذ يُحمّلها ذلك مسؤولية أن تكون حكيمة إلى الحد الأقصى دائماً، خصوصاً فيما يتعلّق بالعنف، وإلا فحرباً همجيّةً كالحربِ العالمية الثانية.
لا نستطيع أن نقول بأنّ العنف هو مُنتَج حصري ديني، ولا هو مُنتَج حصري غير ديني، إنما هو سلوك موجود في سياق التاريخ.
غير أن هذا السلوك، ككُل ما يَبدُر عنا قولاً أو فعلاً، لا يُمكن أن يَحدث في التفاعل الإنساني بشكل عشوائي واعتباطي، إنما هناك ما يُحركُه، يَدفع باتجاهه، ويَدعو إليه، إذ يرى فيه سبيلاً لتحقيق غاية يُريدها؛ وهذا المُحرّك هو السلطة، دائماً وأبداً.
فحين أهُمُّ بالتعدّي على الآخرين بالعنف، إنما أفعل ذلك بإملاءٍ من سُلطة عقلي عليّ، ما يعني أنّ السلطة موجودة أصلاً داخل عقل كل واحد منا، نُمارسها على أنفسنا، نُدير ونُخضِع بها ذواتنا، نفعل الخير أو الشر، نُخطط ونُنجز، ننجح أو نفشل، نَحكم على أنفسنا بالحياة أو الموت، كل ذلك مرهون بالسلطة الموجودة داخل عقولنا، والتي نوازن من خلالها علاقتَنا بالوجود والعالم.
إلا أنّ هذه الإدارة والموازنة التي تقوم بها السلطة في عقولنا تَعتمد اعتماداً جوهريّاً على مجموع تحصيلنا المعرفي والإدراكي؛ فالذي يَعرف الصواب يَفعل الصواب، والذي لا يَفعل الصواب لا يَعرفه، ولا يَعرف أصلاً كيف يفعله.
إذاً فالسلطة داخل عقل الإنسان هي مجموع معارفه، فحين يكون الإنسان عقلانيَّ المعرفةِ، يُمارس وقتها السلطة على نفسه بطريقة عقلانية، يُدير شؤونه ويتدبّر أموره بطريقة عقلانية، ويكون للعقل بالنسبة له القولُ الفصلُ في تحديد الخطأ من الصواب.
في المقابل، حين يؤمن الإنسان بالأسطورة يَعيش حياته بشكل أسطوري كما لو أنه يَرويها، حين يؤمن بالخرافة يُفسّر كل ما يُحيط به ويَحدث له بشكل خرافي، ويتدبّر شؤونه بالخرافة اعتماداً على معرفته الخرافية للعالم ومعرفته الخرافية لنفسه، هكذا يُلقي بالملامة على ما هو غير موجود، وهكذا يَخضع لسلطة خرافيّة خيالية أسطورية داخل عقله وضميره، يَزعم أنها تَدلّه إلى طريق الفضيلة.
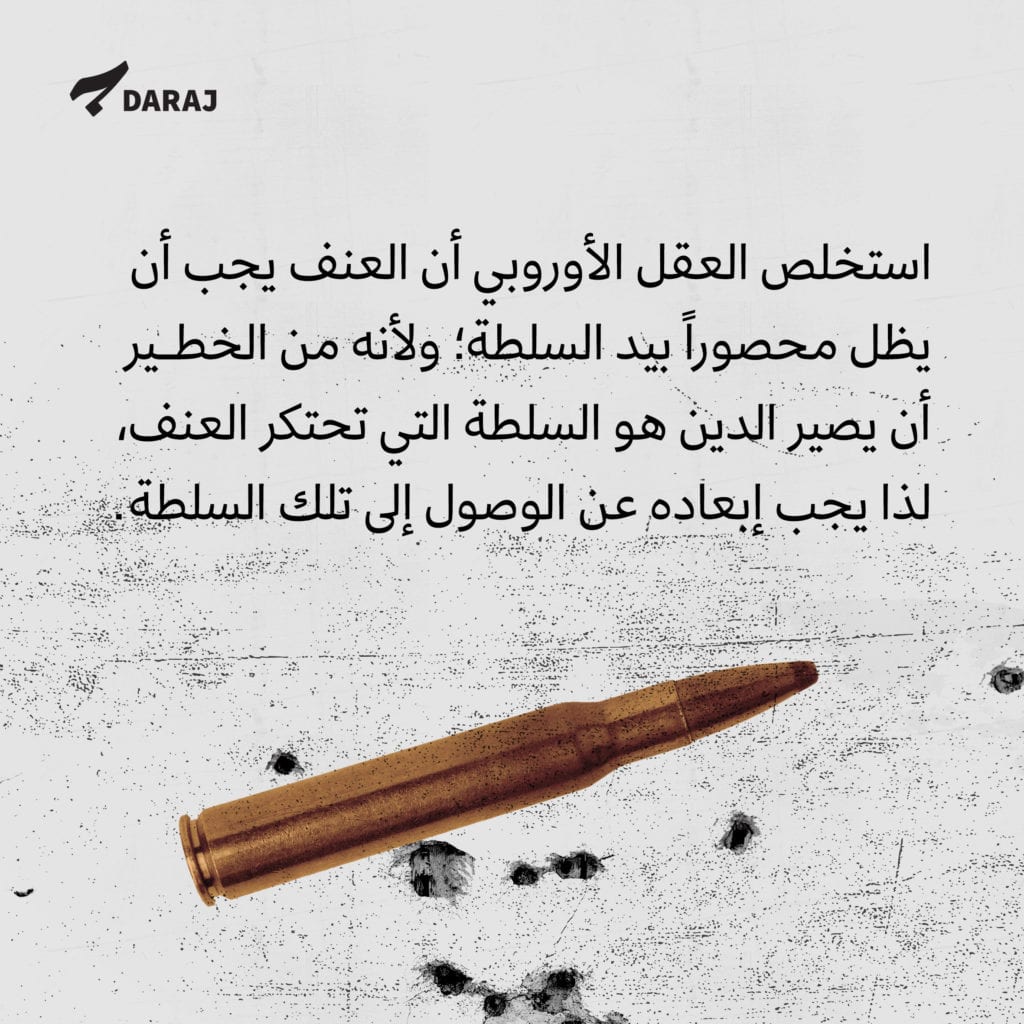
ليس الإنسان شريراً بالمُطلق كي يُمارس العنف، ولا خيّراً بالمطلق كي لا يُمارسه، إذ لا شيء مُطلق؛ إنما الإنسان هو ما يَعرفُه.
ما نَعرفه يُشكّل هويتنا، فحين تتّسع معارفنا تتطوّر عقولنا، وتتّسع آفاق إمكانياتنا، وتتطوّرُ مع معارفنا استراتيجياتُ بقائنا واستمرارنا، وقدرتُنا على إدارة أنفسنا وتدبُّر أمورنا؛ وتصير هذه السلطة الذاتية التي نُدير بها شؤوننا بارعةً في جَلب المصلحة ودرْء المَفسَدة بقدر ما يتّسع تحصيلنا المعرفي والإدراكي.
ولا يتوقّف الموضوع عند هذا الحدّ، إنما يتجاوزه لينطبق على الفلسفة السياسية للدولة كلها، فالخاضعون لنظام سُلطة عقلانية داخل رؤوسهم يَخضعون في المقابل للسلطة العقلانية التي تتجلّى مادّياً على مستوى سياسي. وأولئك الخاضعون لسلطة خرافية في عقولهم يَخضعون كذلك بشكل مادّي للسلطة التي تتبنّى الخرافات التي يؤمنون بها.
فالوضع السوري هو التجلّي المادّي للنظام المعرفي السُلطوي الكامن داخل العقل السوري، ولو لم يكن مفهوم “الأب القائد” مثلاً موجوداً داخل الأسرة السورية ما كان له أن يتجلّى على مستوى السياسة، وحالُ السلطة في لبنان يُمثّل المُقابِل المادّي لما يَحدث من انقسام داخل العقل الجمعي اللبناني.
هكذا يُديرُ الناسُ أنفسَهم بما يَعرفونه، ويُدارون بما يَعرفونه أيضاً. وإلا كيف لتنظيم إرهابي كـ “داعش” أن ينال القبول والرضى من أنصاره أصلاً؟، وقد سمعت أكثر من مرة على لسان القرويين في إحدى البلدات شرق سوريا كانت خضعت للتنظيم مَطلع العام ٢٠١٤ ما معناه أنّ “الدولة الإسلامية تبدو حقّاً كتلك الخلافة التي وَعَدنا بها الرسول، خلافةً على منهاج النبوّة” … نعم، هذا الكلام خطير، وهو يُعيدنا للحديث عن الجهل مراراً، بوصفه القاعدة، لا الاستثناء.
ما نعرفه يُشكّل هويّتنا، ويتجلّى في شكل السلطة التي تَحكمُنا سياسياً، إلا أنّ هذه السلطة تقوم من جانبها بإعادة إنتاج ما نعرفه (إعادة إنتاج هويّتنا) كي تظل متوافقة مع سياستها الرامية إلى إطالة أمد البقاء في السلطة؛ فلمصلحة الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان أن تظل الطائفية حاضرة في العقل اللبناني، كي تظل المحاصصة الطائفية قائمة على المستوى السياسي.
أولئك الجالسون في الأعلى الذين تنتهي إليهم الخيوط جميعها، هم مَن يُديرون الاقتصاد والسياسة، ويَقودون الشرطة والجيش ويحتكرون السلاح، ويتحكّمون بالإعلام والفن والسينما، وهم من يتسببون بالمشكلة التي نناقشها، وهم الذين يُسيطرون على كل شيء، ويبلغ تأثيرهم حتى كوب الماء الذي نشربه.

السلطة والدين
لأنّ السلطة قديمة وموجودة حتى عند الحيوانات، ولأن الطبيعة كلها هي ميدان لتجاذبات على مستوى القوة، ولأن هناك دائماً علاقة خضوع وإخضاع، وأقوى، وأضعف، وأعلى، وأدنى، فإنه لا فهم لأي شيء دون فهم تلك القوة التي تتحكم بالأشياء وتديرها: السلطة.
لا فَهم للدين دون فهم للسلطة وآلياتها، ولا يُمكن فهم السلطة الدينية دون فهم طبيعة المعرفة الدينية، والخطاب الديني، وأدواته التي يُعبّر بها عن نفسه.
الدين هو دعوة للانخراط في نظام مَعرفي بغرض سياسي سُلطوي.
ويَحمل الدين -التوحيدي أكثر من غيره، والإسلامي بشكل أكثر صراحة من غيره- يَحمل كل صفات الحزب السياسي، هناك مُرشّح للقيادة، وهناك آيديولوجيا تُشكّل عِماد برنامجه الساعي نحو السلطة، وهناك قواعد وتشريعات، وهناك حملة دعائية قائمة على الترغيب والترهيب، ويُراد منك -بالقوة أحياناً- أن تنخرط في هذا الحزب، وتلتزم ببرنامجه، مقابل وُعود ساحِرة لغوياً تتعهّد بمنحك سعادةً مؤجّلة، ستتحصّل عليها بعد الموت.
إقرأوا أيضاً:
الحاكم
طبيعة الرب الذي يدعو إلى اتّباعهِ الدين هو مَدخل لفهم السلطة الدينية.
حين يَدعو الدين لعبادة إله واحد لا شريك له، إنما هو بذلك يُروّج سياسياً لحاكم واحد لا شريك له.
وحين تدعو مجموعة الأديان لعبادة مجموعة من الآلهة الواحدة التي لا شريك لها، ولا بديل عنها، إنما هي بذلك تُروّج لنموذج سياسي فاسد يشبه رؤوس السلطة في لبنان.
وعلاوةً على كَون رب السلطة الدينية واحداً أبديّاً لا شريك له، هو أيضاً غير مرئي، غامض، غير مفهوم، ويَعجز عن التواصل بشكل مباشر مع مَحكوميه.
ولأن ربّ السلطة الدينية غير مفهوم، فالدين لا يمكن أن يكون مفهوماً، ناهيك عن أن يكون مشروعُه قانوناً!
كيف لإله غير واقعي أن يَحكم في قضايا واقعية؟ كيف لإله غير موجود وغير عقلاني أن يَحكم في العالم الموجود بطريقة عقلانية؟ ألا يجب أن يكون الإله الحاكم على صلة بعبيده وشعبه؟ حسناً كيف سنتواصل مع هذا الحاكم؟ عن طريق رجال الدين؟ ماذا لو اختلفوا، كيف سنتواصل مع الرب الحاكم وقتها؟ وكيف سنقضي فيما اختلفنا فيه؟ هل هناك حل نهائي لهذه الجدليّة عدا إبعاد الدين عن التطلّع نحو السلطة؟
البرنامج
أكثر ما يتوجّب الوقوف عنده في البرنامج السياسي للدين هو أنه يعِد بمصلحة بعد الموت.
إنه مشروع سياسي قائم على ادعاء لا يمكن إثباته وهو أن هناك مصلحة بعد الموت، وعقاب بعد الموت أيضاً، أي أنه يترك لخيال مَن يُخاطِبُهم حرية نسج هذه الخرافات والأوهام، وبالتالي يبثّ الأمل والألم والرجاء والخوف في مخيلتهم، ويَعِدهم باللغة لا أكثر.
ما هي النتيجة التي تتجلى مادّياً عن تطبيق هذه الفكرة على مستوى السياسة؟ ناهيك عن الاقتصاد والثقافة والاجتماع وقضايا الحرب والسلام؟!
ماذا لو أعلنا للناس: أيها الناس، هناك مصلحة بعد الموت ستتحصّلون عليها شرط انتمائكم إلينا والعمل لصالحنا؟
بالتأكيد، لن يرى الأتباع وقتها في الحياة أي قيمة عدا عن كونها مجرّد رحلة في عالم فانٍ، الإنسان مسلوبُ الإرادةِ فيه، والصابِرون يُكَافَؤون في نهاية الرحلة!
هكذا يَنحطُّ واقع المجموعة البشرية لأجل مصلحة مُبهمة لا يُمكن تفسيرها، وهكذا يَصير الدين فكرة عدميّة، وتصير العدميّة ديناً يَتجلى في مناحي الحياة كلها، وهكذا يُحكَم الناس بانتظار أن يأتي “غودو“، والمهدي، وكل ما لن يصل أبداً.. وهكذا أيضاً يصير حال الناس مرهوناً بين “إن شاء الله” و “الحمد لله”.
إن الدين يعِد أتباعه الوهم والكذب، وهو لا يستطيع أن يُبرهن على ادعاء واحد مما يقول، خصوصاً تلك المتعلّقة بـ الجنة، والنار، والحِكمة الإلهية، والقَدَر، وبقيّة ترّهاته البيانيّة التي يَسلب بها الأفئدة والقلوب، إنه مشروع سياسي غادِر ومخادِع.
إن السياسي الأكثر صراحة وعلانية في خداع الجماهير وتضليلها هو الدين حين يقول: اتّبعني، وسأمنَحُك السعادة بعد أن تموت.
لا عجب أنّ مَن يُصدّق هذا النوع من الوعود الكاذبة أن يُحكَم بطريقة مماثلة على المستوى السياسي.
ازدياد معدلات التديّن هي مؤشر على أن المجموعة البشرية تعيش في عالم موازٍ، في بُعد زماني ومكاني آخر، هناك حيث يُمكن بالادعاء الديني السيطرة عليها والتلاعب بها بسهولة.
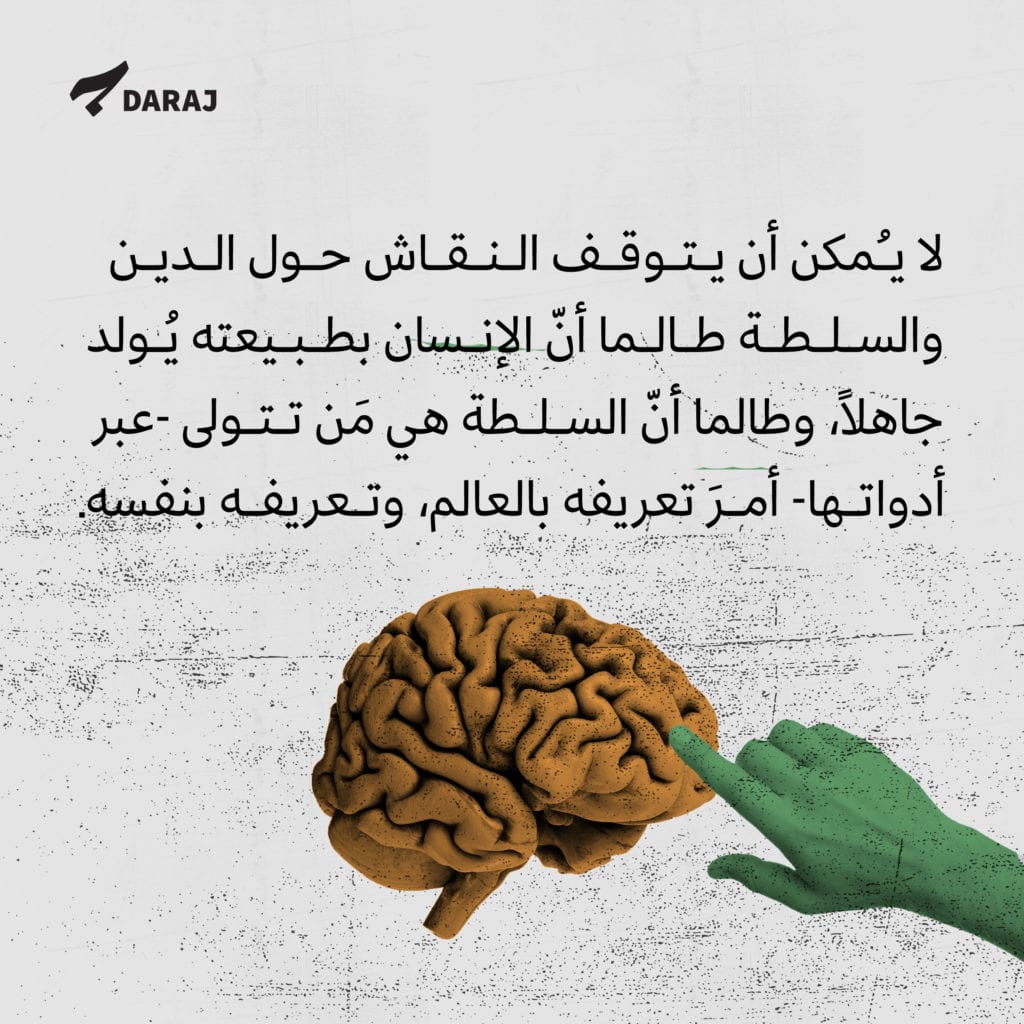
السلطة التشريعية الدينية
إن النسق المعرفي السياسي السلطوي للدين يَستمدّ شرعيته من نصوص غير واضحة الغرض والدلالة يُشكل تفسيرها منطق التشريع الديني.
وإذا ما جئت تبحث في أي مسألة دينية -إسلامية تحديداً- فإنك ستجد نفسك وسط لعبة لغويّة سفسطائية يَختلط فيها “الحابل بـ النابل” لن تصل بك إلى أبعد من “محاولات” التفسير، ففي الدين لا أحد يَعرف الحقيقة، حتى علماء الدين نفسهم يُقدّرون المسائل تقديراً، وهكذا فإن رحلة البحث عن الحقيقة في الدين هي عبارة عن عملية شدّ المفردات ومَطّها، ولَيّ أعناق النصوص وإقحامها داخل بعضها للوصول إلى نتيجة.
محاولة البحث عن الحقيقة في التشريع الديني هي سجال لغوي عقيم يَصِل حتى تشريع الفعل ونقيضه!، وذلك بِحُكم تناقضات النص القرآني مع بعضه، ومع العقل والواقع نفسه.
حريٌّ بمن يُريد تنظيم حياة الناس أن يكون صريحاً ومُنَظّماً، كي يتفادى خروج النص عن السيطرة، لا أن يتحدث عن الدورة الشهرية ثم يتحدث بعدها عن مواضيع تخصّ التجارة والاقتصاد!
السلطة التنفيذية الدينية
الدين فاسد سياسياً بالضرورة، لكونه الخصم والحَكَم في الوقت نفسه.
مَن سيُحاسب السلطة الدينية حين تُخطئ؟ الله؟! هل سُيحاسب الله نفسه على تقصيره في توضيح ما يُريد؟ ساعةً يقول “لكم دينكم ولي دين”، وساعة يقول: “ومَن لم يَحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون”! كيف يُمكن فكّ هذه الشيفرة؟!
لا يُمكن لأحد أن ينتهي إلى نتيجة حاسمة في مسألة دينية، فـ “المختلف عليه” هو الدين كله.
غير أن المشكلة الأكبر هي أن هذا الـ “مختلف عليه” يَشمل قضايا جدّية مفصليّة تَخُصّ الحياة والموت، كقضية الحق في استخدام العنف.
إقرأوا أيضاً:
الدين والعنف
لا تبدأ الدعوة الدينية إلى العنف بمجرّد الدعوة إليها، إنما بجملة من المقدِّمات التي تَسبقها. فالمشكلة لا تبدأ بالنصوص التي تدعو إلى العنف، بل في المقولات الدينية العامة، في البرنامج السياسي التشريعي الذي يتّبعه الدين، وينطبق هذا الكلام على العنف الذي تتسبّب به الديكتاتورية العسكرية أيضاً.
الدين يَصنع الجهل بعلومه ومعارفه وشكل الثقافة التي يَفرضها على الناس بحُكم سُلطته، فيَكذب حين يُصوّر العالم بغير ما هو عليه، ويَقسمه إلى (نحن) مقابل (الآخرين)، ويبدأ الحديث عن المؤامرة التي تُحَاك ضده… ومِن هنا، مِن هذه النقطة يُجرم الاختلاف، ويُميّز المختلفين، ويُرهبهم، ويتوعّدهم بالعذاب، ويُفرّق بينهم وبين أتباعه، ويتّهمهم بالغدر والخيانة، ويدعو أنصاره للحذر منهم وكراهيتهم.
ولأنّ مُقدِّماته لم تَخضعْ مُسبَقاً لمعيار العقل، وليس مسموحاً معها أصلاً أن يكون العقل حاضراً، تصيرُ دَعوةُ الدينِ أتباعَهُ وقتها للجوءِ إلى العنفِ دعوةً مُبَرَّرةً وضرورية، بحجّة أن الغرضَ منها لا يتخطى حاجة “الدفاع عن النفس”.
إذاً فالدعوة الدينية إلى العنف هي نتيجة لمقدّمات خطابيّة سابقة عليه، إذ لا عنف ديني دون خطاب الكراهية الديني، ولا خطاب كراهية دون إثارة للرعب والخوف، ولا خوف دون الكذب والتزوير والحديث عن المؤامرة التي يحيكها الآخرون.
حين يَجهل الإنسان، يَجهَل مَصلَحتَهُ، ويُشكِّلُ خطراً على نفسه، ويقودها إلى التهلكة بيديه؛ ومَصلحة الإنسان -لو يَدري- هي أن يحيا لنفسه والآخرين، لا أن يموت، ولا أن يدفع الآخرين باتجاه الموت.
لا يَدعو الدين إلى العنف لأنه يُريد مصلحة الإنسان، بل لأنه يُريد تحصيل السلطة السياسيّة.
لو أنّ ربّ السلطة الدينية يُريد الدفع باتجاه مصلحة الإنسان في كل زمان ومكان -حسبما يدّعي- لدَفعَ باتجاه الحب والتآخي والسِّلم، ولكان أكثر مسؤولية ووضوحاً فيما يتعلّق بالعنف، لكنه يدعو إلى “الجهاد” و “حروب الرب” لأنه مشروع وبرنامج سياسي توسّعي عابر للقارات، كالثورة الإسلامية في إيران.
لن يتوانى الدين عن السعي نحو السلطة لأنه حزب سياسي، ولن يتوانى عن استخدام العنف، لا بل إنه سيظل يُحاول تغليف هذا العنف بحجة الدفاع عن النفس والمُقدَّس.
وليس الدين مُضطرّاً لأن يُفسّر لنا سبب لجوئه للعنف، لأنه وقتها سيكون مُضطرّاً أن يشرح لنا كل ادعاءاته السابقة، ووقتها سيَقع في مأزق أنه غير عقلاني بالمرة حتى قبل الحديث عن العنف مِن أصلِه.
الأجدر بنا أن نسأل الدين تفسيراً لسبب حبّه وسَعيِه وولَعِهِ الشديد بالسلطة، وشرحاً مُبسّطاً لحالة البارانويا المُصاب بها إزاء وجود مؤامرة تُحاك ضده، ودليلاً واحداً على صدق ادعاءه بوجود إله حاكم في السماء هو الذي -تحديداً دون غيره- يدعو إلى كل هذا!
ربّ السلطة الدينية غير عقلاني، لذلك فالجرائم باسمه لا يُمكن أن تكون عقلانيّة.
الأخطر من ذلك هو أنّ الدين حين يَدعو أتباعه (بشكل خاص) إلى ممارسة العنف، إنما هو يُغامِر في خطابه، ويَسلك طريق الحرب الأهلية.
فخطابُه القاصِر يَحول بينه وبين دعوة المخالفين له، إذ لا يستطيع الدين حين يكون في السلطة أن يدعو جميع مواطني الدولة على اختلافهم لاستخدام العنف ضد عدو خارجي مثلاً، لأنه يدعو أتباعه فقط (بحكم أنهم الوحيدون المؤمنون به)، لهذا حين يدعو إلى العنف يشقّ وقتها الصفّ، ويتسبب بحرب أهلية. داخلية وخارجية.
لكن، لأيّ غرض سيستخدمُ الدينُ العنفَ حين يكون في السلطة؟ لحماية مَن سيستخدمه؟ لحماية نفسه أم المواطنين جميعهم؟ وضدّ مَن؟ ضد مُخالفيه أم أعدائه؟ مَن هُم أعداء الدين؟ هل هم أنفسهم أعداء الدولة؟ كيف سيمارس العنف ضدهم؟
اللائكية
اللائكية موقِف نابع عن ضمير عقلاني، نَقدي، وحُرّ، يتّخذ لنفسه مساحةً تنتصر للتفكير إزاء كل القناعات والرؤى المُسبقة في العالم، وهي ليست شكلاً ثابتاً واحداً، إنما تخضع يومياً لاختبار في الحياة والسياسة، ويُشبعها المفكّرون والفلاسفة نقداً وتحليلا وتنظيرا، لذا فهي عالمّية لعقل ومواطِن عالمي يُؤمن بالعالم وينتمي إليه.
ليست اللائكية مذهباً، ولا آيديولوجيا، ولا بديلاً عن الدين، إنما هي ثمرة سنوات طويلة ومريرة من البحث والتجريب، أخذَت أولى خطواتها منذ أن شكّك الإنسان للمرة الأولى بالأسطورة، وقرر التفكير بعقله.
لهذا السبب تؤمن اللائكية بالحرّية كقيمة إنسانية لا حياد عنها، بوصفها حقّ الإنسان في التفكير، والتعبير، والتواصل، وتداول المعرفة؛ وتشترط لتحقيق ذلك أن يكون نظام الحكم في الدولة ديموقراطيا، يُساوي بين الجميع أمام القانون دون تمييز في الحقّ والواجب، ويَتعهّد بالحفاظ على تداول السلطة.
وتتعهّد اللائكية أن يستظلّ جميع الأفراد بظلّها، فيتمتّعون بالحقوق التي تمنحهم إياها، والحماية التي تُوفّرها، مُقابل أن يلتزم الأفراد من جانبهم بعدم التحريض على الكراهية أو العنف، وذلك بوصفهما تجاوزاً لحدّ الممارسة الخيّرة، ودَفعاً باتجاه الشر في العالم.
هذا يعني أن اللائكية لا تحمي المعتقدات ولا الأفكار ولا الأشخاص من التعرض للنقد أو السخرية، طالما أنّ الممارسَة سِلمية، خالية من التمييز العنصري، ولا تُحرّض على الكراهية أو تدعو إلى العنف.
إقرأوا أيضاً:
اللائكية والدين
تَدين اللائكية بوجودها للفلسفة، تاريخها مرتبط ارتباطاً وثيقاً وعميقاً بتاريخ الفلسفة منذ الدعوات الأولى التي أشارت إلى العقل بوصفه سبيلاً لتحصيل المعرفة.
ويُعد الفيلسوف الأندلسي “ابن رشد” (1126 م) أحد الآباء المؤسسين للائكية، قاضي قضاة الأندلس، وأشهر فلاسفة المسلمين، كان قد تنبّه في وقت مبكّر إلى التذبذب الحاصل في النص القرآني، ودعا إلى إخضاعه للعقل.
يقول “الحسن ما حسَّنه العقل، والقبيح ما قبّحَه”، ويقول: “لا يُمكن أن يمنَحنا الله عقولاً ويَمنحنا شرائع مخالفة لها”؛ كما يُنسَب إليه القول:
“L’ignorance mène à la peur, la peur mène à la haine et la haine conduit à la violence. Voilà l’équation” – Averroès.
الجهل يؤدي إلى الخوف، الخوف يؤدي إلى الكراهية، والكراهية تؤدي إلى العنف، هذه هي المعادلة – ابن رشد.
دعوات ابن رشد إلى الاعتماد على العقل في التفكير والحُكم، وشروحاته لآرسطو، وأفلاطون، حجزَت له مكاناً مرموقاً في الثقافة الأوروبية، لدرجة أن كتبه كانت تُدرّس في جامعة باريس إبان العصور الوسطى.
هذا التعويل على العقل والثقة والإيمان به جعلت من ابن رشد أيضاً رائداً للحداثة في عصره، لدرجة أن فنّان عصر النهضة الأوروبية “رفائيل” اتّخذَ له حيّزاً بجانب “فيثاغورث” في لوحته الشهيرة “مدرسة أثينا“.
غير أنّ التغيير في أوروبا كان لا يزال مُبكّراً، فقد كان للسلطة دائماً أساليبها في التسلّط والاستبداد، ولِقرون طويلة دَمّر الصراع الديني أوروبا، وحدثت الكثير من المجازر والحروب كـ مذبحة سان بارتيليمي عام 1572، وحرب الثلاثين عاماً 1618 – 1648، إضافة إلى قضية المواطن الفرنسي جان كالاس 1762، جميعها كانت أدلة تُشير بوضوح إلى الكراهية والعنف والاضطهاد الذي يتعرّض له الناس حين يكون الدين في موضع السلطة.
حين انتهت حرب الثلاثين عاماً، كان باروخ سبينوزا يبلغ من العمر آنذاك 16 عاماً، الفيلسوف وعالم اللاهوت الهولندي كان له أيضاً الأثر الكبير في التنوير الأوروبي.
رأى سبينوزا مثلاً أنّ فكرة “الحساب الإلهي” الذي سيَخضع له الناس في عالَم آخر هو أحد أكثر العقائد المدمّرة التي روّجت لها الأديان، فحسب رأيه أنّ الإنسان إذا ما اعتقدَ أنّ الله سيجزي الصالح ويُهلك الطالح فإنّ حياته ستحكُمها انفعالات الخوف والرجاء؛ الخوف من أن يكون الله قد قدَّر له أن يكون من الهالكين، والرجاء في أن يكون من الذين اصطفاهم.
وبلسان سبينوزا فإنّ حياةً محكومةً بأهواء غير عقلانية هي حياة عبودية، و”الذين تَحكُمهم الأهواء عوضاً عن العقل يُمكن وبكلّ سهولة أن يتمّ التلاعب بهم من قبل رجال الكنيسة”.
وللحيلولة دون هذا التلاعب من رجال اللاهوت بعقول الناس، كان سبينوزا يُشدّد على الحرّية، فيقول: “حرية التفلسف لا تُمثّل خطراً على التقوى أو على سلامة الدولة، بل إنّ القضاءَ عليها قضاءٌ على سلامة الدولة، وعلى التقوى ذاتها في آن واحد”.
ويقول: “إنّ الحكومة التي تُحاول أن تتحكم في عقول الناس هي حكومة استبدادية، وعندما تَفرض السيادة الحاكمة ما يَتعيّن على كل مواطن أن يَقبله على أنه حقّ ويَرفضه على أنه باطل؛ تكون السيادة الحاكمة حينها مُجحفة ومنتهِكَة لحقّ مواطنيها”.
ويقول أيضاً: “إنّ أي محاولة للدولة لِفَرض التحدث كما تريد السلطة العليا بالرغم من الأفكار المتباينة والمختلقة للأفراد، سيؤول بالفشل التام. إنّ أشد الحكومات استبداداً هي تلك التي يُحرم الفرد فيها من الحرية عن التعبير والدعوة لما يفكر فيه، بينما الحكومات المعتدلة هي تلك التي تضمن الحرية لكل فرد”.
ومن بعد سبينوزا وقبله عكفَ الفلاسفة الأوروبيون أمثال فولتير و جان جاك روسو على محاولات التفكير بمستقبل أفضل لإنسان أفضل، وهكذا، بعد قرون طويلة كان عنوانها الحرب باسم الرب والخضوع لسلطة الكنيسة، والذل والفقر والجوع والاضطهاد، خلُصَ العقل إلى أنّ الدين في السلطة يعني معاداة الحرية والتعلّم، وأن الدين في السلطة يعني خطاب التمييز، والخوف، والكراهية، والعنف، والحرب الأهليّة والإقليمية.
وانفجرت ذروة تلك الأحداث حين قامت الثورة الفرنسية لتقلب الميزان لصالح الشعب.
حين أطاحت الثورة بالحكم الديني، أعلنت أوروبا على فرنسا الحرب، رأت فيها تهديداً على المنظومة التي كانت لا تزال تَحكم على الطريقة القديمة.
غير أن الألماني إيمانويل كانط، أهم فلاسفة التنوير، كان يدعو إلى تعميمها على كل أوروبا، يقول عنها: إنّ مثل هذا الحدث لا يُمكن أن يُنسى، إنه يكشف أنّ في الطبيعة الإنسانية استعداداً للعمل بما هو أفضل…. إنّ مثل هذا الحدث هو مِن العظَمة والارتقاء بمكان يَجعلها وثيقة بالمصلحة الإنسانية”.
هكذا استخلص العقل الأوروبي أن العنف يجب أن يظل محصوراً بيد السلطة؛ ولأنه من الخطير أن يصير الدين هو السلطة التي تحتكر العنف، لذا يجب إبعاده عن الوصول إلى تلك السلطة.
وهكذا أيضاً قادَ العقلُ وإيمانُ الفلسفةِ به أوروبا إلى ضرورة أن تكون الدولة مُحايدة، كي توفّر الحماية وتَعدِل بين المواطنين جميعهم على حدّ سواء.
لهذا ترى اللائكية بضرورة إقصاء الدين عن الفضاء العام الذي تحضر فيه الدولة، وهي بذلك ليست مَسلَكاً إلحاديّاً، ولا دينياً، إنما هي تأبى أن تتدخّل المؤسسة الدينية في إدارة شأن الدولة.
إنّ اللائكية تعمل على تحرير الدولة والمجال السياسي من سلطة رجال الدين وتدخّلهم، وهي في الوقت نفسه تُحرر الدين من هيمنة السلطة السياسية وعبثها به، وهي بذلك تحمي الدين من أن يكون أداة لتحصيل السلطة مثلما يحدث في كل نظم الحكم الاستبدادية التي تجد في الدين وسيلة ناجحة لضبط المجتمع والتحكّم به.
وهي تُقدّم إمكانية للتجديد والإصلاح الديني، فهي تكفّ يد السياسي عن إقحام الدين في مشاريعه، وتدعو الأديان إلى إعادة إنتاج مقولاتها الدينية والمساهمة في تطوير الدولة والمجتمع، وليس ليّ عُنق الحياة نفسها كي تتوافق مع النصّ الديني.
من هنا جازَ القول بأن اللائكية ليست اتفاقاً بين مسلمين ومسيحيين، ولا بين شيعة وسنّة، إنما دعوة لتَجَاوُز الدين سياسياً.. وهذه ليست دعوة للإلحاد، إنما دعوة لـ عقلنة الدين، لمصلحة الدين، ومصلحة الدولة.
إقرأوا أيضاً:
اللائكية والعلمانية
تَعتبر اللائكية الدينَ خصماً سياسياً، لذلك فهي أكثر ارتياباً وحذراً إزاء أي علاقة تجمع بينه وبين السياسة، خلافاً للعلمانية التي لا تعتبره كذلك.
لا ترى العلمانية أن هناك مشكلة في أن يتعامل الكاهن مع السياسي أثناء سعي هذا الأخير نحو السلطة، ولا ترى أي خطورة في أن يُخاطِب السياسيّ مجموعةً من المواطنين خطاباً دينياً بغية حشدهم حوله.
فخطابات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مثلاً تلك المغلَّفة دينياً والتي يريد من خلالها حشد المسلمين الأتراك، أو خطابات الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أو دونالد ترامب التي تستهدف الإنجيليين الأمريكان وتدعو “الربّ” أن يحفظهم ويحفظ أمريكا، كلها موضع قبول لدى العلمانية.
لكن على العكس، لا تسمح اللائكية بذلك، فهي تستشعر الخطر من علاقة حساسة وخطيرة كعلاقة الديني بالسياسي، وتشترط على المتنافسين للحصول على السلطة أن يكونوا مواطنين حياديين بشكل صارم وقطعي، وأن يجسّدوا ذلك في خطابهم ومشروعهم.
كذلك نرى أن رئيس الولايات المتحدة يُقسم على الإنجيل حين تولّيه الرئاسة، بينما لا يتم ذلك في فرنسا.
يزداد الأمر حساسيّة حين تبدأ النقاشات عن إظهار الرموز الدينية في المدارس، وأثناء العمل داخل المؤسسات الرسمية، وهو الأمر الذي ترى فيه اللائكية طريقاً يُمكن للدين أن يستغله كي يصل إلى السلطة.
فمِن وجهة نظرها، يجب على الطلاب والموظفين الذين يقومون بأداء أعمال تُمثّل الدولة (القطاع العام) أن يحترموا الحياد الصارم لأنهم موضع مسؤولية، حيث الرموز الدينية التي يرتدونها يُراد منها أن تقول شيئاً عنهم، وتُميّزهم في الانتماء عن البقيّة.
وذلك مِن مُنطلَق أنّ النقابات الطلاّبية والعمالية والأحزاب تتمتّع بالحقّ والقوّة والقدرة على إدارة القرار السياسي، لذلك فإن إبراز الرمز الديني داخل هذه النقاط الحيوية والحسّاسة في جسم الدولة هو ممنوع، لأن من شأنه حشد الناس على أساس ديني، والقدرة على الاستفادة من هذا الحشد سياسياً، ما يهدّد تماسك النسيج الاجتماعي داخل الدولة، ويؤذن بالعودة إلى ما قبل النهضة والتنوير.
في ذلك وجهة نظر معقولة ومُحقّة، فتصاعد التمثيل السياسي للإنجيليين في الولايات المتحدة، واعتماد الدين وسيلة لحشد الناخبين، واستخدام زعماء العالم للدين في تحصيل السلطة، كل ذلك يشير إلى ما لا تُحمد عقباه في المستقبل، ويؤكد بثبات أنّ اللائكية الفرنسية حل نهائي لمعضلة الديني – السياسي.
إقرأوا أيضاً:
















